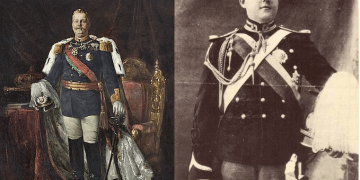قراءة في قصة ( جرح في أمومتي ) للكاتبة ( ليلى المُراني)
الأمومةُ مسؤوليةٌ حياتية.
أمي لماذا لا تسأليني مَن هم
أصدقائي؟
مقصوصٌ مهم يدور حوله النصّ، ويمكن اعتباره مفتاح القصة.
تلك القطيعة بين الأم وابنها، وبين الآباء والأبناء، أو مانسميّه بصراع الأجيال، هو ما أرادت الكاتبة ” ليلى المُراني” إيصاله إلينا في قصتها القصيرة والمعبّرة جداً ” جرحٌ في أمومتي” . وقد كرّرت الكاتبة مجموعة من الكلمات والعبارات للدلالة على أهمية ماتريد إيصاله إلينا، من مثل: “السيارة مسرعة” كنايةً عن الشوق الكبير لرؤية ابنها المسجون، ثم عبارة ” لماذا لاتسأليني مَن هم أصدقائي؟ ” دلالةً على حالة الغربة بين الأم وابنها، فهي لاتعرف شيئاً عنه، ولا مَن هم أصدقاؤه الذين يرافقهم، كما أنّه طلب منها ذلك ولكنها بفعل ضغوطات الحياة لم تُعِر سؤاله اهتماماً. وتبدو القصة من خلال عناصرها الأساسية؛ المكان: في السيارة المسرعة، والزمان: بعد شهور من سجن الابن، والشخصيات: فهي الأم وابنها وابنتاها وقد ذكرت الجميع من غير أسماء، ربما للدلالة على أنّ الحالة التي تكتب عنها عامة، وتحدث كثيراً في واقعنا المُعاش. أمّا الأحداث: فقد جاءت من خلال استحضار للذاكرة البعيدة والقريبة، وعبر تتالي ذكرياتٍ سابقة، ثم تلتها أحداثٌ في الزمن الحاضر. جاءت الأحداث الماضية من خلال تذكّر الأم لما حصل معها ومع ابنها، وشعورها بالتقصير والذنب تجاهه، إنّها تتذكر صوته وقد ملأ رأسها حتى أصبح مثار تعذيبٍ وأرقٍ لها، يطنّ في رأسها ليل نهار، ويُحيل حياتها جحيماً وهي تسأل نفسها : ” هل كنتُ سأغيّرُ شيئاً لو استمعتُ إليه؟ ” ضميرها يعذّبها، ويقضّ مضجع راحتها، وإحساسها بالتقصير تجاهه وعدم إيلائه العناية الكافية من الحوار والحديث، كيف لم تستمع لابنها وقد فتح لها قلبه عندما سألها: ” لماذا لاتسأليني مَن هم أصدقائي؟ “. إنّه يريدها أن تشاركه حياته الخاصة، فتتعرّف على أصدقائه، لتكونَ له عوناً ورشداً. لم يكن الابن ليسأل والدته ذاك السؤال، بل ويلحّ عليه لو لم تكن بداخله رغبةٌ جامحة لتشاركه أمه همومه، ومعرفة أصدقائه. فهل افتقد الآباءُ هذه الرغبة في زمننا ؟؟ .. لكنّ الأم لم تفعل ماطلبه منها الابن، ولم تُجِب على سؤاله، بل؛ أقامت بينها وبينه حاجزاً من جلمود بقولها ‘” لم أكلّف نفسي عناء النظر”، ” وهل سأعرفهم لو ذكرتهم لي ؟” باللامبالاة وعدم الاهتمام كان ردّ الأم على بوح الابن لسؤاله لها، وهذا الردّ شكّل فيما بعد غربةً قاسية جافية بينهما، فأصبحت الكلماتُ قليلةً بين الاثنين، كذلك قلّ تواجده وحضوره في البيت، لقد فقدَ الابن الحضن الدافئ الذي كان يلوذ إليه وقت الحاجة، لم تعد أمه ملاذه وملجأه، ولاعجبَ، بعد أن خذلته برفضها الاستماع له. وليس هناك موقفٌ أقسى من تلك الغربة التي تتشكّل بين الأم وابنها، أو بين الآباء والأبناء بفعل موقفٍ قد لايكون مقصوداً، لكنّه تشكّل بفعل ضغوطات الحياة والضجر والملل والإرهاق. تحاول الأم تبرير موقفها، فهي أمٌ تعيش في الغربة بعيداً عن وطنها وأهلها، وهي متعبةٌ أكثر لأنها مسؤولة أيضا عن ابنتين مراهقتين أخذتا مساحةً كبيرةً من أيامها في الخصام الدائم بينهما ولوقت طويل،على حين أنّ الأب قد تنصّل من أبوّته لأبنائه، فهو غالباً خارج البيت، وإن عاد إليه يكون مخموراً، يعلو صوته بالصياح والسباب والشتائم، لذلك مسؤولية الأم هي مسؤولية وحيدة في قهر صعوبات الحياة.
هذه الأسباب مجتمعةً حوّلت الأم إلى كيانٍ ضعيف هشّ، وصفتها الكاتبة وصفاً رائعاً معبّراً مثل ” سحابة صيف”؛ التي لا تُغني ولا تفيد، فسحابة الصيف تأتي من غير مطر أو من غير فائدة، لذلك آل حالُ الأم إلى الحزن والألم وذرف الدموع، وإلى تأنيب النفس بصمت مطبق . تبرَعُ الكاتبة ” ليلى المُراني” في تخيّر صورها الفنية التي تستقيها من أدبنا القديم .
تُعاود الأم تذكّر ابنها، وكيف ستلقاه بعد شهور قضاها في السجن، ماذا ستقولُ له وهي التي لم تحضر محاكمته، ولم تزره بعد أن انهارت وفقدت النطق والحركة؟؟؟. .. ثم بعد شفائها أنبّت نفسها أكثر بقولها: ” أنا السبب أنا السبب”، وتتذكّر الأم المفارقة، كيف كان ابنها مُتعلقاً بها في صغره لدرجة ضايقها، فقالت له : ” لماذا لاتصاحب صديقاً وتخرج معه ؟ “، ويبدو ندم الأم جليّاً بقولها : ” كان يطلب مساعدتي، ولكنني وبكلّ غباء وقسوة لم أعره اهتماماً ” . كرّرت الكاتبة كلمة الشوق مع مرادفاتها كثيراً في القصة، لتبيّن حبّ الأم وشوقها الكبيرين لابنها، لاسيما أنّه لم يعد ذاك الصبيّ الصغير المراهق الذي كان يلتصق بها كجلدها ” احتضنني بقوة أشعرتني أنّه لم يعد ذلك الصبيّ الصغير الذي كان ملتصقاً بي كجلدي”، تُجيد الكاتبة ” ليلى المراني” التعبير جيداً عن الحالات الشعورية العاطفية، وقد تجلّى ذلك في قولها السابق ” ملتصقاً بي كجلدي”، فتعلّق ابنها بها كالتصاق جلدها بجسدها، صورة موحية معبّرة، تُظهر مقدار التعلق بالشيء أو بالآخر، كذلك جاءت عبارة ” لم أجد ما أقوله سوى دموع صامتة”، تلك الدموع الخفية التي يسكبها القلب في تجاويفه لتزيده ألماً ووجعاً، فلا يعلم بها أو يراها سوى المجروح فقط، لقد أحسّت الأم بمقدار خطئها تجاه ولدها، وتقصيرها معه، وهي التي كان واجباً عليها أن تحتويه، ولكنّها لم تفعل، لقد جُرحت في أمومتها، هذا ما أشارت إليه الكاتبة في العنوان ” جرحٌ في أمومتي”، استطاعت الكاتبة أن تلتقط حدثاً اجتماعياً، غالباً ما يعيشه الآباء والأبناء، ويكون سبباً في انهيار الأسرة ودمارها، الأبناء يحتاجون مَن يسمعُهم ويتحدّث إليهم، يحتاجون مَن يحاورهم ويستمع لشكواهم ومتاعبهم.
تقبِضُ الكاتبة -كما عوّدتنا دائماً في قصصها القصيرة- على محاور حياتية مهمة في حياة الإنسان، تطرحها بعمق الفكرة واللغة والأسلوب، تتغلغل إلى سيكولوجية القهر والمعاناة في أعماق الإنسان، وتحتلّ الأسرة؛ الأم والأب والأولاد المساحة الأكبر في معالجاتها، لقد درستْ هنا حالة الغربة واللامبالاة وعدم الاهتمام، إضافةً إلى حالة الشعور بالخطيئة وبالندم، حتى تعمّق الإحساس كاملاً بدموعٍ صامتة سكنت قلب الأم، إذ لاشيء يبرّر خطأها..
عالجت الكاتبة مشكلةً يعيشها المراهق في كلّ أسرة من مجتمعنا، لذلك لم تُطلق اسماً محدّداً على الابن، لتدّل على أنّ الحالة عامة يعيشها أغلب المراهقين في هذا العمر ” السادسة عشرة”، حيث سنّ البلوغ والمراهقة، وحيث حاجة الأولاد إلى الاهتمام البالغ من قِبل الأهل، وضرورة عدم الاستهتار باحتياجاتهم أو بمشاعرهم كيفما كانت.. ولم تنسَ الكاتبة أن تُبيّن أثر الظروف الاجتماعية على الذكور والإناث معاً، فابنتاها المراهقتان تعيشان الحالة ذاتها، وإن لم تكن على تلك الحساسية والاتساع ممّا هي لدى الذكور . لقد تطرّقت الكاتبة إلى الحديث عن “الجندر” بطريقة غير مباشرة، وذلك عندما بيّنت أنّ عمر المراهقة كمرحلة عمرية، يعيشه كلٌ من الذكور والإناث معاً، لكنّه يغدو خطراً لدى الذكور، لأنّ متسع الحرية والتعرف على أصدقاء كثر هي مُتاحةٌ لهم أكثر من الفتيات، وهذه قضية مهمة عبّرت عنها الكاتبة، وقد لايعيها الآباء والأمهات بسبب عادات مجتمعنا الذكوري الذي يجد في الذكر رمز الكمال في تحمّل المسؤولية، وأضافت الكاتبة سبباً مهماً وهو غياب الأب عن مشهد الأسرة وعدم مسؤوليته عنهم كما يجب، مّا يجعل الوضع متفاقماً وسلبياً أيضاً .
ويجيء العنوان أكثر تعبيراً في القصة، ولأنّ فشل الأبناء غالباً مايكون سببه الأم، فالأم تجمع وتلمّ، وتحتوي وتخفف الوجع، وترشد وتؤثر بعاطفتها، إنّها تستطيع أن ترجّح كفتي الميزان من خلال وجودها وحضورها الفعليّ في البيت ولدى أبنائها. وقد يكون التساؤل الخجول: هل كانت اللامبالاة وعدم الاهتمام هما السبب أم كان غياب الحبّ؟؟ الحبّ يلغي كلّ المشاعر السلبية، ويضعها جانباً ليتولى قيادة الحياة.. الحبّ هو ميزان الاستمرارية في الحياة.
قصة قصيرة مؤثرة جداً، وقد تكون نسبة حدوثها كبيرة في حياتنا، في ظلّ الظروف الحياتية الصعبة الضاغطة، وقد استطاعت الكاتبة العراقية ” ليلى المُرانيّ” بلغتها الجميلة وأسلوبها الآسر أن تضيء المشهد، وأن تشير بقلمها إلى مشكلة أسرية مهمة جداً، قد تكون سبباً قوياً في تدمير الأسرة، والأبناء تحديداً، وقد لعب المونولوج من خلال حوارها الداخلي مع ذاتها درجةً قدسيةً ارتقت بعاطفة الأم أكثر وأكثر، لقد احتلّ المونولوج الداخلي مساحةً كبيرةً في القصة، وإن دلّ على شيء فهو يدّل على شعور الأم بالألم، لأنّها السبب فيما حصل لابنها فيما بعد. استخدمت الكاتبة أيضاً أسلوب المفرد المتكلم” أنا” بقولها : ” وأنا متكوّرة أسترجعُ مامضى، وأترقّبُ خائفةً ماسيحدث” وذلك لتبيّنَ خصوصية المشكلة القائمة بين الأم والابن .
وقد اختارت صورةً فنيةً مؤثرة عندما شبّهت الأم نفسها كفأر خائف: ” وأنا متكوّرة كفأر خائف في زاوية المقعد الخلفي”، ولماذا اختارت الفأر تحديداً ؟ وكأنّ الكاتبة تدرك صفات الفأر عندما يتكوّر وينزوي في زاوية بعيداً، إنّه الاستسلام والضعف الكامل حين يُنهك الجسد ويضعف حدّ الموت . ولاتخلو القصة القصيرة من ذاك الإيقاع الموسيقي الداخلي للكلمات كما في قولها : ” صوته مايزال يملأ رأسي، يؤرقني، يعذبني، يلاحقني، ليل نهار…”، وتتخيّر الكاتبة ” ليلى المراني” مفرداتها بعناية بالغة للتعبير عن مكنونات أعماقها، مثل: ( كان يومي “مترعاً” بالضجر والتعب – وأب لاوجود له إلاّ مخموراً ” يشعل” البيت ناراً بالصياح- السيارة مسرعة ” تلتهم” المسافات- أصبح الأرق ” رفيقي” كلّ ليلة- ” أستمطر” ذاكرة – لوعة عميقة كالزلزال أو الموت ” تسري” في عروقي “)، حقاً تتفرّد الكاتبة من خلال مفرداتها الممتلئة والتي تعبّر بدقةٍ عن الشعور والموقف المراد وصفه والحديث عنه، إنّها تحمل فكرتها السامية، ولغتها القوية، لتكونا جناحين يحلّقان باسمها عالياً في سماء الأدب.
رولا علي سلوم
***********************
نص القصة :
جرحٌ في أمومتي../ قصة قصيرة
ليلى المرّاني
السيّارة مسرعة تبتلع المسافات، وأنا متكوّرة كفأر خائف في زاوية المقعد الخلفي، أسترجع ما مضى، وأترقّب خائفةً ما سيحدث، صوته ما يزال يملأ رأسي.. يؤرقني.. يعذّبني.. يلاحقني ليل نهار.. ليلًا يسرق نومي؛ فأنهار على فراشي باكيةً، هل كنت سأغيّر شيئًا لو استمعت إليه؟
لأوّل مرّة يفتح لي قلبه، جالسًا أمامي في المطبخ وأنا أغسل الصحون، قال فجأةً بتردّد:
— لماذا لا تسأليني من هم أصدقائي؟
لم أكلّف نفسي عناء النظر إليه، فقد كان يومي مترعًا بالضجر والتعب، أجبته بسرعة ونفاد صبر:
— وهل سأعرفهم لو ذكرتهم لي؟
طأطأ رأسه وخرج مسرعًا.. كلمات قليلة أصبحنا نتداولها عند الضرورة، حتى تواجده في البيت أصبح قليلًا، هو لا يزال في السادسة عشر من عمره، وأنا أمّ أرهقتها سنين الغربة ومسؤولية ابنتين مراهقتين تتخاصمان طوال الوقت، وأب لا وجود له إلاّ مخمورًا يشعل البيت نارًا بالصياح والسباب لأتفه الأسباب، حتى أصبحت هشّةً مثل سحابة صيف، أذرف الدموع بصمت وأندب حظّي!
السيارة مسرعةً تلتهم المسافات، وأنا ساهمةً أفكّر كيف سألقاه.. كيف أصبح شكله بعد أن أمضى عدّة شهور في السجن.. بماذا يفكّر.. ماذا سأقول له؟
لم أستطع حضور محاكمته ولا زيارته بعد أن صدر الحكم عليه، فقد أصبت بانهيار تام فقدت على إثره النطق والحركة، وكان أول ما نطقت به بعد شهور، ” أنا السبب.. أنا السبب “، وأصبح الأرق رفيقي كلّ ليلة.
أستمطر ذاكرتي من جديد.. يطالعني وجهه من خلال نافذة السيارة مفعمًا بالألم والضياع حين اقتاده شرطيان من البيت، أذكر أنني سقطت أرضًا وأنا أسمعه يردّد:
— ماما لا تخافي.. سأعود سريعًا.
ولم يعُد..
حزن وصمت ولوعة عميقة كالزلزال أو الموت تسري في عروقي، ورغبة جامحة أن أفتح باب السيارة وألقي بنفسي في الطريق، ولكن دموع الحنين والشوق لرؤياه ملأت عينيّ وتساقطت مطرًا غزيرًا.. أموت شوقًا ولهفةً لرؤيته، ذلك الابن، المراهق الصغير الذي تعلّق بي لدرجة أصبحت تضايقني، فأقول له، ” لماذا لا تصاحب صديقًا وتخرج معه؟ ”
وصاحب أصدقاء كثر، لم أعرف عنهم شيئًا.. ابتعد كثيرًا، إلى ذلك اليوم الذي قال لي، ” لماذا لا تسأليني من هم أصدقائي؟ ”
كان يطلب مساعدتي، ولكنني وبكل غباء وقسوة لم أعره اهتمامًا.
حين وصلت السجن، اقتادوني إلى غرفة صغيرة فيها كرسيان ومنضدة، بعد التفتيش وبعد أن أخذوا حقيبة الملابس الصغيرة التي جلبتها له وبعض الطعام الذي يحبه.. كنت أرتجف، جفّ ريقي، حاولت دون جدوى أن أسيطر على ارتجاف يديّ.. أمطارًا انسكبت دموعي حين رأيته قادمًا نحوي، احتضنني بقوّة أشعرتني أنه لم يعد ذلك الصبي الصغير الذي كان ملتصقًا بي كجلدي..
— أنا آسف يا أمي، سبّبت لك الكثير من الألم.
اختنقت، حاولت أن أخرج تلك الغصّة التي تكسّرت في صدري، ولكن لم أجد ما أقوله سوى دموعٍ صامتة.