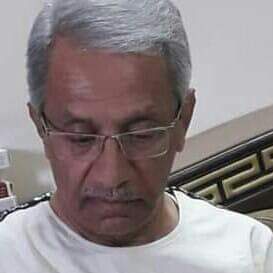(وحدة الوجود) بين ابن عربي و اسبينوزا ..
د.علي أحمد جديد
لأنّ ظاهرة التصوّف ظاهرة عالميّة عابرة للأديان والزمان والمكان ، فهي تجربة ذاتيّة فرديّة ، كمذهب روحيّ متمثّل في كلّ الديانات ، يسعى فيها المتصوِّف لاكتشاف الحقيقة الجوهريّة للوجود من خلال تصفية القلب ، والتأمّل ، والتخلّي عن رغبات الجسد وشهواته ، وعن كلّ العيوب الأخلاقيّة ، والتحلّي بالفضائل والتواضع ، والتقشّف ، والزهد .
وباستعراض عناصر التشابه ، والاختلاف في التصوّف عند الديانات الثلاث .
وثمّة مُشتَرَك موجود عند متصوّفي الديانات الثلاث يظهر من خلال ممارسة بعض الطقوس من الناحية الظاهرية ، سواء في طقوس الذِكر والإنشاد حيث يركّز الشخص المتصوّف على كلمات معينّة ، ويردّدها تكراراً حتّى يصل إلى ذروة الشعور .
أو في طقوس التأمّل الذي يتمّ بالتركيز على كلمة معيّنة وترديدها وتكرارها وفق نغمات معيّنة . فالمتصوّفة من اليهود ، مثلاً ، يركّزون على اسم الرب (يَهْوَه) ، والمتصوّفة من المسيحيّين يركّزون على اسم السيدة(مريم العذراء) ، أو على اسم (أبانا الذى في السموات) ، أمّا المتصوّفة من المسلمين فيركّزون على اسم (الله) أو على (الصلاة على محمّد وآل محمّد) مع استخدام التنفّس العميق المنتظم في شهيقه وزفيره . وقد يكون التركيز التأمّليّ على الصدقية الروحيّة عند المتصوّفين اليهود في (القَبّالة الحسيدية) ، أو تلك التي يتمّ التركيز فيها لدى غير اليهود على المشاعر التي يثيرها وجود الربّ ، أو المسيح ، أو حضرة الرسول الأكرم (محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم) .
وفى طقوس التلاوة ، ثمّة اشتراك بين متصوّفي الديانات الثلاث في قراءة الأذكار ، أو التلاوة من الكتب المقدّسة ، على أن تكون القراءة صامتة أو بصوت جهوريّ ، وعلى تكرار كلمة أو عبارة واحدة أثناء القراءة أو التلاوة . وهناك ما يشبه الاتّفاق على أنّ القراءة الصامتة هي الطريق الأسلم إلى القلب وإلى تنمية الحسّ الذي من خلاله يمكن الحصول على النور والتقرّب من الله تعالى .
ومن خلال استعراض جوانب الطقوس نجد تجانساً بين متصوّفي الديانات الثلاث على مستوى فعل الطقوس ، ولكنّه يختلف على مستوى الكيفيّات ، إذْ يتفرّع عن ذلك عدّة مفاهيم :
* – مفهوم الخلوة :
لأنّ مفهوم الخلوة ذو أصلٍ دينيّ عند متصوّفي الديانات الثلاث ، فقد اعتكف الأنبياء بعيداً عن أعين الناس للتأمل والصلاة ، ومناجاة الله ، سواء (موسى) في طور سيناء ، أوالسيد (المسيح) على جبل الزيتون ، أو النبي (محمد) عليه وآله الصلاة والسلام في غار حراء . وانطلاقاً من ذلك ينسجم مفهوم الخلوة لدى المتصوّفين ، وغالباً ما يدّل إلى دلالة رمزيّة التي تعني الانعزال عن الناس ، والتأمّل في ذات الله وفي خلقه . وباعتبار أنّ لها منافع عديدة ، فهي تُنعش الروح وعلى قَدر اتّساع الصحارى ، والجبال ، تتّسع آفاق النفس ومعها القلب والفكر ، وهي الدلالة التي نجدها ماثلة عند متصوّفي الديانات الثلاث .
* – مفهوم (وحدة الوجود) الذي يعني المماثلة بين الله وبين الوجود ، فالله والوجود هما واحد ، الله هو كلّ شيء وكلّ شيء هو الله ، والله هو الكون والكون هو الله ، ووجود الله يسري في كلّ شيء . وهذا المفهوم متّفق عليه من قبل المتصوّفين في الديانات الثلاث خاصة عند “اسبينوزا” و و”ابن عربي”، وكذلك عند “الحلّاج” كما هي عند “ليكهارت” الذي يؤكّد على أنّ الله هو المتعالي فوق الوجود . ويحاول المتصوّفون استحضار ذلك الموجود المتعالي والذي هو الله ، ولكن تختلف النظرة إلى (وحدة الوجود) باعتبار أنّ الله ماثل في الطبيعة على سبيل الدوام ، أو مفارق للطبيعة لكنّه يتجلى للموجودات ، وهي نظرة المتصوّفين المسلمين .
* – وفي مفهوم الحبّ أو العشق الإلهيّ فإنَّ الله هو الموضوع الأوّل لفضيلة المحبّة عند متصوّفي الديانات الثلاث ، باعتباره واجب الوجود ، و ذو الصفات الكماليّة الثبوتيّة والسلبيّة غير المتناهية ، التي تكشف لنا عن الجمال والرحمة والعدالة الإلهيّة ، ولذلك فهو المحبوب و نور الأنوار وأصل الموجودات ، والكلّ يتّجه إليه . فالعشق الإلهيّ له طابع فرديّ داخليّ في التجربة الصوفيّة الإسلاميّة ، وهو حبّ يتسامى بين الإنسان والوجود ، وهو الفناء في ذات الله ، والاتّحاد فيه والاتّصال بنوره ، والوصول لمقام الشهود . والعشق الإلهيّ في التجربة الصوفيّة المسيحيّة هو المحبّة ، والإيمان والرجاء ، والوصول إلى نور الله . والعشق الإلهيّ عند (القَبّالة) اليهود المتصوّفين يرتكز على أنّهم قَبّاليون مخلوقون من روح الربّ ، التي تؤكد على حلول الربّ في شعبه (المختار) .
وبالتالي فإن الكلّ يتّجه إلى الربّ (يَهْوَه) نور الأنوار ، إلّا أنّها تبدو نظرة متعالية لأنّهم وطبقاً لتعاليم “التلمود” بأنّهم من الربّ ، وبقية الأرواح هي من الشياطين (الأغيار) .
ومفهوم الحلولية بالرب أو الاتّحاد مع الرب فهو هدف المتصوّفين اليهود ، والمسيحيّين ، ولكنّه يمرُّ عند المتصوّفين المسيحيّين عبر ثلاث فضائل أساسيّة وهي (الإيمان ، والمحبّة ، والرجاء) ، إذ يقول “المونسينيور غي” :
“بالإيمان يصبح نور الله نورنا ، وحكمته حكمتنا ، وعمله عملنا ، وروحه روحنا” .
ويكون الاتّحاد بالله في التصوّف المسيحيّ من خلال الاتّحاد بالأقانيم الثلاثة : الآب ، والابن ، والروح القدس ، و قد يكون الاتّحاد مع الله بعيداً عن هذه الأقانيم الثلاثة ، وإنّما هو اتّحاد واحد بسيط يتعالى على قسمة الأقانيم طبقاً لأقوال “ليكهارت” . أمّا الاتصال بالله تعالى في التصوّف الإسلاميّ فهو اتصال شهوديّ عرفانيّ عبر الأنوار والإشراقات والفيوضات التي فيها تجليّات للصفات الإلهيّة ، وعبر الحب الإلهيّ . من هنا نجد أنّ مفهوم الحب الإلهيّ قد يتّفق من جانب ، ويختلف من جانب آخر بالنسبة للمتصوّفين المسيحيّين والمسلمين .
والتجربة الصوفيّة في بحثها عن الإلهيّ والمقدّس ، وتجليّاته في الكون وفي الإنسان ، لا تختلف كثيراً بين المتصوّفين من الديانات السماويّة الثلاث ، إذ نجدها متشابهة في التجارب الروحيّة تبعاً لثقافات دينيّة وإشراقيّة وهنديّة وفارسية ، وهي ذات طابع فرديّ داخليّ و وجدانيّ حيث أنّ العاطفة الجيّاشة تمثّل أساس التجربة الصوفيّة ، فيتجلّى نار العشق الإلهيّ في أبهى صوره عند المتصوّفين ، وهي غير قابلة للصياغة في تصوّرات أثناء التجربة الصوفيّة ، أي يصعب وصفها وصفاً دقيقاً باللغة المتداولة ، ويقول أحدهم :
(إذا اتّسعت الرؤية ضاقت العبارة). ولذلك يستخدم المتصوّفون الرمز أو المجاز في تخاطبهم عن تجربتهم الصوفيّة ، لأن الصوفيّة تتجاوز حدود المكان والزمان ، وشعور الصوفيّ بالخلود أثناء تجربته الصوفيّة ، يكون في لحظة غير زمانيّة ، وأنّ النفس لا تبلغ حالة الاستغراق والتصوّف إلا بعد أن تتجاوز الزمان الآنيّ الأزليّ . وفي هذا الصدد يقول “ليكهارت” : “فالنفس كلّما ارتقت إلى الأعلى ، واتّحدت بالرب ، لا تعي الأمس أو اليوم أو الغد ، فالأزل لا يوجد فيه إلّا (آن) فقط” .
كما تتمثل السمة المشتركة عند المتصوّفين في عدم تقديمهم الأدلّة والبراهين على وجود حقيقة خارجيّة تتجاوز ذاتيتهم .
وفكرة التوحدية أو (وحدة الوجود) مذهب فلسفي عند كثيرين من فلاسفة الصوفية أشهرهم (محي الدين بن عربي) الذي يعتمد المذهب القائل بأن الله والطبيعة حقيقة واحدة ، وأن الله هو الوجود الحق . ويعتبر الله صورة هذا العالم المخلوق ، أما مجموع المظاهر المادية فهي تعلن عن وجود الله دون أن يكون لها وجود قائم بذاته . وهي الفكرة التي تبدأ بالفلسفة الأفلاطونية المحدثة وفلسفة الرواقيين .
ويَعتبرُ بعض علماء أهل السنة والجماعة وعلى رأسهم شيخ التكفيريين المعروف (ابن تيمية) أن من يعتقد بوحدة الوجود زنديق خارج من دين الإسلام .
كما نادى بوحدة الوجود بعض فلاسفة الغرب من أمثال (سبينوزا وهيغيل) . لأن أهل فكرة (وحدة الوجود) يعتقدون أنه لا وجود إلا الوجود الواجب ، وهو وجود واحد لا يتعدد ، وأما العالم فهو موجودٌ بنفس وجود الله تعالى ، لا بإيجاده ، بمعنى أن العالم إنما هو صورة ومظهر للوجود الإلهي ، ولا يمكن أن يحدث وجود العالم بعد عدمه ، بل الحادث عندهم إنما هو صورة العالم بعد عدمها ، والصورة عين المظهر الإلهي ، ولذلك يقولون إن الله تعالى لا يتجلى لغير نفسه .
وفكرة (الواحدية أو وحدة الوجود) هي الاعتقاد أن الكون و الألوهية حقيقة واحدة . والواحدية هي ترجمة للمصطلح اليوناني “Pantheism” الذي يعني “الكل هو الله” .
إذاً فإن (الواحدية) ترمز إلى فكرة واحدية “الله” سبحانه كعملية مرتبطة بالكون . وقد تعددت مذاهب الواحدية وكان منها الواحدية المادية ، والواحدية الروحية . إلا أن الأفكار المشتركة عند (سبينوزا) تنظر إلى العالم ككل واحد ، مع نظرة توقير له وتقديس للكون وللطبيعة .
وقد قال بفكرة (وحدة الوجود) فلاسفة قدماء مثل الفيلسوف اليوناني “هيراقليطس” الذي يرى الله – سبحانه وتعالى – عنده نهار وليل ، وصيف وشتاء ، ووفرة وقلة ، وجامد وسائل ، وهو كالنار المعطرة التي تسمى باسم العطر الذي يفوح منها ، والنار هي النور
– كما يرى سبينوزا – .
وفي الديانة الهندوسية الهندية التي تقول عن الوجود :
” إن الكون كله ليس إلا ظهوراً للوجود الحقيقي ، وإن الروح البشرية جزء من الروح العليا وهي كالآلهة ، سرمديةٌ غير مخلوقة .
كما يقول (محي الدين ابن عربي) الاندلسي بفكرة وحدة الوجود .
وفي القرن السابع عشر الميلادي ظهرت مقولة “وحدة الوجود” لدى الفيلسوف اليهودي سبينوزا ، الذي أخذها عن آراء (ابن عربي) الأندلسي في وحدة الوجود من خلال اطلاعه على مؤلفات الطبيب والفيلسوف اليهودي الأندلسي (موسى بن ميمون) . ولا يخفي (سبينوزا) إعجابه بأفكار (برونو) الفيلسوف الإيطالي الذي مات حرقاً في مرحلة “محاكم التفتيش” وخاصة تلك الأفكار التي تتعلق بوحدة الوجود . حيث عرض أقوالاً اختلف حولها المفكرون ، فمنهم من كان يعتبره من أصحاب (وحدة الوجود) ، وآخرون ينفون عنه ذلك .
وفي القرن التاسع عشر الميلادي عادت تتردد مقولة (وحدة الوجود) على ألسنة بعض الشعراء الغربيين مثل (بيرس شيلي 1792 – 1822م الذي يقول بأن الرب – كما يرى في رأيه – :
“هو هذه البسمة الجميلة على شفتي طفل جميل باسم ، وهو هذه النسائم العليلة التي تنعشنا ساعة الأصيل ، وهو هذه الإشراقة المتألقة بالنجم الهادي في ظلمات الليل ، وهو هذه الورود اليانعة تتفتح وكأنها ابتسامات شفاه جميلة إنه الجمال أينما وُجِد ..” .
وهذا يؤكد بأنه كان لمذهب (وحدة الوجود) أنصار في أمكنة وأزمنة مختلفة ، وإن نظرية (وحدة الوجود) قديمة جداً ، وكانت قائمة بشكل جزئي عند اليونانيين القدماء ، وكذلك كانت في الهندوسية الهندية . وانتقلت الفكرة بعد ذلك إلى بعض المتصوّفة المسلمين من أبرزهم : (محي الدين ابن عربي ، وشرف الدين عمرابن الفارض ، وابن سبعين ، وعفيف الدين سليمان بن علي بن عبد الله التلمساني) . ثم انتشرت في الغرب الأوروبي على يد الفيلسوف المسيحي (برونو) و(سبينوزا) اليهودي . وكان من أبرز الشخصيات وأفكارهم الشيخ (محي الدين ابن عربي) 560هـ – 638هـ الذي هو (محي الدين محمد بن علي بن محمد بن عبد الله العربي الحاتمي الطائي الأندلسي) ، أحد أبرز مشاهير الصوفية ، وقد عُرِفَ بلقب الشيخ الأكبر . ولد (ابن عربي) في (مرسية) بالأندلس سنة 560 هـ وانتقل إلى (أشبيلية) حيث بدأ دراسته فيها ثم عمل في شبابه كاتباً لعدد من حكام الولايات .
وبعد مرض أَلَمَّ به كان التحوّل في حياته وانقلب بعد ذلك زاهداً سائحاً منقطعاً للعبادة والخلوة ، وقضى بعد ذلك حوالي عشر سنوات متنقلاً بين مدن الأندلس المختلفة وبين شمالي إفريقية بصحبة عدد من شيوخ الصوفية .
ولما بلغ الثلاثين من عمره انتقل إلى تونس ثم ذهب إلى فاس حيث كتب كتابه (الإسراء إلى مقام الأسرى) ثم عاد إلى تونس ، ومنها سافر شرقاً إلى القاهرة والقدس واتجه جنوباً إلى مكة حاجاً ولزم البيت الحرام لعدد من السنوات ، وألَّف في تلك الفترة كتابه التصوفي (تاج الرسائل، وروح القدس) ليبدأ سنة 598 هـ بكتابة مؤلفه الضخم (الفتوحات المكية).
وفي السنوات التالية انتقل برحلاته بين بلاد الأناضول وحلب ودمشق والقدس والقاهرة ومكة ، ليستقر بعدها في دمشق لدى عائلة (ابن الزكي) وأفراد من الأسرة الأيوبية الحاكمة بعد أن وَجَّه إليه الفقهاء سهام النقد والتجريح ، والاتهام بالكفر والزندقة . وفي تلك الفترة ألّف كتابه (فصوص الحِكَم) وأكمل كتابه (الفتوحات المكية) وتوفي في دار القاضي (ابن الزكي) سنة 638هـ ودفن بمقبرة العائلة في سفح جبل قاسيون .
تتلخص نظرية (ابن عربي) في (وحدة الوجود) بإنكاره لعالم الظاهر ولا يعترف بالوجود الحقيقي إلا لله تعالى ، والخلق هم مجرد ظلال للوجود الحق فلا موجود إلا الله وهو وحده الوجود الحق حيث يقول :
“سبحان من أظهر الأشياء وهو عينها” .
ويقول مبيناً في إثبات (وحدة الوجود) وفي أن الله يحوي في ذاته كل المخلوقات :
يا خالق الأشياء في نفسه
أنت لِما تَخلقُ جامِعُ
تخلق ما لا ينتهي كونُهُ
فيكَ فأنتَ الضيِّقُ الواسِعُ
وبناءً على هذا التصور فقد فسّرَ خصومه ذلك بأنه :
“ليس هناك خلق ولا موجود من عدم ، بل مجرد فيضٍ وتجلٍّ . ومادام الأمر كذلك ، فلا مجال للحديث عن علة أو غاية ، وإنما يسير العالم وفق ضرورة مطلقة ويخضع لحتمية وجبرية صارمة . وهذا العالم ليس فيه خير وشر ، ولا قضاء وقدر ولا حرية أو إرادة. ومن ثم لا حساب ولا مسؤولية ولا ثواب ولا عقاب ، بل الجميع في نعيم مقيم . والفرق بين الجنة والنار إنما هو في المرتبة فقط لا في النوع . وأكّدوا على تفسيرهم بقوله في الجبر الذي هو من نتائج فساد مذهبه :
الحكمُ حكمُ الجبرِ والاضطرار
ما ثَمَّ حكمٌ يقتضي الاختيار
إلا الذي يُعزى إلينا ففي
ظاهره بأنّهُ عن خَيار
لو فكّر الناظرُ فيه رأى بأنَّهُ
المختار عـن اضطرار
فإذا كان قد ترتب على قول (ابن عربي) بوحدة الوجود قوله بالجبر ونفى الحساب والثواب والعقاب . فإنه ترتب على مذهبه أيضاً قوله بوحدة الأديان حيثُ يؤكد (ابن عربي) على أن من يعبد الله الواحد في مسجد أو يعبد في كنيسة أو معبد كلهم سواء لأنهم في الحقيقة ما عبدوا إلا الله إذ ليس ثمة فرق بين خالق ومخلوق .
ويقول في ذلك:
لقد صار قلبي قابلاً كلَّ صورةٍ
فمرعى لغزلانٍ وديرٌ لرهبانْ
وبيتٌ لأوثانٍ وكعبةُ طائفٍ
وألواحُ توراةٍ ومصحفٌ قرآنْ
وفسَّروا مذهب (وحدة الوجود) الذي يقول به (ابن عربي) بأنه يجعل الخالق والمخلوق وحدةً واحدةً سواء بسواء ، ويترتب على هذا المذهب نتائج باطلة قال بها (ابن عربي) وأكّدها في قوله بالجبر وفي نفيه الثواب والعقاب ، وكذا قوله بوحدة الأديان .
وقد تابع (ابنَ عربي) في القول ب(وحدة الوجود) تلاميذ له أعجبوا بآرائه وعرضوا لذلك المذهب في أشعارهم وكتبهم من هؤلاء(ابن الفارض وابن سبعين والتلمساني) .
أما (ابن الفارض) فيؤكد (وحدة الوجود) في قصيدته المشهورة بالتائية:
لها صلاتي بالمقام أُقيمُها
وأشهدُ أنها لي صَلَّت
كلانا مُصَلٍّ عابِدٌ ساجِدٌ إلى
حقيقة الجَمْعِ في كلٍّ سجدَت
وما كان لي صلى سواي فلم تكن
صلاتي لغيري في أداءٍ كلٌ ركَعَت
ومازالت إياها وإياي لم تزل
ولا فرق بـل ذاتي لذاتي أحبَّت
والصوفية معجبون بهذه القصيدة التائية ويسمون صاحبها (ابن الفارض) بسلطان العاشقين . أما (التلمساني) وهو كما يقول عنه شيخ التكفيريين (ابن تيمية) :
“من أعظم هؤلاء كفراً وهو أحذقهم في الكفر والزندقة . فهو لا يفرق بين الكائنات وخالقها ، إنما الكائنات أجزاء منه ، وأبعاض له بمنزلة أمواج البحر في البحر ، وأجزاء البيت من البيت ، ومن ذلك قوله :
البحر لا شك عندي في توحده
وإن تعدد بالأمواج والزبدِ
فلا يغرَّنَك ما شاهدتَ من صُوَرٍ
فالواحد الرب ساري العين في العددِ
والوجود عند التلمساني واحد ، وليس هناك فرق بين الخالق والمخلوق ، بل كل المخلوقات إنما هي الله ذاته” .
وقد وجد لهذا المذهب صدىً في بلاد الغرب بعد أن انتقل إليها على يد (برونو) الإيطالي ورَوّج له (اسبينوزا) .
والفيلسوف (جيور وانو برونو) مفكِّر إيطالي ، درس الفلسفة واللاهوت في أحد الأديرة الدينية ، إلا أنه خرج على تعاليم الكنيسة فاتُّهِم بالزندقة وفرّ من إيطاليا وتنقل طريداً في البلدان الأوروبية وبعد عودته إلى إيطاليا وُشيَ به إلى محاكم التفتيش فحكم عليه بالموت حرقاً .
و(باروخ سبينوزا) فيلسوف هولندي يهودي الديانة ، هاجر أبواه من البرتغال في فترة الاضطهاد الديني لليهود ودرس الديانة اليهودية والفلسفة كما هي عند (موسى ابن ميمون) الفيلسوف اليهودي الذي عاش في الأندلس وانتقل إلى الشام وصار الطبيب الخاص للسلطان (صلاح الدين الايوبي) ومستشاره الذي استحصل منه على مرسوم سلطاني يبيح لليهود العمل والإقامة في مدينة (القدس) بعد تحريرها لأن الصليبيين كانوا يُحَرِّمون عليهم دخولها ، وكذلك عند (ابن جبريل) وهو أيضاً فيلسوف يهودي عاش في الأندلس كذلك .
ومن أقوال (سبينوزا) التي تؤكد على اعتقاده في (وحدة الوجود) :
“ما في الوجود إلا الرب ، فالرب هو الوجود الحق ، ولا وجود معه يماثله لأنه لا يصح أن يكون هناك وجودان مختلفان متماثلان” .
“إن قوانين الطبيعة وأوامر الرب الخالدة شيء واحد بعينه ، وإن كل الأشياء تنشأ من طبيعة الرب الخالدة” .
“الرب هو القانون الذي تسير وفقه ظواهر الوجود جميعاً بغير استثناء أو شذوذ”.
“إن للطبيعة عالماً واحداً هو الطبيعة والرب في آن واحد وليس في هذا العالم مكان لما فوق الطبيعة”.
ويقول (ابن تيمية) بعد أن ذكر كثيراً من أقوال أصحاب مذهب (وحدة الوجود) :
“يقولون إن الوجود واحد كما يقول ابن عربي – صاحب الفتوحات – وابن سبعين و ابن الفارض والتلمساني وأمثالهم – عليهم من الله ما يستحقونه – فإنهم لا يجعلون للخالق سبحانه وجوداً مبايناً لوجود المخلوق . وهو جامع كل شرّ في العالم ، ومبدأ ضلالهم من حيث لم يثبتوا للخالق وجوداً مبايناً لوجود المخلوق وهم يأخذون من كلام الفلاسفة شيئاً ومن القول الفاسد من كلام المتصوّفة والمتكلمين شيئاً ، ومن كلام القرامطة والباطنية شيئاً ، فيطوفون على أبواب المذاهب ويفوزون بأخسِّ المطالب ، ويثنون على ما يذكر من كلام التصوف المخلوط بالفلسفة” .
أي أنه يُنكِرُ عليهم استخدام العقل والتأمل للوصول إلى حقيقة الدين وإلى مقاصد الرسالات السماوية .
وتقوم نظرية (وحدة الوجود) على أن الكون عين أعيان الثابتة (صورة العلمية) وأعيان الثابتة عين علم الله سبحانه وتعالى . ويقول الشيخ (محيي الدين ابن عربي) :
“إن أسماء الواجب و صفاته جل و علا عين ذات الواجب سبحانه و كذلك بعضها عين بعض الآخر مثلا العلم و القدرة كما أنهما عين ذاته تعالى كذلك كل منهما عين الآخر أيضاً فلا يكون في ذلك الموطن” .