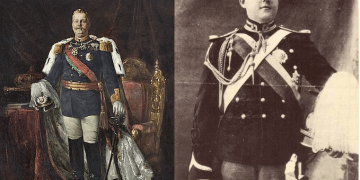بين التاريخ والتأريخ ..
د.علي أحمد جديد
يقول (آرثر سالزبورغ) مؤسس صحيفة ” نيويورك تايمز ” الأمريكية :
” إن رأي الإنسان – أي إنسان – في أيّة قضيةٍ كانت لايمكن أن يكون جيداً إلا بفضل المعلومات التي نقدِّمُها له حول هذه القضية . فإذا أعطيناه معلوماتٍ صادقةً وصحيحة ، ثم تركناه يكوِّن رأيَه فيها فإنه سيَظلُّ عرضةً للخطأ في رأيه بعضَ الأحيان حول هذه القضية ، وربما لبعضِ الوقت .
لكن فرصةَ تصحيح رأيه تبقى متاحةً له وبين يديه وإلى الأبد .
أمّا إذا حجبنا عنه المعلومات الصادقة والصحيحة ، أو تَعمَّدنا أن نقدِّمها له مُشوَّهةً أو ناقصةً .. أو مُغلَّفةً بالدعاية وبالتحريف والتزييف ، فإننا نكونُ قد عمِلنا على تدمير بُنيةِ تفكيره السليمة . بل ونكونُ قد نزلنا به إلى مادونِ المستوى الإنساني “* .
إن تزوير التاريخ ليس بجديد على كل مؤرخي الأنظمة السياسية ، لأنه بالنسبة للمؤرخين وللانظمة على حدٍّ سواء وسيلة لتحقيق المصالح الشخصية حتى ولوكان على حساب مصالح الشعوب الوطنية والقومية والعقائدية .
ولا يقتصر الأمر عندهم على تزوير وقائع التاريخ وأحداثه فحسب ، بل يتفننون بصنع تاريخ موازٍ ومحرَّفٍ من خلال تقديم قراءات وهمية لحقيقة الأحداث التاريخية .
واليوم ، ندرك تماماً أن التاريخ العربي والإسلامي بات بحاجةٍ إلى التصحيح الحقيقي ، من خلال ومضةِ لحظةِ تمرّدٍ إنسانية بعيدة عن الكراسي والعروش ، لأن القيم الإنسانية الكبرى مثل “الحقيقة والحرية والعدالة” لا تشيخ مهما تغوّلوا بانتهاكها وبالتعتيم عليها ، ومهما تغيّرت أدواتها . وإن جرأة العمل على تصحيح التاريخ هي “الخندق الأخير” في المواجهة للدفاع عن الهوية والانتماء ، وهو دفاع مشروع عن القيم الإنسانية والحق العربي ، وعن تعزيز الصمود أيضاً في وجه جرّافة التحريف والتزوير التي دامت منذ أكثر من أربعة عشر قرناً من السنوات ومازالت حتى اليوم ، ذلك التحريف المتعمَّد والممنهج الذي نال حتى من أقدس المقدسات التاريخية والحضارية التي منها تاريخنا الحضاري في “سورية الكبرى” وحتى الوصول إلى الأحاديث النبوية الشريفة . وإن الانحطاط الذي تعرّضنا ونتعرض له ، لم يكن ناتجاً عن قصور ذاتي في أشخاص المؤرخين بوصفهم أفراداً تنقصهم المعرفة ولا الموهبة ، ولكنه نتاج موضعي لواقع أنظمة يتم فرضها سياسياً واجتماعياً وثقافياً منذ بداية العصر (الأموي) وحتى اليوم ، والذي مازالت تحمي تشويهاته مؤسسات وسلطات وتقوم عليه .
إن فرض حرمان المجتمع العربي والإسلامي ، تحديداً ، من التعبير عن الرأي أدى إلى العبث بالوجدان الحضاري ، وإلى صدأ الحساسية الثقافية لدى الشعوب وبالتالي الاستهانة بالحفاظ على تميز الهوية وطنياً و قومياً . وصار لا بد من طرح أسئلة بسيطة عن “العدالة والحرية والأخلاق الطائفية والمذهبية والاحتلال وحق المقاومة والقيم المهدورة وتعميق الفوارق المادية في المجتمع الواحد” ويجري تجاهلها وتجريمها ، بقرارات رسمية ، حتى باتت هذه الأسئلة من المحرّمات التي تعرِّض السائل لقائمة لاتنتهي من الاتهامات .
وإن الأيديولوجية الشخصية للمؤرخ والتي توجه كتابة التاريخ وبخاصة في الأنظمة التي تسعى متعمدة إلى تهميش أو تقزيم أو تغييب دور الآخرين ، والأحداث التي لا تتفق وأصحاب الأيديولوجيات المسيطرة أو السلطات المتسلطة ، وذلك ما كان ملموساً في محاولات السلطة “الأموية” منذ استفراد (معاوية بن أبي سفيان) بكرسي الخلافة في دمشق ، وتوجيهه بتأسيس (الإسلام الأموي) – حسب رأي مستشاره الخاص ومستشار ابنه (يزيد) من بعده (الحاخام سيرينيوس) ، لمحو الخصوصية السورية في بلاد الشام وإحلال الهوية الأعرابية والعبرانية الدخيلة ليتمكن من نشر ( إسلامه الأموي ) المستحدث محل (الإسلام المحمّدي) الذي نزل به (جبريل) عليه السلام إلى النبيّ (محمّد بن عبد الله) عليه وآله الصلاة والسلام . وباتت مشكلة التفريق بين الصحيح في التاريخ وبين المزوَّر حقيقةً شائكةً ومعقّدة حتى اليوم ، إذ أن جزءاً كبيراً منها يتعلق بتغييب حقائق وأحداث ، وجزءاً آخرَ منها هو تهميش أحداث أخرى ، وهو مابات معروفاً اليوم بتسمية (التضليل) عن سابق إصرار وتعمّد ليكون التمهيد الطبيعي في الوصول إلى تشويه الهوية الحضارية وتزوير التاريخ . وإذا تم تقديم القضايا التاريخية بحقائق نسبية وليست قاطعة في أغلبها ، فإن باب التأويل ولَيّ عنق بعض الحقائق ممكن لتحقيق مصالح سلطوية سياسية أو اقتصادية وثقافية . وحين تكون السلطة أو البطانة التي حولها هي التي تفرض الخبر و تكتب الوثائق ، فإنها ستكتب ماهو في مصلحتها وبعيداً عن الحيادية أوالموضوعية ، مما يعني ذلك أن هناك حقائق في التاريخ قد تم إقصاؤها أو تشويهها وتحريفها ، وخاصة مايثبت يوماً بعد يوم عن تزوير الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة المكذوبة والمروية عن (أبي هريرة) الذي لم يتجرأ على رواية أي من أحاديث (الإسرائيليات) إلا حين استقر في بلاط (معاوية) الأموي . ونسمع بين الحين والآخر عن اكتشاف تزويرٍ أو تحريف أو افتراء قد حدث لواقعة معينة ، وأن وثائق قد اكتشفت – صدفة – تفرض إعادة قراءة وتركيب وقائع تلك الواقعة التاريخية .
فإذا كانت هذه هي الصورة العامة التي يعانيها التاريخ أو التي يعانيها دارسو التاريخ والباحثون في خفاياه ، والمنقبون في ركام أحداثه عن الحقائق لتصل إلى الأجيال المتعاقبة كما حدثت ، دون إسقاط أو تغييب ، وهذا يكاد يكون من المستحيلات ، لأن كتابة التاريخ الإسلامي بالتحديد الذي بدأت كتابته منذ أيام (معاوية بن ابي سفيان) وتناول فيه المؤرخون مرحلته حسب الرؤية الأموية ، إضافة إلى تناول ماسبقها من التاريخين العربي والإسلامي ، في محاولة لإضفاء شيء من المصداقية على مايكتبون ، والإيحاء بأن ذلك التاريخ قد كتب بكل صدقية وأمانة . لنصل إلى مايؤكد بأن التاريخ العربي قد تم تزويره ويحتاج إلى إعادة كتابة جديدة وأن التاريخ الحضاري السوري في بلاد الشام لم تتوقف محاولات دثره وإخفائه ، لكن ما لا يمكن تغييره هو الحدث التاريخي والوثيقة التاريخية ، وكل مانملكه فقط هو البحث عن وثائق جديدة والتشكيك بالوثائق المتوفرة ، وهي متهمة حتى تثبت تبرئتها ، لأن من كتبها أو مَن وجّه بكتابتها هم حكام كتبوها طبقاً لمصالحهم السلطوية ، أو أشخاص اجترحوا أحداثها لمنفعتهم الشخصية ، أو لدوافع مذهبية وطائفية واجتماعية ، أو سياسية ذاتية وليست موضوعية .
نحن اليوم نحن أمام إشكالية تجاهل وتغييب الحقائق الواضحة في التاريخ العربي ، وهذا يتطلب أن نقف على أسباب حدوث ذلك وعرض هذا التجاهل والتغييب وأسبابه بكل صدق وشفافية ، حتى نعيد للتاريخ اعتباره بكتابة ما لم يكتب ، لأنه قد يكون إحياء ماتم تغييبه والكشف عنه في تاريخنا يغير كثيراً مما كتب تاريخياً ، وبذلك قد نكتشف تزييفاً أو تضليلاً لأجيالنا ونجد أنفسنا أمام مهمة أخرى في منتهى الحساسية والخطورة ، والتي هي الجرأة على تصحيح المعوّج والخاطئ والمزيف في التاريخ ، ثم تغيير مفاهيم ومعلومات تاريخية تشربتها الأجيال المتلاحقة ، وهذه ليست مهمة سهلة أبداً ، لأنها تحتاج إلى مؤرخين ثقاة وحياديين ،وتتوفر فيهم الصدقية العلمية ، كما تحتاج إلى إمكانيات مادية . والأهم ، أنها تحتاج إلى مناخ حرّ للبحث في الممنوع والمغيَّب .
فهل ننتظر حتى يأتي الوقت المناسب الذي تتوفر فيه تلك الإمكانيات والمناخات ، وقد لايأتي .. أم أننا بحاجة للاقتناع بأنه هناك الكثير من الوقائع المغيّبة في تاريخنا أو تم تهميشها وتجاهلها عمداً ولابد من التضحية والمباشرة في دراستها والكشف عنها ؟
إن الطرح النظري ، أحياناً كثيرة ، قد يرضي النفس ويريحها ، ولكنه أبداً لا يقدم شيئاً ملموساً لأسباب موضوعية نعيشها ، فالواقع قد لا يسمح بالبحث فيما تم تغييبه عن الذاكرة الجمعية الوطنية او القومية من التاريخ ، لأن القوة المسيطرة لا تريد ذلك ، أو لأنه قد يؤثر على نفوذها وسلطتها وهيبتها لأنها لا تعرف ماهية ماتم تجاهله وتغييبه ، حتى ولو كان فيه ماهو لصالحها ، ولأنها دائماً تتوقع الأسوأ فتلجأ إلى منع أو إهمال أية خطوة أو حتى التفكير في ذلك الاتجاه .
وهنا يمكن أن نحمل بعض الأسباب التي تكمن وراء السكوت عن العبث في تاريخنا :
1). لقد لعبت السلطات دوراً في كتابة التاريخ وهي التي كتبت الوثيقة التاريخية في الغالب . لأن الصدق الذي جاء به كلٌّ من (ابن خلدون و المقريزي ) وغيرهما ، قِلّة تمتعوا بالموضوعية وكتبوا بعيداً عن تأثير السلطات .
2). إن الحالة العامة في المنطقة (سورية الكبرى والوطن العربي) من العصور المختلفة لم توفر مناخاً حرّاً يمكن لأي مؤرخ مستقل ولم تتِح له أن يكتب التاريخ كما حدث ، وكانت السلطات دائماً تشهر سيفها في وجه كل المحاولات ، وأقرب الأمثلة في ذلك ماحدث في عملية التخلص من الزعيم (أنطون سعادة) ، ولأن مؤرخي اليوم “ملكيون أكثر من الملك” ينافقون في كتاباتهم التاريخية ويغيّبون الحقائق عن الشعوب لاعتقادهم أن ذلك سيحقق لهم مأرباً أو مصلحة .
3). هناك بعض الأحداث التي لم يدرك الناس ونخبهم السياسية أو المثقفة في وقوع الحدث أو بعد وقوعه بأهمية تدوين وقائعها ، ويكتشف آخرون فيما بعد بأنها مهمة ولكن تم تغييب معلومات دقيقة عنها .
4). وجود الجهل بمنهجية التأريخ لدى بعض من كتبوا التاريخ الذين كتبوا غير المهم من الوقائع والأحداث وتعمدوا إهمال المهم منها ، وهناك الكثير من الوقائع التاريخية المهمة تم الوصول إلى حقيقتها ليس عن طريق تلك الكتابات ، ولكن عن طريق مصادر ثانوية ساندت التاريخ بطبيعة وراثة تداولها كالموروثات من الفنون الشعبية (الشعر المحكي والفلكلور والآثار المكتشَفَة) .
5). استجابة مدوّني التاريخ للإغراءات المالية أو السلطوية في تأويل الحدث التاريخي وتعديل وقائعه وصياغته بما يحقق أهداف المصالح الشخصية ، والعروف بأن المؤرخين أو مدوِّني الأحداث التاريخية معلومة وتفسيراً لا يتمتعون جميعهم بالنزاهة وبالموضوعية المطلوبة والضرورية .
لأنه قبل البحث في حقيقة الأحداث التاريخية من الزيف والحقيقي ، يجب البحث في حقيقة المؤرخين وخلفيتهم الفكرية والعقائدية ، ولا يكون ذلك إلا بالنقد التاريخي ، والشك الحيادي في الكتابات التاريخية ، ووجود جيل من المؤرخين تتوفر فيهم الصدقية والموضوعية الحيادية . وبالتأكيد هناك بعضهم أو الكثير منهم ، لكنهم تائهون تحت هذا (التسونامي) الهائل من الزيف والفساد ، وتغييب الإرادة والحرية التي تجبر الجميع على التفكير بالرغيف اليومي والجري وراءه دون اللحاق به .
ومع التطور العلمي والتكنولوجي الذي نعيشه وثورة المعلومات أصبحت مسألة الوصول إلى المعلومة التاريخية أسهل مما مضى وأسرع وأوفر وقتاً وكلفةً ، فإن ما تم تجاهله أو تغييبه في التاريخ المعاصر تضيق مساحته ، ويكاد يكون ذلك صعباً ، لأن التوثيق بالصوت والصورة يتيح البحث ويسهّل كشف الفبركات التضليلية المقصودة ، لكن المشكلة هي في أحداث الماضي التي لم تشهد توثيقاً كالذي نعرفه اليوم ،
وفي تلك الوقائع التي تم تغييبها في التاريخ ولها تأثيرها الكبير في الحاضر لأن جذور ما نعانيه اليوم تكمن في الماضي ، حين يتم تغييب أحداث الماضي فإنه يصعب فهم وفك طلاسم وقائع الحاضر ، ويصعب من علاج الواقع المفروض طائفياً ومذهبياً و سياسياً كما في لبنان وإثنياً كما في سورية والعراق ومؤخراً في السودان دون فهم جذور هذه الأزمات والتي تم زرعها في الماضي القريب منه أو البعيد .
=============
* – من مقدمة كتابي (الأصولية والإسلام السياسي) ..
قيد الطباعة والنشر .