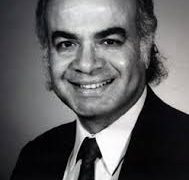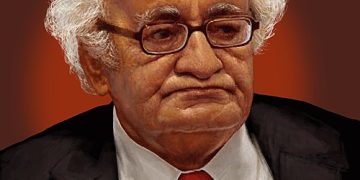دراسة لرواية ” الموت مرتان”
الأديب: محمد البنا/مصر
بقلم: سمية الإسماعيل/ سورية
” الموت مرتان” رواية تنتمي إلى الأدب الاجتماعي النفسي الذي يعكس علاقة الفرد بالمجتمع، حيث يصور الكاتب صراع الشخصية الرئيسة مع قوى القهر والتهميش. تتبنى الرواية منظورًا سرديًا يسلط الضوء على الفرد المهمش في بيئة اجتماعية قاسية، لتطرح إشكالية العزلة، والاغتراب داخل المجتمع المغلق و الذي يؤدي بدوره إلى الانتقام.
الثيمة في الرواية:
تنطوي الرواية على مجموعة من الثيمات التي تسلط الضوء على صراعات داخلية وخارجية للشخصّية الرئيسة في تعاطيها مع المجتمع- تتسم بالتعقيد والتشابك، و تبرز الأبعاد الفلسفية التي تتناول الوجود والاغتراب، تزيد من عمق الرواية وتعدد مستوياتها. و تعكس معاناة الإنسان في رحلة البحث عن المعنى، سواء في الحب أو الهوية أو الحرية، أبرزها:
*الاغتراب والنبذ الاجتماعي
يعد غريب نموذجًا للفرد المغترب داخل مجتمعه، إذ نشأ منبوذًا منذ طفولته، فلم يجد قبولًا بين أهل قريته. تتجسد هذه الثيمة في عدة مشاهد، منها قول غريب:
عن الانتماء
” ولا تتعجبوا إن أخبرتكم أنني لا أنتمي إليها، أو هكذا هم قالوا ذلك عن أبي وأمي، ويقولون ذلك الآن عني، لذا فهي ليست قريتي ولا أهلها أهلي”
يعكس هذا التصوير شعور العزلة التي عاشها البطل منذ الصغر، حيث فُرضت عليه حدود اجتماعية لم يتمكن من تجاوزها.
“نشأتي بين أقراني كانت أيضًا غريبة”
ليطرح علينا السؤال الوجودي:
“وأنا!.. من أنا أو كيف ينظرن إلي؟.. ألست عبدًا مطيعًا لأوامر رجالهن؟ ما الضير إذًا أن يرونني عبدًا لهن أيضًا، أفعل لهن ما يرضيهن ويشبع شهواتهن”
* الديستوبيا الجمعية /القهر الاجتماعي / التدنّي الأخلاقي :
تصور الرواية المجتمع القروي باعتباره كيانًا قمعيًا يمارس سلطته على الأفراد المختلفين. هذه الصورة الديستوبية لا تتجسد فقط في سلوك أهل القرية تجاه غريب، بل تمتد إلى تعاملهم مع”الدجاجة”، والتي يتم التضحية بها كما ضُحي بغريب. إن إحراق الدجاجة إلى جانب غريب يعكس ذهنية الإقصاء الجماعي التي تستهدف كل ما هو خارج عن المألوف.
*الانتقام بوصفه استجابة نفسية للقهر/ تحقيق العدالة
يشكل الانتقام المحور الرئيس للرواية، حيث يسعى غريب للانتقام من أهل القرية الذين تسببوا في معاناته منذ صغره إلى حين محاولة حرقه في المرة الأولى. هذه الثيمة لا تطرح الانتقام كفعل عدواني فحسب، بل كمحصلة طبيعية للتهميش الذي تعرّض له. يعيش غريب هذا الهاجس كونه طريقه الوحيد للشعور بالعدالة، هذا من ناحية.
-من ناحية أخرى هناك الانتقام الذي قام به أهل القرية من غريب بعد اكتشافهم لعلاقته مع نساءهم. فكان قتله حرقًا نوعٍ من التطهير و الذي سبب لغريب” الموت مرتان”
“خشوا أن أكون عدت إليهم لأنتقم منهم، لمحاولتهم قتلي من قبل، حين كنت غريب، فاعدوا خطتهم لقتلي، ”
-انتقامٌ آخر لا يلوح واضحًا في العلن ، انتقام ” الدجاجة” من “غريب” لرفضه لها.
💥الحبكة في رواية “الموت مرتان”
تبدأ الرواية بطريقة بانوراميّة، بقصدية تعريفنا على البيئة setting التي تدور فيها الأحداث، التي بدورها أثّثت لما سيليها من وقائع و تغييرات في المحيط و الشخصيّة المحورية التي اتخذت أيضًا دور الراوي المخاطب، ومن ثم يقحمنا فجأة في السرد وذلك عندما خاطبنا الراوي كقرّاء، أراد أن يجعلنا شركاء في معاناة” غريب”، كأنه يستدرجنا لنشعر بوطأة الظلم والنبذ. و لنكون شهودًا و حكمًا على كل ما سيخبرنا عنه ..
“ما جئت لكم ساردًا قصتي إلا لأنني انتظر حكمكم العادل المنصف حتى ترتاح روحي”
من عالم البرزخ يحدثنا.. إذًا سيقوم الكاتب اعتمادًا على تقنية تيار الوعي السردي بعملية استرجاع للأحداث..
ندخل عالم ” غريب” هذه الشخصيّة المحورية التي لم يتم اختيار الكاتب لاسمها اعتباطًا..
“أنا غريب…هذا هو بالفعل اسمي، نعم اسمي غريب، منذ وعيت على نور دنياكم هذه، وهم ينادوني بـ غريب”
فها هو يبدأ بالتعريف بنفسه و عائلته لنكتشف أن هناك ما يؤرقه و يكون أحد الثيمات التي تتعرّض لها الرواية.. “البحث عن الانتماء” أو الاغتراب و العزلة عن المجتمع الذي وجد نفسه فيه .. يقول:
“ولدت في غرفة مظلمة”
و هذا أول الغيث.. إذًا هي صورةٍ عميقة لحياة شخصية “غريب”، الذي نشأ في بيئة مليئة بالغرابة والعزلة. فلا القرية قريته و لا أهلها أهله يقول:
” ولا تتعجبوا إن أخبرتكم أنني لا أنتمي إليها، أو هكذا هم قالوا ذلك عن أبي وأمي، ويقولون ذلك الآن عني، لذا فهي ليست قريتي ولا أهلها أهلي”
قرية لا يعترف أهلها بانتمائه إليهم، مما يجعله دائمًا على الهامش، يؤدي أدوارًا خادمة للمجتمع دون أن يكون جزءًا منه. فهم سادتها و كبرائها
“القوطية، والبراهمة، والعويسة هم قاطنو هذه القرية…. هم أكابرها وفلاحوها، نسبهم كما قالوا نسب نقي، إذ لا يتزاوجون إلا من نساء نفس العائلة،”
تتراوح الرواية بين واقع معقد من الفقر، والقسوة الاجتماعية، والعلاقات الإنسانية المعقدة،لتطرح أسئلة حول الهوية، و مفارقات حياتية ثقافية، وحكمًا مجتمعيًا على فردٍ عايش تجارب عدة، منها “الموت مرتان”.
تتصاعد الحبكة تدريجيًا من الطفولة المهمشة إلى الشباب المستغل، ثم إلى النهاية التي تتأرجح بين الموت الحقيقي والموت الرمزي.
بنية الحبكة وتصاعدها
*النشأة والعزلة:
منذ بداية القصة، يتضح أن “غريب” لا ينتمي إلى القرية بشكل كامل، فهو يعيش فيها لكنه ليس منها، كما يعكس اسمه “غريب” هذه الفكرة.
فأهل القرية يعاملونه كخادم، وأقرانه يعزلونه، والنساء يستغللنه سرًا، بينما في العلن يبقى منبوذًا.
“لا أزال مستغربًا أفعال أقراني وتصرفاتهم الغريبة معي، تصرفاتهم لم تكن نزعات فردية”
*الاستغلال والتمييز الطبقي:
غريب يُستخدم كعامل لدى عائلات القرية، ولا يُسمح له بالاندماج معهم اجتماعيًا، بل حتى في اللعب، يُقصى إلى موقع حارس المرمى فقط.
“”فما من فريقٍ منهم لعبت معه إلا وخصني بحراسة المرمى”
و في مقامٍ آخر ..
“عندما يتوفر لي وقتًا كافيًا لأنضم إليهم في تسابقهم سباحةً في القناة المائية، إلا إنهم كانوا يخرجون من المجرى المائي لحظة ولوجي فيه!…ألا تجدون في هذا الفعل غرابة ؟..أنا وجدتها حينئذ غريبة”
أما النساء فكنّ يستخدمنه لتلبية رغباتهن في الليل، لكنه يبقى بلا هوية واضحة.
“أما الليل فله شأنٌ آخر، خاصة الليالي غير القمرية، فقد كان لها طابعًا خاصًا يميزها عن ليالينا القمرية، فما من ليلة غير قمريةٍ مرت إلا وطرقاتٌ خفيفة خجلة بأنامل مرتجفة تطرق باب بيتي الخشبي المتصدع…”
كلّ ذلك كانت إرهاصاتٍ تؤسس لاضطرام الصراع الداخلي لديه، فقد وقع في شرك الاستحقاق الذي يوليه لنفسه، و حقيقة ما يلقاه من معاملة مغايرة تمامًا إلّا حين يكون عبدًا لرغباتهم جميعًا، نساءً و رجالًا و حتى ولدانًا.
“قالت لي ذات مرة وهى تضع ثوبها على جسدها…. ” أنت ثور يا غريب ولست بشريًا مثلنا “، سمعت وسكتُ إذ بماذا سأرد على قولها؟ وأنا لم أفهم مغزاه!.. أهو قدحٌ أم مدح ؟..ثم ما هو الفرق بين إنسانٍ مثلي والثور الذي في زريبتها؟.. أليس كلانا يقوم بنفس الأعمال الشاقة دون أن يشكو أو يعترض؟”
*الإحساس بالدونيّة و التهميش:
هذه السلوكيات الإقصائية كانت نواة لردّفعلٍ عكسيّ انتقامي عند غريب، -و إن كان بدا عفويًا و غير مدروس- و أقصد بذلك استجابته السريعة لشبق نساء القرية .. كان يغريه المقابل المادي و النفسي، عندما قالت له إحداهن ” أنت ثور” .. و ما كان يرفع من وتيرة التوتر النفسي أنه كان يشعر بتهميشه و دونيّته خاصةً إزاء وفاة والديه:
“عندما رحل أبي كنت لا أزال صبيًا لم يتجاوز الثلاثة عشر عامًا، لذا تفضل علينا بعض رجالهم، فغسلوا أبي وكفتوه، ثم دفنوه في بقعة ترابية خارج مقابرهم، ووضعوا عليها حجرًا،”
“أما حين ماتت أمي بعد أبي بأربع سنوات كاملة، فأنا من غسلتها وكفنتها…..ودفنتها بجواره ووضعت حجرا.”
تتصاعد وتيرة هذا الإحساس عندما يتعلّق الأمر بأمه، أمه التي كانت تعني وجوده:
“في الصباح لم يسألني أحد أين أمي،”
“.لم يسألني أحدهم عن أمي أبدا، حتى جاءت اللحظة التي قتلوني فيها؛ قتلوني ولم يسألني أحدهم أين أمي !!”
*التحول الدرامي والموت الأول:
عندما تكتشف القرية علاقته بنسائها، يتم التخلص منه، ويحترق بيته كرمز لحرق هويته ووجوده نفسه، لكن المفارقة أن الجثة التي دفنت لم تكن له، مما يجعله ينجو من الموت الجسدي بينما يظل في حكم الموت الاجتماعي.
“هربت بينما احترق بيتي، وعلمت فيما بعد أنهم بعد أن أحرقوه، لملموا عظامي- أو ما ظنوها عظامي- ودفنوها بجوار البقعة التي دفنوا فيها أبي وأمي، ولكنهم مضوا ولم يضعوا حجرًا!!”
*المدينة والموت الثاني:
ينتقل غريب إلى المدينة حيث يتم استغلاله مرة أخرى ولكن بطريقة مختلفة، إذ يجد نفسه في خدمة سيدة من طبقة راقية تستغله جنسيًا. هذا يرمز إلى استمرار استعباده في صورة أخرى،
“الآن سأملي عليك شروطي فاحفظها جيدًا، لأن إخلالك بشرطٍ منها سيكون جزاؤه إلقاءك في الشارع بالجلباب الذي أتيت به إلى هنا.”
*النهاية المفتوحة والتساؤل حول الظلم والعدالة:
في النهاية، يجد غريب نفسه أمام الملكين الموكلين بحسابه، لكنه لا يعرف إن كان ظالمًا أم مظلومًا. هذا التساؤل يطرح بُعدًا فلسفيًا عميقًا عن طبيعة الظلم والعدالة، وهل كان غريب مذنبًا في حياته، أم كان مجرد ضحية لمنظومة ظالمة؟
“إلا أنهم اختلفا ظالمٌ أنا أم مظلوم، وما زالا مختلفين وروحي معلقة لا تدري إلى أين تذهب، إلى أن اقترحت عليهما أن نعرض المعضلة عليكم، ربما يجدان في رأيكم ما قد يرجح إحدى الكفتين على الأخرى.”
بالنطر لقضيّة الموت المرفوعة ضمن سطور الرواية، هذا الموت الذي يتكرر مرتين في حياة غريب ليس فقط موت الأفراد في حياته، بل هو موت معنوي أو رمزي أيضًا، حيث يعبر عن انتقال غريب بين حيوات متعددة متباينة، وهو ما يشير إلى موت الهوية والذاتية في النهاية.
في الحبكة، تتداخل الأحداث في مستويات زمنية مختلفة، فتتراوح بين الماضي والحاضر مع تداخل الأبعاد النفسية والواقعية في سردية واحدة. هذا التفاعل بين الواقع والرمز يتضح في الطريقة التي يعبر بها غريب عن معاناته، سواء من خلال ملاحظاته على علاقاته مع أفراد القرية أو من خلال ما يظهر من ظلال في علاقته بالجنس الآخر.
تقنية السرد والخطاب الروائي
الراوي المخاطب / العليم: بدا لنا السارد، و هو الشخصيّة البطل” عالمًا بالمروي كلّه يعلم متى بدأت الحكاية ومتى انتهت وكيف سارت أحداثها، ويعلم بالشخصيات ظواهرها وبواطنها، أي سلوكها وأفعالها وأقوالها، وحالاتها النفسية، يقول:
“ثم ومن المؤكد أنها أسرّت لأمها باستغرابها الشديد من طلبي خبزًا مطهيُ في ليلة غير قمرية، وأن أمها فهمت المراد، لكنها بررت ذلك لابنتها قائلةً ” ربما هذا من عاداتهم في صعيد مصر “، وأن الابنة اقتنعت بذلك التبرير”
السرد الذاتي وتيار الوعي:
تستخدم الرواية تقنية السرد الذاتي، مما يتيح للقارئ الدخول إلى وعي غريب واستكشاف أفكاره وهواجسه. كما يعتمد الكاتب على تيار الوعي، حيث تتدفق أفكار غريب بشكل غير خطي، ما يعكس حالته النفسية المضطربة.
إقحام القارئ في النص
يلجأ السارد إلى مخاطبة القارئ مباشرة، كما في قوله:
“عذرًا لقد أخذني الوصف حتى نسيت أن أعرفكم ماهيتي، ماهيتي التي أحسب أن بعضكم كوّن فكرة بسيطة عنها، ولكني أظن وأحسب أن ظني صحيحًا، أنكم أخطأتم
و في مقام آخر…
” ولا أخفيكم قولًا، لأنني ما جئت لكم ساردًا قصتي إلا لأنني انتظر حكمكم العادل المنصف حتى ترتاح روحي،”
هذا الأسلوب يشرك القارئ عاطفيًا في معاناة غريب، ويجعله طرفًا في الأزمة بدلًا من كونه مجرد متلقٍ سلبي.
الشخصيّات المحورية:
💥غريب : الازدواجية في شخصيّة غريب: غريب هو شخصية تتسم بالازدواجية، يعاني من اضطرابات نفسية تجعل من صعب فهم دوافعه بشكل كامل.
نفسيًا: قد يعاني من الاحتقار الذاتي والتمرد ضد المجتمع، إلا أن هذه الصفات تعكس تناقضًا بين رفضه لأن يُحتقر وبين ممارسته لهذا الاحتقار تجاه “دجاجة”.
فهو كان يرفع من استحقاقه لنفسه، مع غرابة سلوك أقرانه، ل إلّا أنه كان يُفسره بما يوافق هذا الاستحقاق:
“فما من فريقٍ منهم لعبت معه إلا وخصني بحراسة المرمى، ربما لضخامة جسمي إذ كنت أكثرهم طولًا، وأعرضهم مناكب”
و عندما يتحدّث عن فتيات القرية و كيف كنّا يختلسن النظر إليه:
“وكنت بالطبع ألمحهن بطرف عيني، إلا أنني كنت أتجاهلن كأنهن غير موجودات في مدى إبصاري.
و حتى إن كان مرفوضًا من الرجال، فهو محط أنظار النساء
” إحداهن قالت لي ذات مرة وهى تضع ثوبها على جسدها الأبيض المشوب بحمرةٍ خفيفة ” أنت ثور يا غريب ولست بشريًا مثلنا ”
من هنا تبلورت الشخصيّة “الإقصائية”:
هذه الشخصيّة الجدلية تجعلنا نطرح سؤالنا التالي:
ألم يمارس غريب عليها ذات الأسلوب الإقصائي؟ ألم يُعاملها بنفس الطريقة التي عامله بها أهل قريته؟ ألم يمارس غريب التنمّر على الدجاجة؟ ماذا تعكس هذه المفارقة التي نراها في سلوك “غريب” ؟
نعم، مارس غريب التنمّر والإقصاء على الدجاجة، رغم أنه كان ضحيةً لهما في طفولته من قِبَل أهل القرية. تعامل معها بازدراء، عندما جاءت تطرق بابه كبقية النساء:
“لم أفتح لها لاعتقادي الجازم – وقتئذ- أن الثور لا يجوز له أن ينكح دجاجة، فالدجاجة لها ديكٌ ينكحها، بينما أنا – كثورٍ افتراضًا- فلا أضاجع إلا نساء قريتنا!”
هذا يعكس فكرة “الضحية التي تصبح جلادًا”، حيث تحوّل غريب، الذي عانى من الإقصاء، إلى شخص يقصي الآخر الأضعف. -و الأمر ذاته ينطبق على ” الدجاجة” التي سعت للانتقام منه – ربما أراد الكاتب من خلال هذا أن يُظهر كيف يعيد المجتمع إنتاج العنف، وكيف أن الظلم عندما لا يُعالَج يتحوّل إلى سلسلة لا تنتهي من القهر والانتقام.(و عندما تصبح الضحيّة جلادًا، فهي تنفث عن نفسها صفة المظلوميّة.. )
💥 الدجاجة: “الدجاجة” ودورها الرمزي
تتخذ الدجاجة بعدًا رمزيًا مهمًا في الرواية، فهي تمثل صورة مصغرة عن غريب نفسه. كلاهما كائن ضعيف يعيش تحت تهديد الإقصاء،
لكنها هي الوحيدة التي عرفت اللعبة و أتقنتها، يقولون عنها دجاجة، و يصفونها بـ ” المعتوهة”
“دجاجة قريتنا فتاة متخلفة عقليًا، أو هكذا كنا نظن كلنا..هذه الدجاجة كانت طليقة تفعل ما تشاء، فهي الفتاة الوحيدة في قريتنا التي يحق لها أن تدخل كل البيوت؛ تأكل وتشرب وتنام، وتعبث أيضًا ولا رقيب أو حسيب لها؛”
و السؤال الآن ، هل كانت الدجاجة ضحيّة فعلًا أم أنها كانت واعية لما يجري؟ هل تصنّعت الجنون لتفعل ما تريد دون رقيبٍ أو حسيب، و- هذا ما لم تستطع نساء القرية فعله علنًا مثلها- و بالتالي كانت محرّك الأحداث ؟
تساؤلاتٍ تفتح بابًا للتأمل في دجاجة كحالة معقدة، ويثير تساؤلات حول الوعي بالذات والقدرة على التمرد في سياق اجتماعي يفرض قيودًا. من الممكن النظر إلى شخصية “دجاجة” على أنها ليست ضحية بالمعنى التقليدي، بل قد تكون شخصية واعية بأفعالها، لكن بطريقة قد تكون غير تقليدية أو حتى غامضة.
*الدجاجة كضحية:
الجنون كوسيلة للهروب: في الواقع، قد تكون الدجاجة تَصَنَّعت الجنون كوسيلة للهروب من الرقابة الاجتماعية أو للحصول على حرية كانت تفتقر إليها نساء القرية. هذا الهروب ليس من الجنون بقدر ما هو هروب من القيود المفروضة عليها كأنثى في مجتمع ضيق الأفق.
*الدجاجة كواعية لما تريد: حين تتملكها الرغبة تدقّ باب ” غريب” و حين تُقابل بالرفض، فهي تعي تلك النظرة الدونية التي يقابلها بها ” غريب” -و المعتوه ليس لديه هذا الوعي- . فهي أيضًا لديها استحقاق عالي لنفسها
“فنساء القرية لسن بأفضل منها أو أكثر جمالًا أو أنوثة، هكذا فكرت واقتنعت ونفذت”
لذلك تلجأ للانتقام منه بإبلاغ أهل القرية عنه
*الدجاجة كمحرّك للأحداث: خصوصًا إنها هي من سلّطت أنظار أهل القرية على ما يفعله ” غريب” عندما وشت به انتقامًا منها لامتهانه أنوثتها و رفضته مجامعتها كباقي نساء القريّة. فتقدّمها رجال القرية في محاولتهم الأولى لقتل ” غريب” قد ساهمت في تحريك عجلة الأحداث و الانتقال بها إلى منعطفٍ جديد، و بالتالي انتقال زماني و مكاني .
عندما أراد تبرير فعله, يقول:
“بصقت في وجهي وزادت أن هذه المرة رمتني بنظرةٍ نارية، ارتجف لها قلبي…
لكنها لاحقًا..
“كفت الدجاجة عن طرق بابي، وكفت أيضًا عن البصق في وجهي،”
نعم كفّت عن ذلك لأنها كانت تُعدّ لمحرقتك، و لكن هذه المرّة بعد أن تصل إلى مبتغاها، يقول:
“لكن الدجاجة كان لها خطةً أخرى، إذ ارتأت أن تتذوق الثور – الذي هو أنا – قبل ذبحه،”
في حين أن أهل القرية كانوا يُعدون لمحرقتيكما معًا…
” اتفقوا دونها على التخلص منها أيضًا، إذ هي من وجهة نظرهم لا تقل ضررًا عن ذلك الغريب السعيد الذي أتى لينتقم منهم، كما أنها – في نظرهم – متخلفة عقليًا قد تجهر في أي لحظة بفعلتهم.”
و لكن …
لماذا الموت حرقًا؟ و لماذا كانت الدجاجة من ضمن عملية التطهير؟
-إحراق الدجاجة: الطقس التطهيري والعنف الرمزي
قرار أهل القرية بإحراق الدجاجة مع غريب يحمل دلالات رمزية عميقة، إذ يمكن تأويله كنوع من “التطهير” الجمعي الذي تمارسه الجماعة تجاه العناصر غير المرغوب فيها. هنا، يعكس الحرق نزعة المجتمع إلى تصفية كل ما هو خارج عن نمطه السائد.
فعند تحليل مشهد إحراق الدجاجة ، نرى أن الرواية تتّخذ بعدًا أنثروبولوجيًا، إذ يمكن تأويله ضمن إطار فكرة “كبش الفداء” التي تحدث عنها الفيلسوف الفرنسي رينيه جيرار، حيث تقوم المجتمعات بإسقاط مخاوفها وصراعاتها على ضحية محددة، ثم التضحية بها لتأكيد وحدتها، و هذا يعود بنا إلى بدايات الرواية و الحديث عن ” القوطية، والبراهمة، والعويسة ”
💥دور الأب والأم في حياة غريب وتأثيرهما عليه
في رواية “الموت مرتان”، يظهر تأثير الأب والأم في حياة غريب بشكلٍ عميق ومعقد. فقد شكّلا، بطريقة غير مباشرة، الأسس الأولى لشخصيته، فكانا نقطة انطلاقه نحو هويته المتأرجحة بين الانتماء والتغريب. هذه الشخصية “غريب”، التي نشأت في ظروف قاسية مع والدين لم يتحدثا عنه بطريقة تظهر الاهتمام الأبوي التقليدي، تعتبر حالة دراسية مثيرة لفهم العلاقة بين الفرد والمجتمع المحيط به.
الأب: صمت الاستعباد والتهميش: لم يكن الأب متحدثًا، بل كان دائمًا يستدعي ابنه ليخبره بشيء، لكنه لا يقول شيئًا.
“تعالى يا غريب، هناك أمرٌ سأخبرك به”؛ آتيه- كالعادة- ولا يقول لي شيئًا!”
يعكس هذا الصمت استسلام الأب للوضع الاجتماعي، وغياب القدوة الحقيقية لغريب. فالأب لم يورث له سوى مهنته، ولم يترك له أي هوية أو مكانة، بل حالة من الحيرة والضياع.
الأم: الحب الصامت والتضحية المنسية، فأمه هي الوحيدة التي اعترفت به كابن، لكنها ماتت ودفنها بنفسه دون أن يسأل عنها أحد.
“أمي كانت دائما تقول لكل من يسألها عني ومن لا يسألها عني ” هذا غريب..ابني الوحيد وقرة عيني”، وأبي بالطبع ليس كأمي، فهو لم يقل ذلك لأحد من رجال قريتنا.”
تمثل الأم الرابطة العاطفية الوحيدة التي كان يمكن أن تمنح غريب بعض الانتماء، و هذا ما كان يُراكم إحساسه بالقهر غير المعلن صراحةً أن لا أحد اهتم لموتها-خاصةً نساء القرية اللاتي كانت حجتهن في لقاءه هو الاطمئنان على أمه-:
“يدعين أنهن جئن للاطمئنان على أمي، ثم تخرس ألسنتهن تمامًا إلا عن موائهن وآهاتهن وأنّاتهن إلى أن ينتهين من حلب الثور،….. ويمضين في صمتٍ كصمت القبور، ويتركنني غارقًا في سؤالي السرمدي؛ ألم تفطن إحداهن ولو مرة لعدم وجود أمي؟..أم لا يعنيهن ذلك أصلًا”
لكن موته الأول جاء بعد موتها، مما يعكس فقدانه لآخر خيط يربطه بالحياة.
النهاية تطرح سؤالًا ملحًا لنا أكثر مما كان لغريب، لماذا تساءل غريب إن كان (ظالمًا أم مظلومًا؟)
تُظهر النهاية أن غريب لم يكن متأكدًا من موقعه الأخلاقي في العالم. هل كان مذنبًا لأنه استجاب لرغبات النساء؟ هل كان ضحية لأنه استُغل طوال حياته؟ هل كان مخطئًا لأنه رفض “الدجاجة”، مما أدى إلى موته الأول؟ هذا التساؤل يعكس فلسفة العبث واللايقين الأخلاقي، حيث لا يوجد حكم واضح، ويُترك الأمر للقارئ ليقرر مصيره.
إذًا هل كان “غريب” يخشى العقاب الإلهي؟
أعتقد أن الخوف الذي أبداه ” غريب” ليس من العقاب بحدّ ذاته، بقدر ما هو من عدم فهم موقعه الحقيقي. كان يسعى لفهم نفسه قبل أن يواجه المصير الأبدي. إنه يمثل الإنسان الذي عاش بلا هوية واضحة، وحين مات، لم يعرف حتى كيف يتم تصنيفه.
💥الزمان والمكان في القصة:
تدور القصة في قرية نائية على أطراف الصحراء، حيث تتجلى العزلة والقسوة الاجتماعية وسط بيئة ريفية مغلقة. يمتد الزمن عبر مراحل حياة البطل، بدءًا من طفولته حتى موته الأول ورحلته إلى المدينة، مما يخلق إحساسًا بزمن متكرر وعبثي، حيث يُعاد إنتاج الظلم والنفي في كل مرحلة.
💥اللغة والأسلوب:
اللغة قوية ومشحونة بالعاطفة، تمزج بين الوصف الحي والسرد الذاتي العميق. الأسلوب يعتمد على الجمل الطويلة التي تعكس تدفق الوعي، مع استخدام صور بلاغية مكثفة لتعميق المشاعر وإبراز مأساوية الشخصية. هناك تكرار مقصود لبعض العبارات، مما يعزز من إحساس العزلة والاغتراب. الحوار قليل لكنه ذو دلالة، حيث يعتمد الكاتب أكثر على توظيف السرد/الحوار الداخلي ليعزز البعد الفلسفي للقصة، مما يجعلها تتجاوز مجرد الحكاية إلى تأمل في العزلة والهوية والرفض الاجتماعي. و بالتعبير عن مشاعر الشخصية الرئيسية، يجعل القارئ مشاركًا في رحلته النفسية والوجودية.
تحياتي أ. Mohamed Elbanna/ محمد البنا