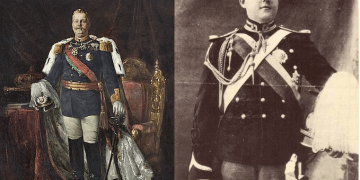فتحية دبش
الرواية القصيرة جدا وأسئلة الهوية
قراءة في رواية ( مخطوطة) الموت مرتان لمحمد البنا.
هل يمكن للنصوص الكبسولية طرح موضوعات متشعبة كالهوية والتمثلات والموت والحياة، خاصة وأن هوية الرواية القصيرة جدا بدورها مازالت تعاني من ارتباكات التجنيس واشتراطاته؟
يحدد الناقد العراقي حميد الحريزي حجم الرواية القصيرة جدا بعدد يناهز الخمسة آلاف كلمة. وهو ما التزم به البنا في روايته الموت مرتان، التي تقع في أكثر من أربعة آلاف كلمة. وتبدو مسألة الحجم مسألة مفصلية في الرواية القصيرة جدا كما هو الحال في كل النصوص الكبسولية على مختلف أنواعها وأجناسها، لكنه لا يكفي لتجنيس النصوص روايات قصيرة جدا.
وإذا كان البنا قد حاول الالتزام بشرط الحجم فإنه سعى في ذات الوقت إلى الالتزام بتقديم بشخصية محورية واحدة هي شخصية غريب التي لا تكتفي بالبطولة بل تضطلع أيضا بمهمة السرد. والشخصية الرئيسية الواحدة ملمح رئيسي من ملامح الرواية القصيرة جدا التي لا تتسع لأكثر من الشخصية المحورية والشخصيات المساعدة والمعرقلة التي يرى النقاد أنها لا تقل عن الأربعة ولا تزيد عن الضعف سواء كانت ذواتا مفردة أو جامعة.
وزع البنا شخصيات روايته على مقاس أدوارها مضيفا دور القارئ الذي يخاطبه البطل السارد مخاطبة الند مرة وهو يسرد الأحداث، ومرة وهو يطالبه بإصدار حكم وبتخيّر مكان ما من الحكاية. فالقارئ شخصية من شخصيات الرواية، وفعلها هو فعل القراءة وإصدار الحكم. فكانت على خلاف الشخصيات الأخرى دون ملامح واضحة ملتزمة في ذلك بما تقتضيه الرواية القصيرة جدا التي تستعيض بالتلميح دون التصريح وتقتصر في تقديم الشخصيات على الوظائف وتبعاتها بدلا من الأوصاف والنعوت إلا في حالات كانت هذه الأوصاف والنعوت مفاتيح قراءة كما هو الحال في تقديم شخصية غريب حتى وإن كان البنا قد أطنب في الوصف أحيانا و كرره دون حاجة لذلك.
أما التفضئة فقد سعت الرواية إلى تقديم فضاءيها الزماني والمكاني بما هي فضاءات معرقلة لشخصية غريب. فضاءات تعيده دائما إلى غربته، فلا هو من أهل المكان ليتبوأ مكانة مرموقة بين أهله ولا هو من أصحاب الزمان. ففي الفضاءين هو الشخصية المهمشة التي لا تستمد وجودها إلا من خلال الوظيفة التي أسندها إليه الرجال نهارا والنساء ليلا. فالجسد بكل غرابته يشكل في الرواية نقطة نفور وانجذاب في ذات الوقت وحمولة ثقافية شديدة التعقيد والقسوة.
من هنا تستمد حكاية غريب وأحداثها أهميتها في الرواية. فتطرح أسئلة متشعبة حول الهوية والموت وعلاقة كل منهما بالآخر، من خلال سؤال الأنساق الثقافية وفاعليتها في تحديد الأنا والآخر، وتبعات ذلك على تقدير الحياة والموت. تقول الرواية أن الموت حدث مرتان. مرة أولى لحظة اقتحم رجال القرية غرفة غريب ولكنه لم يكن فيها نهائيا حيث فر غريب من موته ومن بطش أهل القرية ومن نفسه أيضا عندما صنع لنفسه هوية أخرى في مكان آخر. ومرة ثانية عندما لم تسعفه الحيلة وقضى مع الدجاجة التي نالت أخيرا من جسده ما نالته نساء القرية على اختلافهن.
غير أن الميتة الحق، المضمرة، والتي هي لب الرواية القصيرة جدا فهي الميتة الكلية والنهائية والحقيقية لغريب. فهو ولد ميتا، عاش ومات ميتا دون هوية ولا وجود. لم يسعفه جسده الذي نالت منه النساء كما نال منه الرجال كل على طريقته ونال منه الليل والنهار في أن يكون له وجود وحياة. بل حتى عندما تغير المكان وانتحل هوية أخرى ظل جسده ومدى حاجة الآخرين إلى خدماته هو ما يحدد هويته وكينونته. انتقل من مكان كان فيه يوزع جهوده مجانا أو مقابل لقمة إلى مكان صار فيه جسده وسيلته وآلته للكسب. حتى عندما اشترى ضيعة ومنزلا وصار لا يقل حضورا عن غيره بقي حبيس جسده وغرابته واغترابه. وهو الموت الحقيقي لأنه موت نفسي بالضرورة.
غريب هو رجل بلا زمن غير الزمن الذي عاش فيه ومات. هوية مبتورة مثله مثل الكثيرين الذين جاؤوا إلى العالم مهمشين وظلوا كذلك. فهو رجل يقدمه البنا ببنيته الشديدة ولونه الأسمر مع التصريح في النص بكونها سمرة تختلف عن اللون الافريقي ولست اجد مسوغا لهذا التفصيل طالما أن اللون هنا لا يقتصر على كونه جزءا من نوية بل يستمد أهميته من اقترانه بنسق ثقافي يسعى إلى ترسيخ صورة موهومة تقرن اللون بالبنية الجسدية والقدرة الجنسية وهي رؤية استعمارية لا ترى في أمثال غريب غريب سوى آلة وحيوانية يرفضها المجتمع جهرا ويقبل على استهلاكها سرا .
يحضر غريب في الرواية حضورا يغلب عليه الصمت في البداية قبل أن يمنحه صوتا لن يدوم طويلا. فالذين يشبهون غريب يعيشون مثله على هامش الآخرين حتى أنهم يتحولون إلى مجرد ظلال لا تحدد هويتهم ماهيتهم الحقيقية وإنما تحددها التمثلات والأنساق الثقافية التي بالضرورة تحدد مكانة الناس بألوانهم وأنسابهم. فكلما اقترب اللون من البياض كان بالضرورة بشرا وقد عبر عنه غريب نفسه وهو يحاول مشاركة القارئ طريقته في التمييز بين نساء الليالي المقمرة والليالي غير المقمرة. وكلما ابتعد اللون على البياض كان بالضرورة أقرب إلى الحيوان مختزلا في بنيته الجسدية وكان بلا صوت شأنه شأن غريب والدجاجة. فالشخصيتان غريب والدجاجة ومع أنهما يمثلان مواضيع إقصاء وتهميش حتى أنهما لا يحضران في الرواية إلا من خلال الجسد وماهيته الوظيفية فقد كانا على درجة من التضاد والتكامل في نفس الوقت. هذا اللعب بالصوت وعدمه وبالجسد الوظيفي هو الموت الثالث الذي تركه الكاتب مضمرا غير معلن.
ومن هنا يمكن التأكيد على أن هذه الكتابة على مستويين واحد ظاهر قريب وآخر مضمر بعيد هي واحدة من أهم ملامح الأدب الوجيز بصفة عامة. فما الحكاية إلا وسيلة لتعرية طرائق تفكير وصراعات هوياتية متوهمة لا تفتك بغريب وحده بل بالمجتمع في عمومه.
مع أن الرواية القصيرة جدا جسد ضيق إلا أنها تتسع لموضوعات شائكة ومتشعبة وقد نجح البنا في ذلك أيما نجاح وإن كان يمكنه أن يقدم رواية أشد تماسكا وتصالحا مع جنسها القصير جدا وذلك بالابتعاد عن التكرار والإطناب في وصف شخصية غريب بحيث كانت الأحداث كافية للتدليل على هويته وميتة واحدة كانت تكفي ليبلغ القارئ الميتة المضمرة وهي التي تقوم عليها الرواية القصيرة جدا.