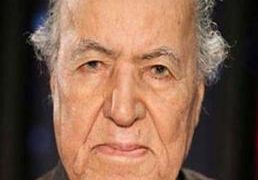إشراقات النار دراسة نقدية حديثة
متعددة الابعاد(فلسفية ونفسية وثقافية)
في قصيدة : من نصوص النار
الاستاذ علي لفته سعيد
بقلم : الدكتور عبدالكريم الحلو
( ١ ) القراءة الفلسفية :
تحليل فلسفي للحرائق الوجودية
في شعر الاستاذ علي لفته سعيد
====================
مقدمة:
* في عالم مشبع بالرماد، حيث اللغة تشتعل ولا تنطفئ، تأتي قصيدة “من نصوص النار” بوصفها صرخةً فلسفية من عمق الذات العراقية، والعربية عموماً، وهي تُخاطب وجودًا ممزقًا بين الذاكرة والحريق، بين الوعي المتألم ومرآة الوجود المحترق.
* في هذه القصيدة لا نتعامل مع النار كرمز للعقاب أو التطهير، بل ككائن ميتافيزيقي يتخلل تفاصيل الكينونة. إنها نار الوعي، نار الشك، ونار الأمل المكسور.
أولاً: النار كوجودٍ أنطولوجي:
————————
* ينطلق النص من استحضار النار لا بوصفها عنصرًا طبيعيًا بل كـ”احتراقات” ترافق الذات في رحلة الوجود:
“أعودُ حاملًا احتراقاتنا”
“أهشُّ بتأففٍ ما يُبعدُ النار عن الخطوات”
* النار هنا تشبه عند هيراقليطس النار الكونية التي يرى أنها الأصل الأولي لكل شيء. إنها تمثل التحول المستمر، صراع الأضداد، والجدلية الوجودية التي لا تتوقف. إنّ علي لفته سعيد يستدعي هذه الفلسفة دون أن يصرّح بها، بل يُلبسها قناعًا شعريًا.
* تمامًا كما قال الفيلسوف الألماني مارتن هايدغر: “النار تُنير الوجود كما تكشف الظلمة.” وهكذا، لا تكون النار في القصيدة مجرّد ألم، بل وسيلة لإدراك الذات والعالم عبر الألم.
ثانيًا:
تفكك الهوية والمرآة المفخخة بالرماد:
————————————
“لا أُغمضُ المرايا حتى لا تكون جثّةً برأسٍ يخرُجُ من قَحفَتِه الدّخان”
* المرآة لم تعد تعكس الجمال أو حتى الحقيقة، بل صارت تماثل الجثة… مرآة الذات حين تنظر إلى التاريخ، أو إلى “رأسٍ” يكاد ينفجر بالدخان. هذه الصورة توازي “لوحة السلفادور دالي” التي تستحضر الغرائبية والسريالية: التشوه، السيلان، الذوبان.
* دالي كان يرسم الزمن كمادة مائعة، وهنا يرسم سعيد الهوية كزمنٍ احترق، كمرآة تنبعث منها النار، لا الضوء.
ثالثًا: سؤال الإرث وعبء الأجداد:
—————————-١١-
“وما على أبي، أو جدّي الذي لم أره
أعمامي الذين لم تلدهم جدّتي…”
* الشاعر هنا لا يتعامل مع الإرث على أنه نعمة، بل كحملٍ عبثي. إنّه تفكيك حاد لفكرة الجذور، كما فعل ألبير كامو في روايته “الغريب”، حين واجه البطل العالم بصمت وجودي هائل، لأنه لا يرى جدوى من الميراث الرمزي أو الأخلاقي.
* كل هذه الصور تتكامل مع الشعور باللاجدوى، بما يذكّرنا بفكرة “العبث” عند سارتر، و”ثقل الوجود” عند كونديرا، خصوصًا في قوله:
“لا شيء لي فيها
الناقةُ هربت…”
* حتى الرموز الدينية الكبرى – الناقة، الكبش، الغيمة – تتحول إلى “لا شيء”، رموز مهجورة، وتصبح المجازات علامات على الانهيار لا النهوض.
رابعًا: المرأة هي النار والسلام معًا:
——————————
“لكنّكِ أنتِ وحدَك
كلّما أشعلت النار
قلت: هل من مزيد؟”
* الأنثى هنا ليست معادلًا رومانسيًا، بل جزء من لعبة النار، منغرسة فيها، ومتورطة بها، تمامًا كما في شعر “سيلفيا بلاث” حين تكتب في قصيدتها “Lady Lazarus”:
“Out of the ash
I rise with my red hair
And I eat men like air”
* المرأة التي تنبعث من الرماد، وتُغذّي النار، تصبح هنا، عند علي لفته سعيد، مفجّرة للرمز وللتأمل الوجودي. فهي الوقود والسلام، الحرب والماء.
خامسًا:
الختام بوصفه انفجارًا فلسفيًا
في وجه الطمأنينة الزائفة:
——————————-
“وأجّجي ما تشائين من الحروب
لأرتوي من عطش الحرمان”
* إنها مفارقة وجودية عميقة: يريد الحرب ليرتوي! يريد النار ليهدأ! هنا يبلغ النص ذروته في تمثيل قلب الفلسفة الحديثة التي تؤمن بأن الإنسان كائن يسعى للمعنى وسط العبث، ويبحث عن السلام في قلب النار.
=====================
( ٢ ) القراءة النفسية :
بين الرماد والروح : قراءة نفسية
في قصيدة “من نصوص النار”
للشاعر علي لفته سعيد
————————-
‘
* حين نقرأ “من نصوص النار”، فإننا لا ندخل عالمًا لغويًا وحسب، بل نقتحم جحيمًا داخليًا، تتقاطع فيه الذكرى مع المأساة، والحنين مع القلق، وتتمظهر فيه الذات ككائن مأزوم يحترق من الداخل ولا يجد منفذًا للانطفاء.
* هذه القصيدة تُشكّل مسرحًا داخليًا لنفس تنوء بثقل التاريخ، وسؤال الوجود، ومأساة الوراثة، وقلق الهوية. سنقف عند أبرز المحاور النفسية.
أولًا:
الذات المنقسمة – الذات المراقِبة
———————————–
“أجلس وحيدًا
أحسب ما لي وما عليّ
وما على أبي، أو جدّي الذي لم أره”
* في هذه المقاطع يظهر انقسام النفس بين المتكلم وذاته، في ما يُعرف في التحليل النفسي بـ “الوعي المراقب” الذي يقيم محاكمة داخلية لما جرى ويجري، ويمتد نحو الآخرين (الأب، الجد، العم…).
* تكرار الضمائر والمساءلة الذاتية علامة على حوار داخلي بين الأنا Ego والأنا الأعلى Superego، حيث تحاول الذات أن تزن ميزانها الأخلاقي، بين ما حملته وما ورثته، وما فُرض عليها.
ثانيًا:
القلق الوجودي – النار كمُكافئ نفسي
———————————–
“أعودُ حاملًا احتراقاتنا
أهشُّ بتأففٍ ما يُبعدُ النار عن الخطوات”
* هنا نجد نموذجًا لما يُعرف بـ “القلق الوجودي”، الذي يُعرّفه “بول تيليش” و”كيركغارد” بأنه شعور اللاجدوى في عالم متصدع.
* النار، رمز الألم الوجودي، تلاحق الذات في كل خطوة، ويقابلها “تأفف” داخلي يعكس فعل المقاومة الخائف. إنها النار النفسية التي لا يمكن إخمادها، لأنها ليست من العالم الخارجي، بل من طبقات اللاوعي المكبوتة.
ثالثًا:
جدلية الهوية والوراثة النفسية
—————————
“وما على أبي، أو جدّي…
أعمامي الذين لم تلدهم جدّتي
أخوالي الذينَ ملأوا جوفهم بالخمور
ثم تيمَّموا للصلاة بعد احتراق الجهات”
* تستبطن القصيدة ما يُعرف بـ “اللاوعي الجمعي” كما يصوّره “كارل يونغ”، حيث لا ينفصل الإنسان عن ذاكرة سلالته، وعن تراث الأجداد، وإن لم يرهم.
* هذه الوراثة ليست وراثة دم فحسب، بل وراثة عُقد، وهزائم، وطقوس، تشكّل في لاوعي الشاعر شعورًا بالذنب الموروث، وارتباكًا في الهوية، بين انحدار الأصول ونفاق السلوك الديني والاجتماعي.
رابعًا:
عقدة القربان – وصدمة الطفولة
————————————
“الكبشُ الذي لم يُنحر
كان فديةً لم تُطفئ النار المشتعلة في الأركان”
* هنا يستحضر الشاعر رمزًا من الطفولة الجمعية، يرتبط بقصة إسماعيل – الكبش – التضحية. لكن الفدية لم تتحقق. هنا يتكشّف عمق الصدمة الطفولية في نفس الشاعر، حيث الشعور بالخيانة من منظومات الوعد، والمقدّس، والإلهي.
* هذه السطور قد تعبّر عن صراع داخلي بين الحماية الأبوية المنتظرة (الفدية) وبين غيابها الفعلي (النار المشتعلة). وهذا ما يُنتج قلقًا دائمًا من “العقاب الإلهي” غير المبرر.
خامسًا: صدمة الواقع – التهكم كآلية دفاع
————————————–
“الغزوات التي لم تعبرْ فيها سفينةٌ
أَخذَت الريح أشرعتها”
“الغيمة التي لم تمطر على أرضي
كان ريعُها لهارون ونسائه”
* هنا يستخدم الشاعر التهكم والسخرية السوداء كآلية دفاعية نفسية Defense Mechanism، تحلّ محل الألم الصريح. إنه أسلوب يوازي ما وصفه فرويد بـ “النكتة كمنفذ للقلق”.
* يتحوّل التهكم من السرد إلى شكوى لاشعورية: التاريخ خدعة، الآلهة تواطأت، المطر خذل الأرض، السفن لم تصل، والغنائم ذهبت للحريم.
سادسًا:
المرأة – النار – الحنين – الرغبة المكبوتة
———————————–
“لكنكِ أنتِ وحدَك
كلما أشعلتِ النار قلتِ: هل من مزيد؟
لا تكوني بردًا، بل كوني سلامًا”
* الأنثى هنا تمثّل، نفسيًا، كائن الرغبة الكبرى. لكنها ليست محبوبة مثالية، بل محرضة، مشتعلة، مقلقة. إنها موضوع التوتر بين الإشباع والمنع، بين العطش والارتواء، بين الحب والموت.
* بهذا، تمثل المرأة هنا “الهو” (Id) الذي يحرك رغبات الذات، ويستدعي نارًا توازي نار الداخل.
* بلغة لاكان: الأنثى ليست موضوع الحب فحسب، بل هي مرآة الانقسام في الذات، ومركز اللذة/الألم.
ء=========================
( ٣ ) القراءة الثقافية :
من نار الحروف إلى جذوة الفكر
دراسة ثقافية في “من نصوص النار”
شعر الدكتور علي لفته سعيد
* تتموضع هذه القصيدة داخل طبقات متشابكة من المرجعيات الثقافية، والأسطورية، والدينية، والتاريخية، لتكوّن ما يشبه نصًا مفتوحًا يشتبك مع خطاب السلطة والتاريخ والمقدّس، ويعيد تفكيكها عبر تمثيلات شعرية عالية.
* القصيدة تُجسّد الوعي الثقافي المضاد، وترفض أن تكون مرآة للتاريخ الرسمي، بل هي في جوهرها حركة شعرية مقاومة ضد التمركز الرمزي للسلطة، سواء أكانت دينية، سياسية، أو معرفية.
أولاً: النار كرمز ثقافي/سياسي :
————————–
“أعودُ حاملًا احتراقاتنا
أهشُّ بتأففٍ ما يُبعدُ النار عن الخطوات”
* النار هنا تتجاوز بعدها الطبيعي، لتغدو رمزًا للهوية الثقافية الجريحة، هي ليست مجرّد أداة احتراق، بل علامة على صراع مستمر بين الذات والهويات القامعة.
* يشبه ذلك ما أشار إليه “ميشيل فوكو” حين ربط بين الجسد والنار في فضاء السلطة والمعاقبة. فالنار هنا عقوبة غير مرئية تمارسها الثقافة السائدة على وعي الفرد.
ثانيًا: تفكيك الخطاب الديني والتراثي :
———————————
“الناقةُ هربت
بعد أن جلست لتحدِّد اتّجاه الصلاة”
“الكبشُ الذي لم يُنحر
كان فديةً لم تُطفئ النار المشتعلة في الأركان”
“الغزوات التي لم تعبرْ فيها سفينةٌ
يحلم فيها أجدادي بغنائمَ تتلوّى بين صدور النساء الأندلسيّات”
* في هذه المقاطع، يقوم الشاعر بعملية تفكيك شُجاعة للرموز الدينية والثقافية التي تشكل جزءًا من السردية الإسلامية والعربية التقليدية.
* في منظور النقد الثقافي، يُعدّ هذا “تفكيكًا للتابو”، حيث يتهكّم الشاعر من رموز الفدية، الغنيمة، الغزوة، الهروب المقدّس، الناقة الموجّهة للقبلة… إنها كلها رموز تمّت أدلجتها في التراث الجمعي لتبرير السلطة والتفاوت الاجتماعي.
* يشبه هذا التمرد ما فعله “صلاح عبد الصبور” في مسرحيته “مأساة الحلاج”، أو ما مارسه “أدونيس” في دواوينه ضد التصحّر الديني.
ثالثًا:
الذكورة المهيمنة
والنقد الجندري الضمني
————————-
“الغزوات … يحلم فيها أجدادي بغنائمَ تتلوّى بين صدور النساء الأندلسيّات”
* هذه الصورة الصادمة، تفضح العنف الرمزي للجنس الذكوري التاريخي، الذي طالما اختزل النساء في “غنائم”، وجعل من الجسد الأنثوي مساحة للهيمنة والانتصار، لا الحب والإنسانية.
* القصيدة تُعيد إدانة هذا السلوك، وتُظهره بصورته الكاريكاتورية، الساخرة، الفاقدة لأي قيمة أخلاقية.
* هذا قريب من خطاب “سيمون دي بوفوار” في كتابها “الجنس الآخر” حيث وصفت كيف تختزل الثقافة الذكورية المرأة إلى “آخر” للاستغلال، لا شريك.
رابعًا: نقد السردية التاريخية الرسمية
———————————
“الغيمة التي لم تمطر على أرضي
كان ريعُها لهارون ونسائه”
* الشاعر هنا يشتبك مع التاريخ بوصفه منتجًا سلطويًا انتقائيًا، ويستحضر شخصيات “هارون الرشيد” بوصفها رموزًا لبذخ بلا عدالة، وغنائم بلا مساواة.
* إنها محاولة لفضح كيف تُنتج الثقافة السائدة أبطالها، وتُعلي من رموزها، فيما تُهمّش “الأرض الجافة”، و”الشعوب المقهورة”.
* يشبه هذا صوت “إدوارد سعيد” حين تحدّث عن الاستشراق بوصفه بناءً تخييليًا للشرق، لا واقعًا.
خامسًا : المرأة- النار- الحرمان
—————————–
“لكنكِ أنتِ وحدَك
كلّما أشعلت النار قلتِ: هل من مزيد؟
لا تكوني بردًا، بل كوني سلامًا”
* في نهاية النص، تتحوّل المرأة إلى رمز ثقافي مزدوج: هي النار (الرغبة/العذاب)، وهي الأمل (السلام).
* لكنها أيضًا، في تصور الشاعر، جزء من اشتعال الذات الثقافية، هي ليست مستكينة، بل فاعلة، طاغية، ومربكة.
* هذا التصوّر مختلف عن التمثيل التقليدي للمرأة في الثقافة الذكورية كشخص “تابع – هامشي”،
* إنها هنا مركز توتّر وهُوية واحتراق.
===================
تقييم نقدي شامل لقصيدة “
من نصوص النار”
أولًا:
من حيث المحتوى والرؤية
النص يتميّز بجرأة فكرية واضحة، حيث لا يتورع الشاعر عن اقتحام المناطق الحسّاسة من الوعي الجمعي، بدءًا من الرمز الديني، مرورًا بالتاريخ السياسي، ووصولًا إلى صورة المرأة. إنها قصيدة تُقارب مفاهيم التمرد، الخيبة، الحريق الداخلي، ومأزق الانتماء في عالم مأزوم.
• عمق الفكرة وجرأة الطرح.
• الغنى الثقافي والتاريخي للنص.
• توظيف سردي مكثّف للرموز التاريخية والدينية يعكس وعيًا معرفيًا.
* قصيدة “من نصوص النار” هي نصٌ ينتمي إلى الوعي الثقافي المتمرّد، يشتبك مع رموز السلطة والتاريخ والمقدّس، ويفضح السرديات التي قامت عليها شرعية الظلم والتمييز والتهميش.
*
* وهي بهذا تندرج في ما يُعرف بـ “شعر ما بعد الكولونيالية”، الذي لا يثق بالتاريخ، ولا يقبل بالمرجعيات الموروثة، بل يعيد مساءلتها شعريًا.
* نصٌ ضد المركز، ضد الخنوع، ضد المقدّس المُسيّس… لهذا فهو شعر ثقافي بامتياز، يعيد بناء الهوية من ركامها المتفحّم.
ثانيًا: من حيث اللغة والصياغة
اللغة هنا ناضجة، قوية، مشبعة بالأسى دون أن تقع في فخّ الرثاء. هناك اقتصاد لغوي جميل، وعناية واضحة في بناء الجملة، مع صور مبتكرة، خاصة في السطر:
“لا أُغمضُ المرايا حتى لا تكون جثّةً برأسٍ يخرُجُ من قَحفَتِه الدّخان”
الصورة هنا سريالية، دالية بامتياز، تشبه لوحات الرسام “سلفادور دالي” الذي استحضره الشاعر بوعيٍ بصري واضح.
ثالثًا: من حيث البناء الفني
• بنية القصيدة تقوم على السرد المتوالي لا التقطيع الموسيقي، وهذا مناسب لطبيعة الموضوع الذي يحتمل التنفّس الطويل أكثر من الومضة.
• التحول الدرامي من الخطاب الجماعي إلى الخطاب العاطفي في النهاية (المرأة/النار) كان انتقالًا ناعمًا يُظهر براعة في التوازن بين العام والخاص.
رابعًا: من حيث الأثر والتأثير
• النص يُحفّز القارئ على التفكير، وليس فقط على التذوّق الجمالي. وهذه من علامات الأدب الحديث العميق.
• يوقظ الأسئلة الكبرى عن الماضي والحاضر والموروثات المهيمنة.
* قصيدة “من نصوص النار” عملٌ شعري ثقافي من الطراز العالي، يُعبّر عن شاعر يحمل وعيًا معرفيًا وتاريخيًا، ويُمارس الشعر بوصفه موقفًا من العالم لا زخرفةً لغوية. هي قصيدة لا تُقرأ، بل تُواجه.
* قصيدة “من نصوص النار” هي منظومة سيميائية تحترق بالرموز، وتنتج دلالات لانهائية من النار، المرأة، المرآة، التاريخ، والدين. كل سطر فيها يشتغل كعلامة تقاطع، وكل رمز يتكثف ويتكرر ويتحول.
* هذه القصيدة لا تكتفي بإعادة إنتاج الرموز، بل تفككها، وتعيد بناؤها، وتجعل من القارئ مشاركًا في توليد المعنى.
* إنها قصيدة تكتب العالم من رماده، وتفتح للقراءة النقدية أبوابًا لا تحترق.
========================
تقييم الشاعر :
الاستاذ علي لفته سعيد
1. الرؤية الفكرية والثقافية:
* الشاعر علي لفته سعيد يمتلك رؤية فكرية متجددة وثاقبة، تعكس قدرة كبيرة على التواصل مع التراث الثقافي والديني والإنساني بشكل معمق. يظهر ذلك في النصوص التي يكتبها، حيث يتناول مواضيع الوجود، والحرية، والتمرد، والجروح التاريخية بطريقة فلسفية تتجاوز التقليدية. يتعامل مع التاريخ والرمزية بشكل لا يعتمد على الإعادة والتكرار بل يسعى لتجديد الرؤية والتفسير، وهذا يظهر في تصاويره السريالية مثل إشارته إلى “سلفادور دالي” في النصوص.
2. المهارة الفنية والإبداع اللغوي:
* الشاعر يعكس إبداعًا لغويًا لافتًا، ففي قصيدته “من نصوص النار”، نجد أنه قادر على استخدام اللغة بشكل غنائي وفلسفي في ذات الوقت. اختياره للكلمات دقيق ومؤثر، والتراكيب اللغوية غير مكررة أو مبتذلة.
* أحد أبرز مظاهر التميز اللغوي هو استخدامه لـ التصاوير الشعرية المبتكرة، التي تدمج بين السريالية والرمزية، وهذا يجعل من قصائده أكثر استثنائية.
مثلًا، في السطر الذي يقول فيه:
“لا أُغمضُ المرايا حتى لا تكون جثّةً برأسٍ يخرُجُ من قَحفَتِه الدّخان”
نلاحظ كيف يتم تداخل الصور المتناقضة والمتجانسة لتعطي إحساسًا بالضياع والقلق الوجودي، وهنا يكمن إبداع الشاعر في خلق هذا التوتر البصري والفكري.
3. التوظيف الثقافي والفلسفي:
* يتميز الشاعر بقدرته على التوظيف الثقافي، حيث يستخدم رموزًا تاريخية ودينية بطريقة تعكس إحساسه العميق بالتاريخ وبالواقع المعاش. هذه الرموز لا تقتصر على الأطر الضيقة، بل تُوظَّف لتوسيع أفق التأمل لدى القارئ.
* القصيدة تعكس التأمل في الماضي والحاجة إلى التصالح مع الجروح والتاريخ الذي لا يزال يؤثر في الواقع المعاش. فالعلاقة بين الماضي والحاضر دائمًا في حالة تفاعل وصراع في قصائد الدكتور علي لفته سعيد.
4. الأصالة والتجديد:
* الشاعر يحمل أصالة في تجربته الأدبية، لكنه في الوقت ذاته يسعى إلى التجديد على مستوى الموضوعات والأشكال. نصوصه تتعامل مع قضايا معاصرة لكن بعيون أوسع وأعمق، مما يضيف لها طابعًا فريدًا. علاوة على ذلك، هناك تجديد في أسلوب الكتابة نفسه، حيث يمتزج الشجن والمرارة بالحكمة والواقعية.
5. تأثير الشاعر في القارئ:
* الشاعر علي لفته سعيد ليس مجرد مُعبّر عن المشاعر والأفكار، بل هو أيضًا محفّز للقارئ على التفكير والتمعن في قضايا الحياة الكبرى. النصوص تثير الحيرة والدهشة وتدفع القارئ لاستكشاف معاني جديدة في نفسه وفي مجتمعه.
* الشاعر علي لفته سعيد هو شاعر يمتلك إبداعًا لغويًا وفكريًا عميقًا، يعكس موهبة استثنائية في دمج الرمزية والسريالية مع الوعي الثقافي. قصائده ليست مجرد كلمات شعرية، بل هي تأملات فلسفية ذات طابع خاص، مما يجعله واحدًا من أبرز الأصوات الشعرية في الساحة الأدبية.
الدكتور عبدالكريم الحلو
==========================
القصيدة:
من نصوص النار
في كلّ يومٍ
أعودُ حاملًا احتراقاتنا
أهشُّ بتأففٍ ما يُبعدُ النار عن الخطوات
لا أُغمضُ المرايا حتى لا تكون جثّةً برأسٍ
يخرُجُ من قَحفَتِه الدّخان
مثل لوحة السَّلفادور دالي
أجلس وحيدًا
أحسب ما لي وما عليَّ
وما على أبي، أو جدّي الذي لم أره
أعمامي الذين لم تلدهم جدّتي
أخوالي الذينَ ملأوا جوفهم بالخمور
ثم تيمَّموا للصلاة بعد احتراق الجهات
لا شيء لي فيها
الناقةُ هربت
بعد أن جلست لتحدِّد اتّجاه الصلاة
الغربانُ مصيبتنا
حين سجّلت أول حالة قتل
باسمٍ مجهولٍ اسمه قابيل
الكبشُ الذي لم ينحر
كان فديةً لم تُطفئ النار المشتعلة في الأركان
الغزوات التي لم تعبرْ فيها سفينةٌ
أَخذَت الرّيح أشرعتها
يحلم فيها أجدادي بغنائمَ تتلوّى بين صدور النساء الأندلسيّات
الغيمة التي لم تمطر على أرضي
كان ريعُها لهارون ونسائه
آهٍ كم من نارٍ مؤَجَّجةٍ بين الكتب
لكنكِ أنتِ وحدَك
كلّما أشعلت النار
قلت: هل من مزيد؟
لا تكوني بردًا
بل كوني سلاما
وأجًجي ما تشائين من الحروب
لأرتوي من عطش الحرمان
الدكتور علي لفته سعيد