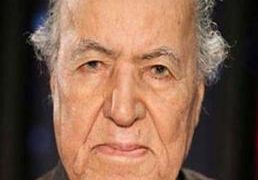أوّل قراءة نقدية تفاعلية لروايتي الجديدة “مددا… مدد..” للأستاذ القاصّ والنّاقد حسن السّالمي… شكرا لك من القلب أستاذ حسن ونالني من اهتمامك شرف أثيل..
تقنية تيّار الوعي. المفهوم والوظيفة والآثار
في رواية “مددًا… مدد…” للرّوائي مراد البجاوي
أ.حسن سالمي
تصدير: قال الجاحظ:”إنّ المعاني ملقاة على قوارع الطريق، وإنما يتميز النّاس بالألفاظ”.
تمهيد:
وأنا أتابع قراءة رواية “مدَدًا… مَدَدْ…” للكاتب المبدع مراد البجاوي كان سؤاًلا يكبر مع الوقت: هل أنا أمام رواية غارقة في تقليديّتها لم تتجاوز بعد شطآن البدايات؟ أم أنا أمام نصّ محلّق تجاوز مرحلة الحداثة، إلى ما بعدها؟ والحقّ إنّ هذا الارتباك الذي حصل معي يعود إلى المغامرة التي ذهب فيها الكاتب من حيث إنشائه عالما ارتكز على تقنيات ومبادئ جمعت بين القديم التّالد والطّريف المستحدث، وزجّ بهما معا في منطقة التباس واسعة، شوّشت على بعض المفاهيم والوظائف الفنيّة التي سادت واستقرّت في ذهن المتقبّل. من بينهم صاحب هذه السّطور. من ذلك اعتماده على تقنية تيّار الوعي على نحو مكثّف ورئيسيّ تجاوز السّبعين بالمائة من مساحة النّص، وصناعته لشخوص عديدة بنمط وحيد متشابه يغلب عليها الشبحيّة، فإذا هي بلا أسماء-غالبا-ولا أفعال ولا دم ولا أعصاب. كذا اعتماده على حوارات مقتضبة مجرّدة أغلب السّرد من الإشارات الركحيّة، معرضا عمّا يمكن أن تسهم به هذه الأخيرة من بثّ الحياة في شخوصه ومنحها الحرارة اللّازمة، فضلا عن جمود الحدث وتقّطعه وانفصام ارتباط بعضه ببعض وتباطؤ حركته أمام تيّار الوعي المتدفّق من الدّفّة إلى الدّفّة. فضلا عن لغة النّص التي جمعت في سمائها نبض الحرف العربي القديم بمنطوق عصرنا الرّاهن من حيث الجمال والتّركيب والتّماهي مع الشّعر في بعده السّاحر…
نحن إذن أمام هندسة سرديّة مربكة معقّدة، حفلت بها رواية “مَدَدًا… مَدَدْ…” لكاتبها مراد البجاوي. هذه الرّواية التي صنّعت مناخا مثاليّا جمع بين النّقيض والضّدّ، والقديم والجديد، خصوصا على المستويين الفنّي والتّقني. فكأنّ الكاتب يقول لمتلقيّه: إنّ لعبة السّرد تقوم على الوظيفة أوّلا وآخِرًا، دون اعتبار للقديم لمجرّد أنّه قديم، ودون اعتبار للحديث لمجرد أنّه حديث. الواقع المأزوم المتخلّف الذي يرزح تحت ثقل الاستبداد وخنق الحريّات وانسداد الآفاق له ما يناسبه من أدوات ومبادئ فنية. كذلك أحلام التّغيير والتّوق إلى بناء مستقبل مشرق لها ما يناسبها مما تقدّم ذكره. أمّا الجمع بينهما والخروج بهما إلى منطقة ثالثة لا إلى هذه ولا إلى تلك، فتلك لعبة السّارد المتمكّن الذي حذق عمله ورام التفرّد في عالم انفجرت فيه المواهب وأنبتت أرضه من صنوف السّرد وفنون القول ما لا يقع تحت حصر.
وقبل أن نفصّل فيما تقدّم ذكره ونربطه عمليّا بالرواية موضوع القراءة، ولكي لا يكون ذهن القارئ الكريم معلّقا في الهواء فإنّه من الضّرورة أن نذكّره بنبذة عن “مدَدًا… مَدَدْ…” كي يحسن مرافقتها ويشاركنا الحديث عنها. وله بعد ذلك أن يتّفق معنا أو يختلف فيما وصلنا إليه من نتائج.
“مددًا… مدد…” في سطور:
زيدان، هي الشخصيّة المحوريّة التي دار بها وحولها نسيج السّرد. يفرّ من عالمه البائس المظلم إلى الخلاء حيث لا يوجد أحد، يفرّ رغم اعتراض المعترضين، زوجته وابن عمّه وآخرون، قائلا في مرارة وفي لهجة صوفيّة رامزة»: دعوني أفنى لأحيا. دعوني أنأى بمصائبي عن عالمكم البائس.» وقبل ذلك كان يخاطب نفسه ويخاطب العالم من ورائها:» اجرِ يا زيدان. اجرِ ولا تلتفت إلى الوراء! إيّاك والتّردد! إيّاك! «
ترك الزوجة والولد وأعباء الحياة ومسؤوليته فيها إلى شِعْبٍ في الجبل بعيد لم تلوّثه أنفاس الخلائق… وما إن اختلي بنفسه حتّى تحوّل الكون من حوله إلى أرواح مبهمة غامضة تحدّثه ويحدّثها حديث العقلان، فتولد أسئلة حائرة ثقيلة في قوّة الجحيم. تؤرّقه وتزيده بؤسا على بؤسه، وتقرّبه من الخبل وفقدان العقل واختلاط الوهم بالحقيقة… وهكذا تتناهشه الأصوات من كل وحدب وصوب ولا يدري أتنبع من ذاته المريضة المتعبة؟ أم تنبع من إنسيّين ظن أنه فرّ منهم فرارا لا رجعة بعده؟ …
ذات حيرة في الدّجى السّاجي، وما أكثر أن عصفت به أخواتها، وجد نفسه محاصرا بالأضواء والسّلاح ليكون السّجن مصيره أغلب فصول الرواية. ومن الغريب المفارق أنّ ابن الدّم والرّحم ورفيق الطّفولة القديم، ابن الخالة هو الذي يلقي عليه القبض غير متردّد في إردائه قتيلا إن لم يستسلم. ومردّ ذلك إلى السّياسة وما جُبلت عليه من قذارة ولعنة في مجتمعاتنا العربيّة، تفرّق بين أبناء الوطن الواحد ولا تجمعهم، وتقطّع أرحامهم ولا تصلها. ويستبدّ من وصل منهم إلى السّلطة فيتحكّم في رقاب النّاس وبطونهم ويجعل من أبدانهم سلّما للعذاب وسوء المصير!
ومن فصل إلى فصل تولد شخوص فجأة وتذهب فجأة وتتداعى الذّكريات في مسار متقطّع مفصوم لتعالج قضايا اجتماعيّة وأغراض مختلفة لا يربط بينها رابط إلّا الخيبة والسّياسة وأزمتها الخانقة.
وما دامت رحى السّرد تدور فإنّ الوهم ظلّ مختلطا بالحقيقة عند زيدان، كذلك رؤاه وأحلامه وكوابيسه ظلّت متماهية مع الواقع الكالح الذي يعيشه ضمن سلسلة من السّخريات لاذعة المرارة. لعلّ أغربها على الإطلاق قذفه في السّجن، وتجرّعه العذاب، لأن الأحلام التي راودته في منامه لا تروق للسّلطان ويخشى أن تهدّد أمن دولته واستقرارها! …
مفهوم تيار الوعي ودوافعه في رواية “مددًا… مدد…”
وردت مقالة بعنوان روايات تيّار الوعي للأستاذ أحمد الشطري ما ملخّصه:
“يستخدم اتجاه تيار الوعي أسلوبا سرديا يعتمد على تصوير التدفق المستمر للأفكار والمشاعر والأحاسيس التي تمر بها الشخصية، ويهدف إلى التقاط الأعمال الداخليّة للعقل البشري، وتقديم صورة أولية غير مفلترة لوعي الشخصيّة، وقد تمنح هذه التقنية المتلقي رؤية معمقة لطبيعة التفاعلات النفسيّة للشخصيّة، مما يوفر تجربة قرائيَّة ثرية وحميمة.”
“وتتميز روايات تيار الوعي بافتقارها إلى البنية السرديّة التقليديّة وتركيزها على الأفكار والتجارب الداخلية للشخصية، فهي غالبًا ما تستخدم تقنيات مثل المونولوج الداخلي والخطاب الحر غير المباشر والسرد المجزأ لنقل تيار وعي الشخصية.”
“غالبًا ما يكون لسرديات تيار الوعي بنية مجزأة وترابطية، فبدلاً من إتباع تسلسل خطي وتسلسل زمني، يقفز السرد من فكرة إلى أخرى، مما يعكس الطبيعة غير الخطية لعمليات التفكير البشري كما يراه أصحاب هذا التيار، حيث يمكن للأفكار والذكريات أن تنشأ بشكل عفوي وبدون نظام واضح”.
وهنا يقع الحافر على الحافر كمل يقال. بتلك المفاهيم قامت لعبة السّرد في رواية “مددا… مدد…” للكاتب مراد البجاوي. وليس أدلّ على هذا من أنّها ابتدأت وانتهت –كذلك-بكلمة مفتاح جرت على لسان السّارد:» اجرِ يا زيدان. اجرِ ولا تلتفت إلى الوراء! إيّاك والتّردد! إيّاك! «
وبين هذين الحدين نشأت دائرة مغلقة تدفّق في داخلها سيل من الصّور والمشاهد والمشاعر والمواقف والمخاوف والأحلام والكوابيس شكّلت فيما بينها تيّارا شقيّا من الوعي، قلقًا إلى حدّ فقدان التّوازن والتباس الأمور على السّارد وقرّائه معا، فلا ندري معه أين الحقيقة وأين الخيال؟ وهل بينهما حدود وما هي؟
وللدّلالة على ذلك تأمّل أيّها القارئ الكريم المقتطفات التالية والتي تمّ انتخباها عشوائيا من متن الرواية وقد جرت كلّها على لسان السارد/ زيدان أو قل تدفّقت من وعيه الشقي الجارف:
“لقد حان وقت الانفصال، ولا رغبة لي في مزيد تحمّل عذابات الوجود. نعم! ويا ليتي أستبدل صحوة الجسد بعلاّته بنومة أخيرة. هكذا كنت أحدّث نفسي
وأستحثّ الخطى مسابقا الرّيح لاجتياز الرّبوة وإدراك الجبل. فهناك لن يقدر أحد على صدّي عماّ عزمت عليه. لن يمنعني مانع عن الاستباق إلى الخلاص النّهائيّ. وهناك أيضا سأهشّ على سطح الذّاكرة لأجتثّ منها ظلمات النّهار ودسائس اللّيل. هناك سأقبع على صخرة الصّمود معانقا أمل النّجاة من أوحال تعاقب الأيّام المربكة.”
“ها أنا أركض، أركض وأركض دون تعب ولا توقّف. إنّي أستعيد أحلام الطّفولة وذكريات الانفلات إلى الطبيعة الهادئة…” (ص23)
“ففي الظّنّ إدراك، وفي اليقن حيازة لمسعى، ولكنّ السّير على ناتئات المقصد مراودة بائسة لعقل بائس واختيار يائس. إذ كلّ المعارك سوّيت محارقها، إلاّ معركتي في الوقوف بن الشّكّ والحقيقة. شكّ قوّته في عناده، ويقين حقيقته في صدامه. كنت أظنّ أنّ البيّن بيّن وأنّ الظّاهر ظاهر تماما كما هو الباطل باطل والمخفيّ مخفيّ. لكنّ الخلاف الأهمّ هو الأقوى من شرعة التّمييز وقدرة الفصل. فإذا نشبت مخالبي في جوف سلطان الشّكّ، خاتلني الحقيقة وراودتني عن نفسي…”
“بتّ ليلتي أضاجع الأحلام وأستبدل قصصها إلى بطولات أزعم أنّي ذو قدرة خارقة على بناء تفاصيلها وإن كنت على غفوة نوم. فهي تارة مرعبة، مخيفة ومفزعة، وطورا تجبرني على التّأمّل أكثر…”
“لا يهّم إن كنت هائما في خيالات قد لا تتلاءم والوضع الّذي أنا فيه. ولا يزعجني إن سحبتني أسئلة البحث إلى ما لا يتطابق والحقيقة. فمشكلتي اليوم تتجاوز حدود العقل وأنا المستكين بقدرتي على تجاوز الورطة الجبانة مها تقسو التّفاصيل.”
“النّظام. النّظام. النّظام. كم مججت هذه العبارة! وعن أيّ نظام يتحدّثون؟ وما أقسى أن يحتكم الفوضويون إلى آلة النّظام؟ نظام استند إلى حكم الفرد في زمن الجماعات التّابعة. نظام ينتفي فيه الأصلح بالأصلح باسم القانون. نظام يستمدّ الوهم القائم عليه من سلطة الوهم الزّائفة. نظام لا يعترف بالفيزياء ولا الكيمياء ولا العلوم ولا الرّياضيات إلاّ في دفاتر مذكّرات أستاذ مجبر على التّنفيذ مقابل مكافأة رخيصة. نظام موغل في تأويل اللّغة وتطويعها بحسب المقاس مبنى ومعنى حتّى تنفذ إلى العقول فتفعل فعلها دون تفسير. هم ليسوا مستعدّين لتبرير ما يفعلون. هم جاهزون فقط للمقام الجاهز. ولا يهمّهم معطى أو قرينة لتسوية وضعية ما، بل كلّ ما يشفي غليلهم إدانة ينتشون بفضلها على آلام قهر الواقعين في المحظور.”
“سيّدي الرّئيس! في هذا الزّمن صار كلّ شيء ممكنا. وقد تتشابك أحلامنا بواقعنا المهمّش. وحينها تتلاطم المصالح العليا تلاطم أمواج بحر عاتية، فتضيع المصالح السّفلى وتنساق العامّة إلى ما وراء تيّار المكاسب اليسيرة الّتي تنتجها الفوضى. ولذلك، لا الأحلام ظلّت منذ الميلاد أحلاما، ولا الواقع متشبّث بحقيقته. فهل لكم أن تحاكموا شعبا كاملا بتهمة أنّ الأحلام تمسّ من الأمن العامّ؟ لا أظنّ سيّدي الرّئيس. لا أظنّ سيّدي الرّئيس! لا أظنّ! وبكلّ تأكيد!”
“وهذا هو المعنى الحقيقيّ لتنكيل الدّولة، حتّى لكأنّها تتحيّن الفرص للإطاحة بأهل الطّموح بألاعيب الحيلة، فتعدّ ما أنجز لها شَركا ذكيّا وتُصادر ممتلكاته باسم القانون، وهي في دفعه إلى الهلاك سابقة. هكذا هي بدم بارد تَعُدّ والشّقيّ يُحصي سنوات العمر بين القضبان متجرّعا مرارة الغبن والحرقة. هكذا هي الدّولة متربّصة بأهل المجازفة العمياء.”
“يا أهل بلدي! أعيدوني إلى رشدي، فأنتم العقلاء وأنا المجنون! والأهمّ من كلّ هذا أن تُعيدوني إلى بلدي، أعيدوني إلى بلدي! .”
إذن، فإنّ قارئ رواية «مددًا… مدد…” لن يجد شيئا مألوفا ولن يكون أمام شخصيّات تامّة التبلور. تهتمّ بالتفاصيل الصغيرة، وتحمل على كاهلها عدسة تصوير تستنسخ الواقع بجميع أبعاده وألوانه، قصد تسلية القارئ ومدّه بالمتعة. ربّما اعتبرت الرواية التي بين أيدينا هذا المنحى نوعا من التّخدير ومبعثا للأوهام التي لا تصنع وعيا في زمن المحنة والمأساة. فالواقع القاتم الكئيب الحافل بسحق الإنسان وقهره إلى ما لا نهاية، لا يحتاج إلى أسلوب عادي قد يصلح للرومانسيّة وأشباهها، قدر حاجته إلى أسلوب يخلخل الوعي ويصدمه ويدفعه دفعا لإثارة الأسئلة باستمرار، ويحمله على التأمّل والتّفكير واستخلاص أسباب الدّاء، والوقوف على الأعطاب الحقيقيّة للمجتمع. إنّ أسلوبًا كأسلوب «مددًا… مدد…” يحوّل وجهة القارئ من متقبّل سلبيّ ينظر إلى النّص من الخارج، إلى فاعل وشريك فيه عبر عمليّة تأويل مستمرّة.
بل إن هذا النمط من الكتابة يعيد إلى أذهاننا أسئلة قديمة تتعلّق بماهية الرّواية في حدّ ذاتها. ما علاقتها بالمتلقّي وما هي وظائفها؟ وكيف تتفاعل مع الواقع وتستعير منه قوانينه الظّاهرة والخفيّة وكيف تحوّلها إلى بنية النّص؟
من تلك الأسئلة التي دفعت إليها رواية «مددًا… مدد…” لماذا راهنت على تقنية تيار الوعي واعتمدته في أسلوبها وهي تعبّر عن واقع مأزوم؟ وما هي تداعيات ذلك على بقيّة عناصرها؟ وما هي مجالاتها وحدود تأثيرها؟
بعد الدّرس والتأمّل لاحظنا أن تقنية تيار الوعي كانت العصب الرئيس لتحريك جميع عناصر الرواية تقريبا، أو على الأقلّ أغلبها. كانت الرّوح المهيمنة على النّصّ من الغلاف إلى الغلاف. وامتدّت آثارها الواضحة على السّارد والشّخوص والحدث والزّمان والمكان والرّمز واللّغة…
وفيما يلي بعض التّفاصيل:
آثارها على السّارد:
ما إن يتقدّم القارئ في عالم رواية “مددًا… مدد…” حتّى يدرك أنّ ملامح شخصية زيدان وتفاصيل ملامحها الجسمانية قد ابتلعتها ومحتها ملامحه الباطنيّة والمعنويّة العميقة. أخرجته من صفة الشّخص الضيّقة إلى صفة السّارد الواسعة، وحوّلته إلى رمز وفكرة، إلى ذات منقسمة على نفسها ليولد من ضلعها ذوات أخرى عديدة تختزل شرائح النّاس بمختلف أزماتهم، وتلخّص علاقة بعضهم ببعض. حاكما ومحكوما وقاهرا ومقهورا وجلّادًا وضحيّة. بتعبير آخر، لقد حوّلت تقنية تيّار الوعي -المنبثقة من واقع الشخصيّة المأزوم- ذات السّارد الطبيعيّة إلى ذات معنوية تلعب دور المرآة التي يرى فيها وجهه ووجه العالم، فيخاطبهما معا خطابا واحدا متواشجا لا حدود فيه.
آثارها على الشّخوص:
قبل الحديث عن الآثار يحسن أن يتعرّف القارئ الكريم على الّشخوص الأخرى-خلاف زيدان-حتى تكتمل عنده الصّورة: الزوجة/ابن العمّ/صوت الباحث عن الكنز/ابن الخال (ضابط بوليس) / شركاء في الزنزانة/ محقق أمني/باحث البداية/رئيس المحكمة/ وكيل الجمهورية/ طبيب/ممرضة/ حارس/خنفساء الريح/ غيلان (الأخ التوأم) / شخصيات أخرى تستدعيها ذاكرة السّارد…
إذا كانت لشخصيّة السّارد/ زيدان ملامح باطنيّة عميقة واسما وبُعدا اجتماعيّا ولو غائما ومضبّبًا ويفتقر إلى الملامح الظّاهرة فإنّ الشّخوص التي وردت أعلاه افتقرت حتّى إلى هذه الصّفات المعنويّة مع غياب تامٍّ لملامحها الجسمانيّة وأبعادها النفسيّة والاجتماعيّة وما إلى ذلك. تظهر بلا مقدّمات وتختفي بلا تمهيد. منها من يندثر نهائيّا فلا نسمع له صوتا، ومنها من يعود للظهور في اقتضاب وسرعة ليضمحلّ تماما وليبقى صوت السارد هو الأعلى والمهيمن على الإطلاق. إنّها تظهر للقيام بوظيفة محدّدة تتمثّل في ترجيع الصّدى لذات السارد لا أكثر. تُختزل في أصوات مجرّدة من الفعل والحركة والعصب واللحم، لا تصنع الحدث ولا تدفعه للنّماء والتّطوّر كما هو مألوف. بل إنها تُجرّد حتّى من كونها شخصيّات مساعدة تستدعيها وظائف الإضاءة على الشخصيّة الرئيسية من الزّوايا المختلفة.
وعلى ذلك يمكن أن نضرب بعض الأمثلة التّالية من النّص:
– “أوّاه من خيبتك يا زيدان! ألم نتّفق على تقاسم المحنة؟
– من تكونين؟ وما حاجتك بي؟
– زوجتك يا زبدان. إيّاك والرّحيل عنّا!
– ما الّذي أتى بك ورائي يا نوّة؟ عودي إليهم، عودي!
– أبناؤك يا زيدان أمانة.
– لعلّ في هروبي رحمة. لم أعد قادرا على الصّمود أكثر.
– والنّفقة؟
– أهون عليّ من تحمّل عبء الهزيمة.
– لستَ مهزوما يا زيدان! وإن تعسّرت لديك الحياة، فأنت تهرب من المواجهة لتعلن إفلاسك وفشلك.
– إنّي لست هاربا، بل قدرتي على الحلم بعالم آخر تستدعي التّمرّد يا نوّة.”
“لم تمرّ لحظات إلاّ وقد عاد صوت هادر قطّعه الصّدى لمرّات متتالية:
– قف مكانك! ولا تتقدّم خطوة أخرى!
– إنّي لا أراك، فمن تكون؟ وما الّذي أنت صانعه في هذا الزّمن وقد هجم الظّلام؟
– أنا الّذي أراك. كنت أظنّ أنّي تركت العيون.
– بل أنا من ظننت أنّي تركتكم هناك. فما الّذي دفعك للّحاق بي؟
– اتركي وشأني! ودعني أنقر الصّخر وأحفر حتّى الكسب الثّمين.
الكسب الثّمين؟
– ولا أثمن منه.
– ومتى تُنهي مهمّتك؟
– حين أظفر بضالّتي.
– وما ضالّتك؟
– بيانات كتب صفراء أرشدتني إلى كنز قد ألقاه وقد لا أظفر به.
– آه فهمت!
– هل تُشاركني؟
– في الجريمة؟
– أيّة جريمة يا هذا؟ دعنا نكسب ممّا ترك الأوّلون.
– الويل لك ثمّ الويل.
– احذر يا رجل! فربّما ترشد العسس إلى موقعي.
– لا عسس بعد اليوم، فاغنم مثلما شئت. إنّهم منشغلون، منشغلون” .
“ولم يفكّ اضطرابي إلاّ ذلك الصّوت الّذي باغتني منذ حلولي، فعاد إليّ سائلا:
ظننتك عابر سبيل. إلاّ أنّك أطلت المقام. أيّ سرّ وراءك؟
كرب وهمّ، أرق وغمّ، وشيء من بئس المصير.
يا لخطبك القاسي!
بل يا لخطبهم لو كانوا يعلمون!
ما الّذي بينكم؟
ارث قديم وأصنام تنبعث من جديد.
إنّك تفتعل لعنة الغريم! أما جادلت؟
فبئس مثوى المجادلين!”
وهكذا قس بقيّة الحوارات التي وردت في الرّواية. ولعلّك لاحظت أن انتقال الكلام من مخاطب إلى آخر كان مجرّدا من كلّ ما يدلّ على الشّخصيّة من هيئات وأحوال وحركات وسكنات. فقط يبرز صوتها ليحمل فكرة ما ثمّ يضمحلّ.
ومن المؤكّد أن هذا الخيار لم يكن عشوائيا في رواية «مددًا… مدد…” ولا جاءت به الصّدف والعفوية غير المقصودة. بل فرضه المناخ العامّ الذي اختار الروائي مراد البجاوي أن ينقله إلى قرّائه. فمن طبيعة الاستبداد أن يعلو صوت المستبدّ لوحده مقابل أن تخفت أصوات الآخرين ولو أدّى الأمر إلى خنقهم وحرمانهم من الحريّة والحقوق، إمعانا في الابتعاد عن الفطرة السّليمة وطبيعة الإنسان السويّة. فكأنّ السارد/ زيدان هنا يقع تلقائيّا فيما يرفضه ويهرب منه، ويجد نفسه مجسِّدًا لصفة الاستبداد دون شعور منه، ولعجزه أيضا على أن يكون ديمقراطيّا حقّا ولو على مساحةٍ ورقيّة. أليس في النّخبة من يتشدّق بقيم الحريّة والعدل والحقّ والجمال وهو ألدّ الخصام لها من المستبدّ نفسه؟! ما هو إلّا امتحان صغير حتّى يجد نفسه على المحكّ دكتاتورًا ولا أبشع منه!
تلك من الرّسائل الخفيّة التي حاولت الرّواية إبراقها إلى القارئ.
آثارها على الحاكم:
وأنت تقرأ رواية “مددًا… مدد…” لن تعثر على ملمح واحد للحاكم سواءً من جهة صفته الشخصيّة أو أبعاده الأخرى. فأنت لا تدري هل هو رئيس أو ملك أو إمبراطور أو أيّ لقب آخر من ألقاب الحكم. لا تدري ما هو نظامه بالضّبط، رئاسيّ، برلمانيّ، ملكيّ… فقط تشعر به من حولك ولا تراه. إنّه الحاضر الغائب في آن. حاضر بأدوات حكمه وسجونه ومراكز أمنه ومحاكمه. وغائب بإنجازاته، وبنفعه النّاس والبلاد والأجيال القادمة…
تناول الحاكم بهذه الضبابيّة الملفتة هو موقف من المواقف الملفتة عبّر عنه السارد بطريقته الخاصّة، فكأنّه يجرّده من آدميّته ووجوده الحقيقيّ ويختزله في مجرّد حالة عامّة تجثم على البيئة العربيّة المأزومة، بقطع النّظر عمّن يكون…
آثارها على الحدث:
من الطّبيعي أن يتجمّد الحدث ويقترب من حالة السّكون مادام الصّوت الدّاخلي هو الطّاغي، وما دامت الشّخوص التي تبعثه وتخرجه إلى الحركة والفعل قد تحوّلت بدورها إلى مجرّد أصوات وأصداء، لكن هذا لا يعني أنّ الحدث قد غاب تماما. فمن فصل إلى فصل كانت الرّواية تعالج وجها من وجوه الأزمة عن طريق ذاكرة السّارد وما حملته من حكايات ومفارقات وطرائف منفصلة عن بعضها بعضا لا يربط بينها رابط عدى صلة أبطالها بالرّاوي المأزوم. والحدث على هذا النّحو كان أشبه ما يكون بقطع الدومينو. لا يطّرد في النّماء إلا إذا تجاور مع غيره في مساحة محدودة جدّا، أسجلّ هذا مع الإقرار ببعض الاستثناء خصوصا مع الشخصيّة الرئيسية التي تميزت بحركة محدودة مكّنتها من إنتاج أحداث على نحو ما ذكرنا. من ذلك: الهروب من المدينة إلى الجبل/ إلقاء القبض على زيدان/ حياة السّجن/ التّحقيق الأمنيّ والقضائيّ/ مداولات المحكمة/ انقلاب عربة البوليس بالبطل في منحدر حادّ/ دخوله إلى المستشفى/ ظهور شخصيّة غيلان/ الكشف عن المجرم الحقيقيّ/ الخروج من السّجن/ العودة إلى الجبل مرّة أخرى…
آثارها على الزّمن:
بما أنّ الشخوص في عمومها كانت باهتة قليلة الحركة والتأثير على الحدث للأسباب التي بينا، عاجزة عن الحركة والفعل فإنّ دور البطولة من حيث تأثيرها وهيمنتها انتقلت-حسب رأيي-من الشّخوص إلى الزّمن في عمليّة تغيير واضحة لمفهوم البطولة. وهذا يُحسب للكاتب مراد البجاوي. ذلك أنّ صوت الزّمن في رواية «مددًا… مدد…” كان الأقوى والأبرز بسبب ما احتواه من قضايا حارقة تتّصف بالقسوة والبشاعة والوجع، وتداخل الحقائق مع الكوابيس والأوهام، وتبعثرها في محيط غامض لا ندري معه الزّمن المحدّد لتلك القضايا. هل هو مثلا يعود إلى أواسط القرن العشرين غداة خروج المستعمر من البلاد العربيّة؟ أم يعود إلى قبل ما يعرف بثورات الرّبيع العربيّ؟ أم بعده؟ ولولا مراكز التّحقيق ومداولات المحكمة ومراعاة بعض القوانين والإجراءات المتداولة في عصرنا لذهب بنا الظنّ أنّ محيط الزّمن أوسع بكثير ممّا تقدّم وقد يمتدّ إلى العصر الوسيط والى ما بعده!
وأحسب أنّ بناء الزّمن الغامض على هذا النّحو كان موفّقا للغاية باعتبار أن قضايا العرب وأسئلتهم الحارقة لم تتغيّر ولم تُحَلَّ بعد. هذا من جهة، ومن جهة ثانية كان يشكّل موفقا ما، على اعتبار أنّ الزّمن لم يكن فيزيائيّا في تقديرنا، بل كان زمنا ذهنيّا بحتا يتحرّك في ذهن سارد مأزوم اختلطت فيه الحقائق بالأوهام، والكوابيس بالوقائع، والأمنيات بالخيبات. كان غموضه موفّقًا كذلك نتيجة وعي السّارد المضطرب الذي يحمله هذا التيّار إلى جهة، ويجرفه ذاك التيّار إلى جهة أخرى معاكسة. ولعلّ لهذا التّأويل بعض القرائن. منها انكسار الزّمن في «مددًا… مدد…” على نحو بيّن فهو لا يسير في خطٍّ مستوٍ حتّى يتعرّج ويتقطّع خارج منطق البدايات والنّهايات. ومن هذه إلى تلك يتحرّك عبر موجات متذبذبة تدور جميعها في حلقة مغلقة كما أشرنا أوّل حديثنا. ولا يفوت القارئ المطّلع أنّ هذه من طبائع الذّهن المشوّش المتعب المقهور الذي لا يسير في نسق مرتّب، حسب الزّمن الفيزيائيّ المعروف.
آثارها على المكان:
إذا اتّفقنا على أنّ ذهن السّارد المشوّش القلق، هو الوعاء الذي تحرّكت فيه الرّواية، وإذا اتّفقنا أيضا على أنّ الزّمن ذهنيّ محض باعتباره مفارقا ومفصولا عن الزّمن الحقيقي عند نقله للأحداث والوقائع، فإنّ المكان في رواية «مددًا… مدد…” أخذ طبيعة هذا الذّهن من حيث علاقته بالزّمن، ومن حيث طغيان الضبابيّة وعدم الوضوح. من المنطق حينئذ على ذهن مرهق وحائر ألّا يهتمّ بتفاصيل المكان وألّا يصّوره تصويرا حسيّا ناطقا بالجمال ولو في حدّه الأدنى. حسبه أن ينصرف إلى الأزمة رأسا. وحسبه أن يختزل الفضاءات التي شكّلت المكان في مجرّد أسماء جافة: جبل/مغارة/زنزانة/ مستشفى/ محكمة…
آثارها على الرّمز:
عندما يتعرّض الذّهن البشريّ إلى ضغوط عالية فإنّ ردّة فعله إزاء العالم وذاته ومحيطه تختلف عنها في حالة الدّعة والسّلام، وتتحوّل إلى شبكة معقّدة من الرّموز التي تخفي وراءها ما تخفي من الدّلالات العميقة والمعاني المشفّرة. والحقّ إنّ رواية «مددًا… مدد…” غنيّة بهذا الجانب وقارؤها يستطيع دون عناء أن يكتشف شبكة معقّدة من الرّموز المتناثرة بين سطورها من البداية حتّى النهاية. منها ما هو مغلق مستعصٍ يلفّه الغموض، ومنها ما هو شفّاف رقيق يكشف عمّا وراءه في يسر وسهولة. تمتزج بالسّخرية والمفارقات المؤلمة المضحكة، وتمتزج أيضا بالمواقف السياسيّة والمبدئيّة. وهكذا ولدت معاني متعدّدة عوّضت محدوديّة الحركة الروائيّة التي ألمحنا إليها سابقا، فضلا عن جذب القارئ ودفعه إلى أن يكون شريكا فاعلا في بنائها.
ويمكن الاكتفاء بالإشارة إلى النّماذج المختلفة التّالية للدلالة على أهميّة هذا البعد ونترك للقارئ فهمها على النّحو الذي يريد:
“يا لخطبك القاسي!
بل يا لخطبهم لو كانوا يعلمون!
ما الّذي بينكم؟
ارث قديم وأصنام تنبعث من جديد.
إنّك تفتعل لعنة الغريم! أما جادلت؟
فبئس مثوى المجادلين!”
– “هذه منامتي آخر اللّيل. فكيف تحوّلت إلى قرينة؟
– هذا شغلنا يا زيدان! ألا تعقّلت؟
– تشتغلون ولو كنتُ على نوم؟ وماذا تركتم لخاصّتي؟
– كلّ مواطن بما كسبت أحلامه رهينة.
– ومتى تعلّمتم هذا؟
– أثناء نومكم يا شقيّ. ناموا إذن ولا تستيقظوا!”
“أرسلت بصري خلسة إلى وجه وكيل الجمهوريّة، فإذا بي أمام مشهد تكرّر ثانية، فانطبقت عليّ كمّاشة الحيرة. يا إلهي! أهذه قضيّة جنائيّة؟ أم مواكب عزاء؟ ما الأمر يا زيدان؟ وخزتني شوكة الصّدّ عن الشرود واستدرت استجابة لطلبهم منّي الخروج. ما الّذي أصاب وكيل الجمهوريّة؟ إنّه يذرف الدّمع مدرارا كأنّ خطبا نال منه”.
“الخنافس تتقدّم في دبيب بطوليّ، والرّوائح تنتشر في كلّ الأرجاء، والدّيار تغرق في عفن نسائم الصّباح الشّامتة. إنّني قابع في نفس المكان ومتستر عن انزعاجي من هزيمتي. لو كان للمدينة وجوه صدّ قادرة على تأمين أنفاسها. فليس كلّ ما تراه حقيقة، وليس كلّ ما يبدو منذرا بالخطر وثيقة إقرار باتّخاذ القرار. لكنّي أقرّ بأنّني خائف من المصير…”
آثارها على اللّغة:
في ظلّ ضبابيّة الزمان والمكان والشّخوص وتماهي بعضها في بعض. وفي ظلّ الأجواء الغرائبيّة وانقسام الذّات على نفسها نتيجة لهيمنة تيّار الوعي، فإنّ اللّغة في رواية «مددا… مدد…” تحمّلت أعباءً إضافيّة زيادة عن مهامّها البنائيّة والدلاليّة. استطاعت أن تعوّض بطء الحركة في النّص بحركة أخرى أكثر نشاطا وانسيابيّة، تشدّ القارئ وتدفعه إلى متابعة القراءة حتّى السّطر الأخير. أو بتعبير آخر شكّلت شركا جميلا حتّى يلج قارئها من بوّابتها إلى عالمها المليء “بالدّلالات والرّموز والتّضاد والتّنافر والكثافة الشعريّة والسّخرية والتهكّم والاحتجاج الصّارخ أحيانا، والنّبرة الحادّة والتراكيب المصقولة المدهشة والفجوات الشعريّة والمفارقات ونسج المفردات القديمة والحديثة في تراكيب متألّقة ومتأنّقة.”
ونلاحظ من جملة ما نلاحظه أنّ الكاتب مراد البجاوي التمس من التّراث عموما، والقرآن الكريم خصوصا نفسا لغويّا متّن لغة نصّه وأعطاه به قوّة ومتانة، رفعت منسوبه الجماليّ وأخرجته من المنطوق العادي.
ولهذا المنحى اللّغوي دافع ووظيفة:
إنّ المتتبّع لكتابات مراد البجاوي الروائيّة السّابقة يلاحظ بيسر أنّ استلهامه من لغة القرآن والسنّة النبوية والتّراث عموما، غدا بصمةً تميّزه من غيره، حتّى أنّنا نحجب اسم الكاتب عن الكتاب فندرك من الوهلة الأولى أنّ مراد البجاوي هو كاتبه. وأمام تكرار هذا المنحى في أعماله السّابقة نستنتج الدوافع الذاتية للكاتب. وحقّ له احتفاؤه بتراث أمّته العظيمة، وارتباطه بها ارتباطا عاطفيّا ومعرفيّا. ذلك أنّ من عظمة لغة التّراث أنّها ما زالت تحافظ على جماليتها الفريدة وعطائها المُلهم رغم ما مرّ ويمرّ بالأمّة. لكن بقطع النّظر عن ذاتيّة الكاتب لم تحضر هذه اللّغة في رواية «مددا… مدد…” من قبيل الصّدفة أو العفويّة غير المحسوبة. ذلك أنّ النّصّ، كلّ النّصّ تنفجر بؤره بالتّأويل ولا ينتهي معناه عند ظاهر ألفاظه.
من وظائف الاستلهام من التّراث أنّ الهموم والمشاغل التي تعالجها الرّواية هي عينها التي يعاني منها الإنسان العربي منذ أحقاب مديدة. الاستبداد وخنق الحريّات والاستحواذ على الحكم تحت مسمّيات عديدة، وجوع الإنسان العربي، وافتقاده لكرامته وغير ذلك، ليست مشكال راهنة فحسب بل تمتدّ جذورها إلى التّراث القريب والبعيد. فكأنّ الزّمن لم يتغيّر والتّاريخ مجرّد حلقة ثابتة من المآسي والأحزان. فاللّغة بنت عصرها. واللغة في «مددا… مدد…” ابنة قضاياها التي تعالجها، القضايا القديمة الجديدة في آن.
الملخّص:
إنّ تيّار الوعي بما هو حركة ذهنيّة بحتة تمثّل سيلا متدفّقا من المشاعر والأحاسيس والرّؤى والأفكار والأحلام والهلوسات والمخاوف والهواجس، فإنّ لذلك آثارًا ووظائفَ نأت برواية «مددا… مدد…” عن الكتابات الروائيّة التقليديّة وحتّى الحديثة، وجنحت بها إلى الرّواية الجديدة، أو ما يعرف بالرّواية ما بعد الحديثة. ولقد كان لتيّار الوعي باعتباره العصب الرئيسيّ في الرّواية والرّوح التي هيمنت على أجوائها، أثارًا على بقيّة تقنيات الرّواية وعناصرها، مسّت طبائع الشّخوص، وحولّتها إلى أشباح ليس لها من الخصائص إلّا الأصوات المنبثقة من هنا وهناك عبر حوار مجّرد من الإشارات الركحيّة أو ما يدلّ على آدميّتها. ولقد امتدّت آثاره أيضا إلى الحدث الذي تباطأت حركته واتّسمت بعدم الاطّراد والنموّ العضويّ. كذلك أثّرت في الزّمن وأسندت له دورا من أدوار البطولة التي لا تقلّ أهميّة عن دور السّارد. أمّا المكان والرّمز واللّغة، فكان لها نصيب واضح من تلك الآثار التي يمكن أن تربك المتلقي وتجعله يعيد طرح الأسئلة من جديد عبر سلسلة من التأمّل وإعادة التّفكير.