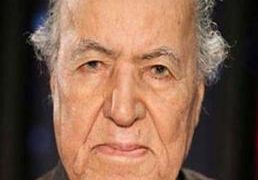#دراسة_نقدية_لقصتي_القصيرة_شال_أمي_الأخضر_بقلم_الناقد_العراقي_الاستاذ_حيدر_الأديب
————————-
———————–
الذاكرة بوصفها لغةً لا حدثًا:
قراءة في قصة “شال أمي الأخضر” لمهدي الجابري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تتناول هذه المقالة النقدية قصة “شال أمي الأخضر” للكاتب العراقي مهدي الجابري بوصفها تمثيلًا سرديًا نوعيًا لتحولات الذاكرة من الحدث إلى اللغة، ومن الحكي إلى الحضور الرمزي.
لا تُقرأ القصة وفق منطق الحدث الكلاسيكي، بل تُفكك من داخل بنيتها الرمزية واللغوية، حيث يتقدم “الشال” بوصفه رمزًا حدوديًا يختزل الوجود والمحو، والحياة والموت، والهوية والفقدان، في صورة لغوية مشهدية مكتنزة.
تعتمد القراءة على فتح مداخل غير مألوفة في تحليل القصة، من أبرزها:
• تشكُّل الذاكرة بوصفها تجلّيًا لغويًا لا وثيقةً تاريخية.
• الرمز بوصفه كفاءةً دلالية لا مجرد إحالة.
• الحجاج المشهدي واللغوي في بنية السرد وارتباطه بأخلاقيات التذكر.
كما تُظهر القراءة تماهي الصوت الفردي مع الذاكرة الجمعية، وذوبان الذوات داخل مشهد النداء الكلي، حيث يصبح البكاء شكلًا بلاغيًا للمحو والنجاة معًا. وبهذا، تتحول القصة إلى نص احتجاجيّ مكتوب من داخل الخسارة، لا من أجل استرداد المعنى بل لتأبيده بلغة ترتجف وتضيء.
ينتهي المقال إلى اقتراح مفهوم جديد للسرد تحت عنوان: “كتابة الضمير”، بوصفها سردًا لا يطلب الوثوق، بل يؤسس ذاكرة أخرى من داخل اللغة التي لم تُكسر بعد.
في “شال أمي الأخضر”، لا يقدّم مهدي الجابري قصة حدث، يقدم نصًّا مكتوبًا من داخل ذاكرة مشروخة. هنا لا نجد ساردًا يستعيد من موقع الأمان ما حدث، الذاكرة تحضر هنا وتحاول بكل قواها أن تكتب اللغة دون أن توحي أنها تتكلمها. يبدو إننا أمام شكل من أشكال الكتابة ما بعد المأساوية، حيث يتخلى الإنسان عن كونه ذاتًا تحكي لصالح كونه أثرًا لغويًا يحاول البقاء.
إن المقبرة لا تحتاج إلى جغرافيا بقدر ما تحتاج الى جملة تقود المشهد الى احداثياته وابعاده
فاللافت في القصة أنّها تفتح على الموت من داخله، وتقول: كل الصحراء مقبرة. وهذا إلغاء لمبدأ النسبة المكانية. لا يوجد “هنا” ولا “هناك”، حيث السارد يضع خمسة أصابع ليقول: “هنا خمس مقابر”، وكأن اللغة تُجسّد الجريمة وتحوّل اليد إلى خريطة.
بكلمة أخرى، نحن أمام لغة تحوّل الجسد إلى توقيع على الذاكرة. المقبرة ليست حفرة، وإنما كلمة تقال، وشاهدها شال ممزق.
وحين ينوب الرمز عن الأم، ويكتشف الجندي الحقيقة المؤجلة فان الجابري هنا يتعامل مع حركية الرمز في معادلات مختلفة
الشال، الرمز المركزي تنعدم دلالته على الأم مباشرة، حيث يعمل كاستعارة متعددة المستويات:
منها اللغة الأولى للحنان (حين كانت تمسح دموعه بطرفه). ومنها القناع الذي حجب عنها رصاصة المصير (حين رمته خارج الحفرة) ومنها العودة المعكوسة للأمومة (حين عاد الطفل رجلًا ليحضن الشال).
أما الجندي ذو القلادة، فهو اختراق مذهل في بنية النص: يظهر لا بوصفه منقذًا، بل شاهدة على أن الشر لم يكن مطلقًا، وأن اللغة التي تُدين يمكن أن تحمي.
غير أن الجندي نفسه يُكتشف لاحقًا في الحفرة، وكأنّ القصة تقول: لا أحد ينجو من لعنة الحقيقة المؤجلة. فـكل من رأى الجريمة يموت بها، حتى الجندي الطيّب.
ومن الملفت في قصة الجابري هذه أن اللغة لا تسرد.. لا تقول …. لا تجزء المشهد، إنما تُساءل عن إمكانية السرد من أعمق ما في النص، أنه لا ينظّم سردًا متدرّجًا بل يعجز عن الترتيب. وهذه ليست عثرة، بل حكمة سردية. فالذاكرة هنا تشبه الجسد المعذّب: لا يستقيم، بل يرتعش، ويضطرب، ويتكلم بجُمل مقطوعة، وصيحات متفرقة، ودهشة مفرطة.
“كأني للآن أسمع صراخهم…”
“القلادة…كان بينهم!”
إننا نشهد انفجار المعنى تحت ضغط القمع. ولعل السؤال المركزي الذي تقترحه القصة هو:
هل يمكن للسرد أن ينجو من المحو حين يكون الزمن ذاته قبراً؟
تتحرك القصة في ما يشبه شعرية الشهادة، لأنها تجرّد كل حدث من خصوصيته ليصبح تعبيرًا عن جريمة بلا اسم.
في الأدب التقليدي، نعرف من القاتل، من المقتول، ما السبب، ما الغاية.
أما هنا، فكل شيء مبهم:
التهمة: “أنتم خونة”
العقوبة: الإعدام الجماعي
الفاعل: “أحدهم”، “العجلات”، “الآليات الثقيلة”
اللغة هنا تنزع الهوية عن القاتل والمقتول معًا، في دلالة تقرّ أن المحو بلغ ذروته.
ونرى جليا بان الطفل الذي روى الحكاية لم يكبر بعد في أعماق الراوي، فهذا الراوي وبصورة مدهشة رغم كونه شاهدًا راشدًا الآن، لا يروي من موضع الحكمة أو التعالي، بل من داخل الارتباك الطفولي. كل ما في القصة يُرى بعيون طفل:
“لم أكن أعلم ما تعنيه كلمة الخونة”
“أرتال تتحرك”
“حُفر كبيرة”
“أمي أمسكتني”
بذلك يتحول النص إلى استعارة كبرى عن الزمن المعلّق. لم يكبر السارد، لأنه لم يخرج من الحفرة، فقط هو أُجلت جنازته.
شال أمي الأخضر هي فاجعة تتحوّل إلى “لغة ثانية”، لغة لا تَصف، تحاول النجاة بخلق المعنى من تحت الركام.
إن “شال أمي الأخضر علامة على أن الجمال يمكن أن يكون أيضًا مقاومة، وأن الذاكرة حين تكتب، تُحيي من ماتوا بالمحو.
في القصة القصيرة “شال أمي الأخضر” للقاص العراقي مهدي الجابري، لا يحضر الحدث بوصفه مفصلًا روائيًا أو محطة زمنية، إن ما يمكن إمساكه من حضور الحدث هو حضوره بوصفه أثراً جارحاً داخل اللغة، يتكون من شظايا ذاكرة لا من متون وقائع. فالقصة، على قصرها، لا تسرد مذبحةً بقدر ما تكتب ارتجاج الذاكرة حين تتعرف على ماضيها في قطعة قماش بالية.
نحن أمام نص ينتمي إلى ما يمكن تسميته بـالسرد التذكري المضاد للحدث إذ ليست القصة قائمة على بنية تصاعدية تؤدي إلى ذروة، ما نلاحظه انها قائمة على ارتداد مفاجئ للذاكرة من خلال أثرٍ مادي (الخرقة التي تبيّن أنها شال الأم)، ليبدأ بعد ذلك سرد داخلي متقطع، كأن الذاكرة لا تتذكر بترتيب بل بإيلام.
اللغة بوصفها حفّارة الذاكرة
في قصة الجابري، اللغة ليست وسيلة نقل، هي وسيلة نبش. يتم استدعاؤها بانفعالٍ لغوي يقطر عرقاً وخوفاً ورمالاً وليس باسترجاعٍ خطي للأحداث:
“غرته مبللة بالعرق… يركض من حفرة إلى حفرة… يصرخ: شال أمي!”
هذا الانفعال يعمل على استعادة الحدث من داخل الجسد، كأن الحكاية تُستخرج من بين مفاصل الذاكرة لا من دفاترها. هنا، الشال هو أداة استدعاء للزمن الحي، الذي ظل حبيس اللاوعي، حتى انفجر بفعل الصدفة الرمزية.
تتبين كفاءة الرمزمن الخرقة إلى الطقس فالرمز في النص شيفرة. “شال أمي” لم يكن علامة على الأم، هو بمثابة بنية سردية طقسية، يعبر عبرها الطفل إلى طور جديد من الإدراك. بمجرد لمس الشال، يتحول النص من المراقبة إلى الاعتراف، ومن السرد الخارجي إلى الصوت الداخلي.
“راح يحكي بصوت خفيض وكأنه يكلم نفسه…”
هذه اللحظة تحوّل الرمز إلى ممر للتشظي، لأن الشال لا يستدعي الأم وحسب، بل يستحضر لحظة الفقد كأنها لم تغب. وهنا تبرز عبقرية الرمز: أنه لا يُشير إلى الشيء، بل يُفعّله.
لا يظهر التاريخ في القصة بوصفه توثيقًا أو خلفية زمنية. التاريخ هنا لا يُذكر، اننا نشعر به. لا تواريخ، لا أسماء أماكن، لا إشارات مباشرة لأنظمة أو حقب. ومع ذلك، يعرف القارئ بوضوح أنه أمام قصة من ذاكرة المقابر الجماعية في العراق. وهذا هو الفن في أعلى درجاته: حين يتحوّل الخاص إلى كوني، والصمت إلى صراخ من طين.
التاريخ في “شال أمي الأخضر” يُخترق من الداخل، لا يُروى من الخارج.
رغم أن النص لا يحمل طابعًا جدليًا مباشرًا، لكنه يحتوي على مباني حجاجية غائرة في اللغة والمشهد، منها:
مشهد الركض بين الحفر، الخرقة البالية، والصرخة، كلها حجج بصرية على وجود جريمة لا تحتاج إلى وثائق. المشهد يُقنعك بشيء لا يُقال بل يُرى. وهذا يمكن تسميته بالحجاج المشهدي
ثمة ما يسمى بالحجاج التقريري العكسي
“لم أكن أعلم ما تعنيه كلمة الخونة… ولا العملاء… ولا عدو”
يبدو هذا الكلام اعترافًا، لكنه حجة براءة خفية: كيف يُتّهم طفل بالخيانة وهو لا يعرف معنى التهمة؟ هنا البراءة تُبنى على الجهل المدبَّر.
حتى القلادة تتمثل بأنها حجة تراجيدية
“ذاك الجندي كان بينهم… القلادة…”
في هذه اللحظة يتحول الجندي الرحيم إلى شاهد مأساوي على ما لا يُحتمل: لقد صار جزءًا من الجريمة التي حاول مقاومتها. هذه أعلى درجات المفارقة الحجاجية: حتى الرحمة لا تبرّئ الجناة، بل تكشف تناقضهم الوجودي.
هذه القصة لا تُروى من زاوية واحدة، فهي تطل علينا من زوايا تتناوب على الرؤية. فثمة نظرة المراقب (فريق حقوق الإنسان)، ونظرة الجنود، ثم الانفجار الذاتي لذاكرة الضحية الناجي، وهذا التعدد يمنح القصة ما يشبه “العدسة المتذبذبة”، فلا نكاد نثبت على موضع حتى ينتقل النص إلى موقع شعوري آخر.
الذاكرة هنا لا تثبت، هي ترتعش، تهتز. وهذا هو سر تأثيرها.
(شال أمي الأخضر) ليست عن ماضٍ مضى، إنها ليست قصة ناجٍ، بل العكس هي قصة من لم ينجُ تمامًا، ومن لا يستطيع أن يعيش إلا إذا تذكّر، ولا يستطيع أن يكتب إلا إذا استعاد ما لا يُروى.
إنها قصة تقيم حدادها باللغة، وتبحث عن عدالتها بالرمل والدموع والخرقة البالية.
وما بين الشال الأخضر والقلادة المعدنية، تقف الحقيقة، لا تنتظر محكمة، بل تنتظر قارئًا يُصغي بعينيه، يصغي بذاكرته.
حيدر الأديب
قصة قصيرة
شال أمي الأخضر
يروح ويجيء بيننا متجاهلا كل من حوله مضطربا.
خلت أنه لا يرانا، غرته مبللة بالعرق جبينه يلمع تحت شمس الصحراء، يركض من حفرة على حفرة يركل الرمال بقدميه، يضع سبابته على صدغه وكأنه يحاول التذكر كبير فريق حقوق الإنسان يراقبه.. العسكر وفريق التنقيب توقفوا عن العمل وأخذوا يتابعون حركته البندولية التي لا تتوقف.
أحد المنقبين رفع يده بخرقة بالية وكأنها شال بهت لونه وتقطعت خيوطه.. انقض عليه كالصقر تلمس الخرقة نفض التراب عنها راح يبكي كطفل ويصرخ شال أمي
اقترب منه كبير فريق حقوق الانسان
هدئ من روعك..هل تعرفت على الموقع هل المقابر كلها هنا
رفع إليه بكفه فاردا أصابعه الخمسة
ممتاز كل هذه الصحراء ونعثر على خمسة مقابر جماعية انجاز … لكن كلمنا ماذا حدث؟
جلس محتضنا الشال وراح يحكي بصوت خفيض ونظرات شاردة وكأنه يكلم نفسه.
كانت حرارة حديد العربات لا تحتمل، الشمس تحرق رؤوسنا وكانت أمي تمسح دموعها بطرف شالها الأخضر وتظللني بطرفه الآخر اختلط نضح عرقنا بالدموع ليرسم خطوطاً مع التراب على وجوهنا، سلاح الحمايات في صدورنا، سأل أحدهم: أين نحن ذاهبون؟ كانت الإجابة! أنتم عملاء لدولة مجاورة عدوة ، لاكلام للخونة! لم أكن أعلم ماتعنيه كلمة الخونة.. ولا كلمة العملاء ولا كلمة عدو
الأرتال تتجه إلى طريق صحراوي بعيد جدا، ولازلنا نرتطم ببعضنا البعض، وصلنا إلى بناء قديم في الصحراء أشبه ما يكون بسجن، أنزلونا والضربات بالعصي والهراوات تتلاعب على ظهورنا، بقينا على هذا الحال في المنفى، حتى زارنا مسؤول كبير قال: وكل هذه الاعداد من الخونة ولا زالوا يأكلون ويشربون من خيرات البلد؟!! نفذوا حكم إعدامهم جميعا.. أصعدونا بذات المركبات العسكرية إلى أبعد نقطة، كانت هناك حُفر كبيرة جاهزة، صاح أحدهم أرموا الخونة في قعر التراب وساووا بهم الأرض، قلبت العجلات أحواضها محملة بالبشر كما تقلب أكداس النفايات، تعالت الصرخات منا وأرعبت الموجودين، تقدمت الآليات الثقيلة لتساوي بهم أديم الأرض بالأحياء، أمي كان شغلها الشاغل انا أمسكتني من يدي ورمتني خارج الحفرة تلقفني أحد الجنود خلت أنه سيعيدني إلى القبر لكنه على عجل ضمني إلى صدره حتى خلت أن القلادة ستخترق جبهتي استغل انشغال الجميع مسح دمعتي وطمرني بقليل من الأعشاب اليابسة كان مختلفا عنهم لم يضربنا طوال رحلة الموت وكان في عنقه قلادة تلمع تحت الشمس انسحب الجميع، أخذت أصرخ وأرفس التراب بقدميّ و أخذتُ أبحث لعلي أصل إلى أمي ولكن دون جدوى، كأني للآن أسمع صراخهم، أخذني الخوف والتعب فوقعت مغشياً عليّ، حتى أيقظتني أشعة الشمس الحارقة، نهضتُ خائفاً أتلفت وأجول الصحراء ببصري لا ظل ولا ماء ولا طعام، حتى لاح من بعيد غبار أخذ يقترب مني رويدا رويدا، تبينته وإذا بها سيارة قادمة غاب نظري تشوشت الرؤية وجف حلقي ورحت بسبات أسبح بالفضاء يظللني شال أمي الأخضر أفقت في بيت السائق على يد سيدة تسقيني الماء ..
قطع حديثه إذ رأى الحفرة تتسع قفز فيها بين أكوام من العظام … وأخذ يصرخ: القلادة … ذاك الجندي كان بينهم ..القلادة …كان بينهم..
مهدي الجابري.. العراق
@إشارة