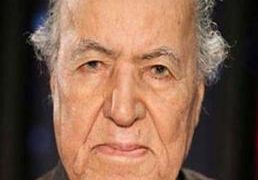قراءة في القصة القصيرة ( ساحة الدار ) للكاتبة ” لودميلا نده”
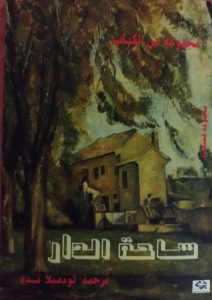
بقلم رولا علي سلوم”
القصة القصيرة ” ساحة الدار” للكاتب ” هامير الدين مداي” ترجمة الكاتبة ” لودميلا نده” ضمن مجموعتها القصصية المعنونة ب ( ساحة الدار) والمؤلفة من مئة وثلاث وعشرين صفحة من القطع المتوسط .
ساحة الدار مثل قبضة باب الدار، ومثل عتبة باب الدار، ومثل مفتاح باب الدار، أشياء لا تُستباح على الإطلاق، تحمل خصوصيتها ودلالتها، يعيها كلّ إنسان حرّ شريف، هي أشياء لا تقبل المساومة، أو التنازل عنها.. و”ساحة الدار ” قصة تحمل بين طياتها عبق التراث الأصيل، فساحة الدار حيث تجتمع نسوة الحيّ، وتقوم كلّ واحدةٍ منهن بعمل ما، تتبادلن الأحاديث والضحكات، إنها ليست مكاناً عابراً وحسب، بل؛ إنّها رمزٌ جميلٌ وحميم للعلاقات الإنسانية بين أفراد الحيّ.” هذا البيت يحتاج إلى سور، فوضى هائلة في ساحة الدار، تسببّها هؤلاء النسوة القادمات من كلّ حدب وصوب طيلة النهار، لايستطيع المرء أن يجد لحظةً من راحةٍ في هذا المكان وهنّ يصحن مثل مجموعة من البط” ص٩
وبناء سورٍ حول هذه الساحة، ووضع باب مغلق من قبل الأب صاحب البيت، والذي كانت تزعجه أصوات النسوة وضجيجهنّ ماهو إلاّ قتلٌ لتلك الحالة الإنسانية من التواصل الشفيف، ” في نهاية الأمر توقفت تجمعات الظهائر النسائية في منزل جعفر نهاي، كما توقفت أمي نهائياً عن الخروج من البيت ” ص١٠. لقد حدّت الأسوار من مجيء النسوة والتقائهنّ، وقتل كلّ تواصل بينهنّ، كما جعل الأم في عزلة وحزن كبيرين، ” هذه الأيام أرى أمي تمضي نهاراتها في فناء دارنا، وهي تنعم بشمس الظهيرة، جالسةً على حصيرة مصنوعة من سعف النخيل، مشغولة بتطريز قطعة قماش تتمتم وتدندن لحن أغنية أعرفها. وأسألها مع مَن تتكلمين يا أمّاه؟ وتردّ: أتراني أعاني نقصاً في عدد الناس حولي، ألقِ نظرة على كلّ هؤلاء النسوة، وتجول بنظرها في المكان، لقد غرزت أمي في هذا الفناء ٱلاف الغرز، أبدعت فيها مشغولات رائعة كما الحياة، لا، لم يغادر أحدٌ أبداً” ص ١١ . لقد أبدع الكاتب في تخيّر لفظة ” غرزت” لما تشير إليه هذه اللفظة من عمقٍ ودقةٍ وروعةٍ، فللمكان ذاكرة، وللمكان حضورٌ، لايستطيع السورُ بجبروته أن يمحوه ويزيله.. ولقد أجادت المترجمة الأديبة ” لودميلا نده” في إيصال هذا المعنى، وتلك الدلالة بحذافيرها، من خلال ترجمتها الجميلة، وذائقتها الأنيقة، إضافةً إلى تلك الثنائية التي ركزّت عليها القصة، فساحة الدار بامتلائها وحميميتها وذكرياتها، يقابلها السور بعزلته وقسوته وإبعاد النسوة عن تلك الساحة. ومع ذلك فقد كانت الغلبة للساحة، للحضور الآسر، إذ ليس الحضور بالجسد وحسب، بل؛ الحضور بالروح وبما يتركه المكان وضيوفه من آثار عابقة بالطيب والجمال. هذا ما أشار إليه الكاتب، رمزٌ شفيف من خلال كلمة ” غرزت” ولّدت معاني ثواني في القصة، وأعطتها إيحاءات إنسانية وتراثية معبّرة، فهل بتنا في عصرنا نفتقد تلك الساحة ؟؟!! ” على امتداد عدة سنوات فقط، تغيّرت طبيعة الجوار كثيراً، فجميع البيوت الآن صارت مبنّية من الاسمنت، اختفت كلّ البيوت الطينيّة، الجميع ضمن ملكياتهم، يعيشون خلف الأسوار والأسيجة، حتى إنّ رائحة الدجاج المطبوخ في أحد المنازل لم تعد تخترق الجدران لتنبعث في أمكنة أخرى من البيوت المجاورة” ص١٠ لم يمنع السور النسوة من اللقاء وحسب، بل؛ قتل العادات التراثية الجميلة بين أفراد الحيّ، عندما كانوا يتقاسمون الطعام الطيّب فيما بينهم، ركّز الكاتب على دلالات تراثية عميقة كالتطريز وحياكة حصيرة من سعف النخيل، وتدوير ملابس صوفية قديمة، ودندنة ألحان الأغنيات الحزينة المؤثرة .. ولم يذكر الكاتب أسماء لشخصيات قصته” ساحة الدار” ربما ليؤكدّ على أنّ هذه الشخصيات عامة وليست خاصة، فهي كثيرة في المجتمع وليست محدودة ..
لقد أصبحت غربتنا أشدّ قسوةً مع التعوّد، على الرغم من أنّ الذاكرة لا تُمحى، وحضور الأشخاص يبقى، لكنّ للزمن على المدى البعيد آثار مؤلمة، على أمل أن تتغلّب ذكرياتنا التي نقتات عليها لنستمرّ كما نحبّ، وعلى أمل أن يبقى مفتاح سورية بأيدي أبنائها، أصحاب الدار.
رولا علي سلوم