الثراث اللامادي في رواية
( خطى كتبت علينا )
للأديبة السورية ( ناديا شوالثراث اللامادي في رواية
( خطى كتبت علينا )
للأديبة السورية ( ناديا شومان )
جرأتها في طرح فكرة مضى عليها الدهر بعيدا ، إذ عالجت في روايتها استخدام فتيات من الريف كخادمات مؤجرات لبعض الأسر الثرية في المدن ..
أعرض قراءتي المتواضعة لهذه الرواية الجميلة .. وكمقدمة أذكر عبارتي وهي من وحي ما قراته :
( ناديا شومان زهرة تفتحت، فلامس عطرها أرواحنا العطشى ) ..
تبدأ الكاتبة روايتها بمشهد مؤثر، مخاض ” فهيمة” ، ومعاناتها القاسية في وضع مولودها، تساعدها والدتها في البداية ، عبثا من غير فائدة، لثلاثة أيام تعاني مخاضاً صعباً عسيراً ، تصوير دقيق تحاول الأم والنسوة فيه مساعدة “فهيمة”، لكنّ القدر أقوى .
مشهد جميل جدا من حيث التفاصيل الدقيقة التي ذكرتها الكاتبة، والحالات الشعورية الحسية التي تكاد تلامس أرواحنا . تصف الكاتبة معاناة الناس ؛الفقر الجوع ،البيئة، الجهل ، قلة الحيلة ، الموت … كلها
ساهمت في جعل فهيمة تعاني، ثم تُسلِم الروح .
و( الأمراض _ كما تقول الكاتبة _ على أنواعها تشفيها قطعة من البطيخ الأحمر أو جرعة زيت، أو بعض حشائش مغلية، والأورام تُداوى بالكي ) ص١٠ .. هي ذي مساحة العقل والفكر في القرية .
يحاول أخ ” فهيمة” شق بطن أخته لإخراج المولود ، لكنّ زوجها يمنعه قائلاً : ( لا لن تمسها ، ما نفع الولد بعد أن ماتت الأم ، لا ريب أنها ابنة خامسة ، لتدفن مع أمها فذلك خير لها ، وعلت أصوات : لا ..لا يجوز لحرمة الميت أن تُنتهك ..أبداً ، وقالت أصوات أخرى : يا للعار .. أيطلع الرجال على جسد المرأة بعد الموت؟ أفضل لهذا الجنين أن يُقبرَ مع أمه ) ص١١
وبطريقة غير مباشرة تصف الكاتبة ” فهيمة” ، من خلال تذكر الزوج بشير لها : ( صبورة تساعده في العمل ، تهتم بالبيت ، غير متطلبة ، تكنس .. تعجن .. تخبز ..)
كثيرة هي الأحداث التي تتراوح بين المد والجزر ، بين اللين والقسوة ، الزوج القاسي والزوجة المحبة المعطاء ..تقول الكاتبة : ( أما هو فيلومها بعنف ويشتمها لا لشيء إلا لكونه تعباً ، فتصمت.. وقد تردّ عليه أحياناً بكلمة ، فينهال عليها ضربا، ويغادر البيت وهي لاتزال تبكي ، ويعود عند هبوط الظلام فإذا هي قد نسيت كل شيء ، وعلى استعداد لتلبية كلّ رغائبه ..
لقد أنجبت أربع بنات .. ماذا كانت أسماؤهن ؟ لقد نسي ، آه ، زهرة ومريم ونسيمة وفتنة ) ص١٥
تبدو حسرة الأب على موت زوجته ، والطفل الذي قد يكون دُفن معها صبياً ذكراً ، ثم موت ابنتيه زهرة ومريم ؛ زهرة وقعت في البئر ، ومريم ماتت بالحمى ، وبقيت نسيمة وفتنة ، تحملتا مسؤولية البيت، فقدتا الأم ، الحضن الدافئ ، تقول الكاتبة : ( فهيمة ماتت ، قتلها حملها الأخير، أيكون ذكراً هذا الطفل الذي مات دون إنجابه ؟ كان بمقدوره أن يعطيه لأخته تربيه مع أولادها ، ثم يكبر ويصبح شابا يساعده في العمل .) ص ١٧ هذه هي نظرة المجتمع للذكر ؛ نظرة ملؤها الحب والتعلق والرغبة الكبيرة …
تصف الكاتبة حال الزوج ” بشير “.. وهو يفكر بالزواج ،واختياره ل ” مسعودة “،رغم أنه لم يمضِ على وفاة ” فهيمة ” سوى أربع وعشرون ساعة ، نشعر بحوار بشير مع ذاته ، المونولوج الداخلي كثيرا ما تلجأ إليه الكاتبة ” ناديا شومان ” ، فهو يمنح النص حميمية كبيرة ، ودفئاً خاصاً ، حوار الذات وطرح الأسئلة والأجوبة …
تصف الكاتبة العمل المتعب المرهق في الأرض كزراعة التبغ ،تقول : ( أنجز شك صف طويل من الأوراق الخضراء بخيط ثخين من القنب، شعر بالجوع ، فاتجه
ناحية العين ، وتناول من الأرض قبضة من التراب ، فرك بها يديه جيدا ،فاتجه وعاد إلى مكانه ، فتناول من صرته رغيفا وبصلة كبيرة ، نزع رأسها بفمه ، ثم وضعها على حجر وضربها بقبضتيه ، فانسحقت ، وبرزت منها بصلة صغيرة بيضاء تلوثت بالتراب ، مسحها بيده ونزع قشرتها الخارجية وبدأ فطوره. ) ص١٨
وصفت الكاتبة حياة المعاناة والفقر من خلال خلو بيت بشير من الأثاث ومن الطعام ومن المصابيح، ومن أبسط متطلبات الحياة .. تتوالى الأحداث بعد موت فهيمة ، ورغم ذلك لايتوانى الزوج عن التفكير بالزواج من مسعودة ، يقارن بينها وبين زوجته الراحلة ،ويتمنى لو توافق على الارتباط به ، فهو سيلبي لها كل ماتطلبه ..تقول الكاتبة : ” أقبل الربيع وتفتحت في الأرض ملايين الزهور الصغيرة، وملأت البراعم الأشجار، وخرجت القطعان بعد حبس طويل لها إلى المراعي، وكثرت السواقي وفاضت الينابيع والعيون ، واقترب زفاف بشير ومسعودة ..” ص٣٥ . مقاربة جميلة في لغة الكاتبة بين مجيء الربيع وزفاف بشير ومسعودة .
يتم الزواج بينهما ، ويظهر دلال بشير لمسعودة ، وخاصة بعد أن ولدت له حسن، ثم تبدو معاملة مسعودة القاسية للفتاتين نسيمة وفتنة وإرهاقهما بالعمل … إلى ان تدخلت أم فهيمة وطلبت من أبي علي والد مسعودة
الرأفة بالبنتين ، فلبّت طلب والدها إلى أن مات .
في لغة الكاتبة تلك المسحة الإنسانية العذبة الشفيفة، والتي تبدو جلية بين ثنايا الكلمات والحروف .. وتلك الصور الفنية الرائعة المستمدة من عفوية الطبيعة وبراءة البيئة التي تعيشها … كثيرة هي مواقف الحزن الشفيفة المؤثرة ، والتي تمتلئ بها الرواية .. حقاً إنّ الحزن الشفيف ينقي الوجع ويصّفيه ويجلوه، ليصبح أكثر صفاء وروعة ونقاء وعذوبة…
اتسمت الكاتبة ” ناديا شومان ” في روايتها ” خطى كتبت علينا ” بسمات عدة وهي ، الجرأة ، والنفَس الطويل ، إضافة إلى الذائقة الأدبية الجميلة جدا، لاسيما عند الحديث عن التقاليد والعادات والموروثات وجماليات الطبيعة والبيئة ..
الجرأة ؛ تبدو من خلال طرح الكاتبة موضوعا حساسا ، وهو تأجير الفتيات من الأرياف بعمر صغير للعمل في الخدمة في بيوت الأثرياء والموسرين في المدينة. لقد احتل هذا الموضوع مساحة الرواية بأكملها ، فهو الموضوع الرئيس ، عالجت الكاتبة من خلاله صور التناقض بين الريف والمدينة ، بين الغنى والفقر ، بين العلم والجهل ، بين الحب والكره ، بين اللين والقسوة .. ثنائيات ضمنّتها الكاتبة أحداث روايتها ، إنها مشاعر إنسانية تتواجد في كل مكان وزمان ، ولعل السبب في
وجود تلك الظاهرة هو الفقر المدقع بالدرجة الأولى، فتأجير الفتاة لمدة معينة مقابل مبلغ من المال ، يخفف على الأب عبء مصروفها ، ثم إنه يستفيد مما يقبضه من مال لتحسين وضعه المعيشي ، إضافة إلى عوامل أخرى ؛ كرفض الخالة زوج الأب احتواء البنات . حتى بشير الذي كان قد استهجن هذا التصرف قبِلَ به في النهاية ، تقول الكاتبة : ” وكيف استطاع هؤلاء الأجلاف أن يؤجروا بناتهم ليخدمن في منازل أهل المدينة ” ص ١٨ . وهؤلاء الفتيات اللواتي خُلقن في تلك البيئة الفقيرة، كان قدرهن أن يخطون نحو قدرهن في المدينة ، وكل فتاة وما تحظى به ؛ إما عائلة رحيمة كريمة، أو عائلة قاسية بخيلة ، ولم تنسى الكاتبة شومان ان توضح آثار تلك الظاهرة ، كما بينت أسبابها ، فهي وإن كانت تعلّم الفتاة أعمال البيت والطبخ والتنظيف والحياة الاجتماعية ، لكنها كانت تسبغ مشاعر القهر والظلم والألم والذل والشوق والحنين إلى البيت الأول بيت عائلتها . اختيار موفق من الكاتبة في الحديث عن هذه الفكرة ومعالجتها .. لاسيما أنّ الفتاة لازالت في مجتمعنا الشرقي تعاني من التفرقة والتمييز بينها وبين الرجل ..
نسّوم وفتنة شخصيتان بدأت بهما روايتها ؛ حيث ماتت الأم ” فهيمة” إثر مخاض صعب بعد خمس ولادات كلهن بنات ، لم تستطع القابلة إنقاذها بسبب الجهل والفقر ،
ولم تردع الزوج في التفكير بأخرى، لاسيما أنه كان ينتظر مولوده الذكر ولم يتحقق، وخوفه من ان يكون المولود أنثى هو الذي دفعه لدفن الأم ومولودها الحي في رحمها من غير أن يتجرأ أحد على شق بطنها لاستخراج المولود .. هي ذي قسوة البشر فوق قسوة القدر …
ثم تبدأ رحلة نسوم وفتنة بعد رفض الخالة زوج الأب لهما، تبدأ رحلتهما الشاقة في المدينة، وفِقت ” نسوم” حيث أخفقت ” فتنة ” ، وما تفرع من قرينات لهن في العمر كان قدرهن أشد وأقسى ، ” نهوة ” كذب عليها حسن وأغراها بالزواج ، و ” زهرة ” لم يُعرف مصيرها ، و” عيشة ” ماتت بمشفى بعيد عن الأهل بمرض السل …
أما السمة الثانية لدى الكاتبة ” ناديا شومان ” فهي : النفس الطويل .. فبعد أن تضع المحاور الأساسية للرواية والخطوط العريضة التي تسير وفقها ، نراها تُشعّب الخطوط ، وتفرّع الأحداث، وتولّد من الشخصيات شخصيات تكاد تكون حقيقية ، نشعر ونحسّ بوجودها، كأنها تكلمنا وتشكو لنا آلامها وأحزانها ، هذا التماهي في الشعور بين الشخصية المتخيلة في الذاكرة وعلى الورق وبين الشخصية المتكونة من لحم ودم ونفس وروح ، وتلك مزيةٌ في أسلوب الكاتبة ، ألا وهو قدرتها على جعل الشخصيات حيوية نابضة بالحياة ، وذلك لا يتأتى عن عبث، بل؛ عن قدرة كبيرة ورؤية جمالية قادرة على تحريك الشخصيات بعفوية وصدق وروعة …ومما يؤكد على هذا النفس الطويل لدى الكاتبة هو خوضها في جزئيات وتفاصيل صغيرة جدا جدا ، تضفي عليها صفة الإنسانية الشفيفة، ففي كل تفصيل مسحة إنسانية شفافة ، هو مايجعل القارئ ينجذب لأحداث الرواية ويتفاعل معها ، ويقرأ الرواية بشغف من غير توقف .
ومما يجعل النص نابضاً بالحياة كثرة الأفعال في الرواية، والتي تدل على التجدد والحيوية ، وعلى الحركة والانفعال .. إضافة إلى تطعيم النص ببعض العبارات من البيئة المعاشة لإضفاء صبغة الواقعية ، فهي تسترسل في اختيار موجودات عذبة جميلة كحديثها عن الحبق وزهر الليمون وصنع ماء الزهر … ثم حديثها عن العادات والتقاليد في العيد ، وعن زراعة التبغ ومافيه من صعوبة بالغة، وحالة الدبق التي إن ألّمت بالزرع انتهى المحصول ، هي ذي ثقافة الكاتبة تساعد على خوضها في الحديث عن تلك التفاصيل التي ربما لا يعرفها سوى المتخصصون في ذلك كالفلاحين مثلا …
أما عن تقديمها لشخصيات روايتها ؛ فهي تتحدث عن الشخصية في الرواية من غير أن تقدّم كل شيء عنها
دفعة واحدة ، بل تترك لخيال القارئ أن يتشوق لمعرفة المزيد ، فنرى ذلك يبدو بعد فصل واكثر ، عندما تعود الكاتبة بالخلف خطفاً ، وتستذكر تلك الشخصية وتكمل ما بدأته عنها، إنّه أسلوب التشويق والجذب ، وكل ذلك بلغة جميلة معبرة واضحة، مليئة بالمفردات ذات الوقع العذب على الأذن ، فليس من كلمات نابية عن الذوق ، بل إنها تتذوق اختيار المفردات بشكل آخاذ ، ويزيد من تلك الجمالية تلك الأمثال المستمدة من واقع الحياة ، والمناسبة لغرض النص ، تذكرها الكاتبة بين الفينة والأخرى .
وتتحدث الكاتبة في روايتها عن بعض العادات والتقاليد السلبية المتوارثة في حياتنا ، كنظرة الأسرة إلى الصبي وخاصة البكر ، تقول الكاتبة على لسان ام حسن : ” .. ربما لأنه البكر ، وللولد الاكبر دائما منزلة خاصة عند الأم ، لكنه فعلا أسوأ أولادي ..” ص ١٣٥ .. وقولها ايضا : ” .. كلهم رفضوها ، لعلهم كانوا يفضلون ميلاد ذكر ولو مات لساعته ” ص ١٤٠ .. كذلك التفاخر باقتناء الخادمات بقولها : ” كلكم يتشدّق بكلمة خادمتي ، خادمتي فعلت كذا وقالت كذا ..ونهرتها وأدّبتها ” ص١٤٨
ولاتنسى الكاتبة ان تربط الأدب بالواقع المعاش ، فتُضّمن الأحداث الاجتماعية في الرواية أحداثاً سياسية تعصف بالبلد ، جاءت عباراتها تلميحاً عن سياسة المستعمر الفرنسي في البلاد كتوثيق مهم ، تقول :” أبو عدنان وزوجته ، تطرقا إلى الأخبار والوضع السائد في البلاد حيث كثرت هذه الأيام الشائعات وما يتناقله الناس عن مصادقات وقعت بين الأهالي والسلطات الفرنسية وعن عدد المعتقلين الذي يزداد باستمرار ” ص١١٣ .. ثم الحديث عن مواكبة فرحة البلد لجلاء المستعمر الفرنسي عن ارضنا ، تقول : ” ثم أقبل اليوم المجيد يوم خرجت القوات الأجنبية نهائيا من بلادنا مشيعة باللعنات وبالبيض وبالبندورة تقذف في أثر الجنود وهم يركبون سياراتهم الضخمة مغادرين المدينة إلى غير رجعة ” ص١٥٠
أما عن موقف الكاتبة تجاه العادات السلبية فإنها تعبر عن رفضها لها ، ولا تتوانى عن ذكرها والحديث عنها ، كحرمان الفتاة من التعليم ومن الخروج من البيت إلا برفقة والدتها او أخيها ، تقول : ” أم حسن قاسية مع ابنتيها ، لاتسمح لهما بمغادرة البيت إلا نادرا برفقتها أو برفقة من تثق بهن من بنات العائلة ، كانت نوال أحيانا ، ولفرط تشوقها للدراسة وشعورها بالقهر لحرمانها منها ، تمر ظهرا أمام مدرستها القديمة، وتحت إبطها بضعة كتب تختلط بأفواج التلميذات الخارجات منها ، تسير معهن بضعة أمتار، موحية لنفسها أنها منهن ، ثم تعود إلى المنزل ..” ص ١٧٧ .. كذلك تعبر الكاتبة على لسان شخصية ام حسن رفضها ارتداء ابنتها القصير ، تقول : ” أنا لستُ أماً رجعية كما تظنين ، أريدك أن تكوني فتاة عصرية وإلا لما وافقتُ على دراستك في بيروت ، ولكن لكل شيء حدود ، ولا أريدك أن تتجاوزيها أبداً ، ليس من مظاهر الحشمة ولا الفضيلة لبس هذه الأشياء الصغيرة التي تسمونها ثياباً …” ص ٢٦٩
تعرضُ الكاتبة الصورة كاملة بإيجابياتها وسلبياتها ، من خلال صورة معاملة الفتاة المؤجرة ، فهي صورة سلبية أحيانا ، كما هي في شخصية ” زهرة ” التي عُوملت بقسوة من قبل سيدتها أم حسن ، تقول الكاتبة : ” صارت زهرة تجيب على كل نداء تطلقه أم حسن حتى لو كان لايخصها ، خوفا من التقريع والضرب ، كانت السيدة حالما ترجع من زيارتها تخلع حليها ، وتعيدها إلى مكانها في الدرج السريّ ، تترك جوربها وحذاءها لإحدى الخادمتين التي يتوجب عليها غسل الأول فورا ، ومسح وتنظيف الثاني وإعادته إلى مكانه المخصص له في أسفل دولاب الملابس ” ص٩٦ .. توضح الكاتبة بمكان آخر من الرواية وجود فكر مستنير متعلم يرفض الذل والهوان . تقول الكاتبة على لسان ابن أم حسن : ” ليتكِ يا أمي تبدّلين هذه الطريقة ! كم أتمنى أن أعود يوماً فأرى البيت خاليا من الغرباء ! ماذا لو استغنيت ِ عن شراء الخادمات ، تستطيعين أن تكتفي كخالتي بمن يساعدك من الجارات ، ما تسمينه انتِ شراء الخادمات ، تسميه الكتب الرقيق الأبيض ، وتدعو إلى إلغائه .. وآن لنا أن ننتهي منه …” ص ٩٩ .
وهناك نموذج آخر تعرضه الكاتبة شومان بإيجابية ، حيث تبيّنُ معاملة الفتاة المؤجرة ، تقول الكاتبة على لسان أم رفيق تخاطب عيشة : ” قلتُ : لا .. يعني لا …كنتِ مساء تعبة فلا داعي لتعبكِ هذا الصباح .. مريم صبية وقوية ، وكذلك أم فؤاد ، إذا شعرتِ بالنشاط أمكنكِ أن تنشري الغسيل ، وإذا بقيتِ تعاني أي إزعاج فوديعة تنشره ” ص١٠٦ .. وفي موضع آخر تبدو عاطفة أم رفيق نحو عيشة : ” كانت تعلم أنها لا تهتم بنفسها ، فأصبحت تحيطها بعناية خاصة ، تراقب أكلها ، تحرص على تناولها وجبات مغذية ” ص ١٠٧ ..
ومن الصور الجميلة في مقارنة الكاتبة بين طبقتي الفقر والغنى ، حيث يبدو المونولوج في سدة روعته عندما قارنت الكاتبة بين ولادة الخادمة وولادة السيدة ، وذلك على لسان أمي هاجر التي ساعدت ” نهوة ” في ولادتها ، تقول : ” الأمثال لا تكذب ، إنها حصاد سنين وسنين وخبرة أجيال ، واحد ابن الست والآخر ابن الجارية ، مسكينة هذه الجارية ، حساء الدجاج وقْف على الوالدات الشرعيات هن الضروريات ..أما ” نهوه” فمن يفكر فيها ؟ إنها ليست والدة شرعية ، إنها زانية مطرودة من الرحمة …” ص ١٥٦ .
وتظهر مقارنة هذه الثنائية المؤلمة ” الفقر والغنى ” على لسان ” نسّوم ” وهي ترتدي ثوب وداد الأحمر ، تقول الكاتبة : ” ليته كان لها ، لتركت حين تلبسه شعرها محلولا ، ينسدل على كتفيها ، لن تربطه كما تنصّ التعليمات ، كانت ولاريب ، ستبدو أجمل من وداد وهدى أيضا ، ولكن لتعاستها ولدت في بيئة فقيرة وليست الآن أكثر من خادمة في هذا البيت ” ص ١٢٦ ..
ومن صور الرحمة والعطف معاملة ام عدنان لنسّوم بلطف وحنان ، تقول الكاتبة : ” فنسيمة بنت مسكينة ، اشتهت أن تقيس هذا الثوب ، ولا بأس أن نسامحها هذه المرة ، المسامح كريم ” ص ١٢٧ .. أما عن القسوة في معاملة الفتاة المؤجرة فتبدو لدى ام خليل لخادمتها امون تقول الكاتبة : ” شكّت أم خليل من قذارة أمون ، قالت إنها كانت تتبّول في فراشها ، ثم أقلعت عن ذلك حين عرفت كيف تعالجها ، صاحت أم رفيق باستنكار : كويتها بقضيب حامي ؟ أمعقول هذا ؟ حرامٌ عليكِ . كانت هي الطريقة الناجعة . نبهتها أول الأمر ثم وبختها ، ثم هددّتها فلم ترعوِ . كنتُ أفتتح صبحيتي بمنظرها غارقة في البول ، ولما جرّبتُ معها الكيّ لم تحتج إلا لمرات معدودة ، ثم تابت ، وشفيت ” ص١٧٤ .
أما عن التراث اللامادي في رواية ( خطى كتبت علينا ) لناديا شومان فهو يبدو جليا واضحا وبغزارة .. فيه الألفة والمودة والمحبة بين القلوب المجتمعة على أدائه .. سأوردهُ من خلال الصور التي عبّرت عنها الكاتبة بحميمية وعذوبة ..
الصورة الأولى ؛ تبدو من خلال احترام الأخت الكبرى واستشارتها والأخذ برأيها ، تقول الكاتبة على لسان أبي عدنان وأخته هدى : ” اتفقنا أنا وأبو عدنان على السهر عندكم لنستشيركم في أمر خطبة هدى ، تعرفين أخاكِ ، لا يبتُ برأي دون مشورتكِ ، فأنتِ الكبيرة وأنتِ فعلا كبيرة في كل شيء “ص ١٧١ .
الصورة الثانية ، التضحية ؛ تظهر في تضحية ” كلير ” التي أصيبت بالعمى ، تقول : ” لا ريب أن الله اصطفاني لأمور أجلّ من الزواج ، أصيبت أمي بالشلل، فقمتُ على خدمتها ، ثم توفيت وأنا لا أزال حتى الآن مسؤولة عن أبي وأخوتي والبيت ” ص١٩٩ .
ومن الصور تقاليد العرس في القرية وإيحاءات الفرح والمحبة والسعادة بين الناس ، تقول الكاتبة : ” تزوجت نسوم وكالعادة كان الحفل مختلطا ، لعمري أنّ أعراس القرية أكثر رقياً من الناحية الاجتماعية من أعراس المدينة ، التي تقتصر على النساء ! رقصَ الصبايا والشباب وغنوا الأغاني الريفية الحلوة، وتألقت الثياب الموردة الملونة ، أركبوها على حصان والدها الأصهب ذي القمرة البيضاء في جبينه ، فسار يتبغدد بها وسط الزغاريد ، حتى وصل علي ، فأنزلها عنه وكشف النقاب عن وجهها ، وعلا التصفيق والهتاف ” ص٢٢٣ .
ومن الصور أيضا ، تقاليد الخطبة في المدينة ؛ تقول : ” في الصباح _ كما هي العادة _ أرسلت أم رفيق بعضا من علب الحلويات من مختلف الأنواع إلى أهل الخطيب ، فجاء الرد حالا : أسورة عريضة من الذهب ” ص١٩٠ .
ومن جميل الصور اللامادية التي عرضتها الكاتبة ايضا : اهتمام العائلة بطبخ الصابون وكأنه عيد أو احتفال مميز ص١١٥ .. كذلك خوف الجميع لدى حصول مكروه لأحد أفراد العائلة ، تقول : ” أسرعَ الجميع في أثر طاهر ليطمئنوا عليه ، كان الجدّ أشدهم خوفاً وجزعاً على حفيده ، خشي أن يكون الصابون الحار قد سبّب له ألماً أو حروقاً …” ص ١١٧ ..
صنع العائلة للشعيرية ولماء الزهر والتبغ ..تقول الكاتبة : ” في الصيف ، أيام النهارات الطويلة والوقت الملائم لإعداد المؤونة تكون أم فؤاد حاضرة دوما ، كانت مشهورة بخفتها وبراعتها في فتّ الشعيرية ، تجتمع الجارات ، تعجن أم فؤاد ، تقطع العجين قطعاً صغيرةً ، تأخذ كلّ واحدة قطعةً تفتلها بين راحتيها بتأنٍ حتى تستطيل وتصبح حبلاً رفيعاً ، عندئذ تبرم طرفيها من الإبهام والسبابة ، وتقطعها حبات صغيرة متساوية كحبات الشعير ” ص ١٠٤ ..
حسنُ التدبير في لباس الأولاد : تقول الكاتبة : ” …وأنّ حُسنَ التصرف يقتضي أن تكون الثياب الجديدة للأكبر ، ثم يأخذها أخوه في السنة المقبلة بشرط أن تكون محتفظة بشيء من رونقها ، أما إذا حدث أنها لم تعد كذلك فلا بأس أن يشتروا للصغير شيئاً جديداً ” ص ١٠٨ .. كما كان رأيها أيضا أن تكون ملابس الأولاد أكبر من مقاسهم نظرا لنموهم السريع ” ص ١٠٩ ..
عادة حمل الطفل الصغير على الظهر لدى صيامه يوماً كاملاً : تقول الكاتبة : ” لا تاتا .. أنا ثقيل لاتستطيعين حملي . بل اركب .. عندما يصوم الطفل أول مرة حمله يشفي وجع الظهر .. حمَلته على ظهرها ، رغم ممانعتها ودارت به عدة أشواط في باحة البيت ، وأعدّت له من الطعام ما يشتهي ، وقالت له : عندما تكبر ستصوم مثلنا جميعا ” ص٨٥ ..
تقبيل الأيدي : تقول الكاتبة : ” وجدنا الأولاد بانتظارهم وقد ارتدوا ملابسهم الجديدة ، تسابقوا إلى تقبيل الأيدي مرددين تحية العيد التقليدية ( كل عام وأنتم بخير ) ، ثم جلسوا بأدب بانتظار العيدية ” ص٨٧ ..
صورة العيد كتذكار ، تقول الكاتبة : ” صورة العيد الماضي أخذتها _ أنا _ لهم كانت على الأريكة عينها ، نفس الوجوه ونفس الأقدام البيضاء المتلاصقة ، الشيء
الوحيد الذي تغير هو وجه السنة المنقضية .. هل يمكن التقاط صور لسنين ؟ ” ص٨٨ ..
تقاليد الطعام : تقول الكاتبة : ” وبعد الطعام القهوة ، ومن ثم ضيافة العيد ، يغرف كل واحد غرفة بيده من السكاكر والملبس والشوكولا يدّسها في جيبه شاكرا ” ص٨٨ ..
طقوس العيد ” الطبّال” ، تقول الكاتبة : ” وكلما كان الأجر أكبر كان المديح أكثر ، يقبض ما يتيسر ثم يدخل بيتاً آخر ، كانت معظم البيوت تضم أطفالا ولكن إذا حدث ودخل أحدهم بيتاً لا أطفال فيه أو أصحابه في حداد فكلمة : ” نحن لا نعيّد ” أو ليس لنا أولاد تكفي لينسحب حالاً ، ويختفي دون أية ضجة ” . ص٩٠ ..
الحب والحنان لدى ربة البيت ، تقول الكاتبة : ” تناول الأحفاد الطعام على مائدة خاصة ، وأشرفت الأمهات من بعيد على ذلك ، وكانت الجدة تتنّقل بينهم لتتأكد من أنّ الجميع أكل بمقدار ما يستطيع ويزيد ، إذ إنّ المحبة والعطف والحنو يُقاس بمقدار ما تبتلعه بطون الصغار ، لا تفتأ تسأل : هل شبعت حبيبي ؟ أتريد مزيدا من الأرز واللحم ؟ حبيبتي لم تأكلي حلوى ؟ .. أنتَ ياغالي هل أعطيكَ شيئا من اللبن ؟ ” ص٩٠ ..
تفاؤل الكاتبة دليل على حبها للحياة .. هكذا كانت خاتمة روايتها ..
( قبل أن يشرق النهار ، كانت أم حسن قد ودّعت الحياة ، ورغم أنّ الحزن الذي كان يخيم على العرافة ، كانت جوقة العصافير في الخارج تغني لميلاد يوم جديد ) ص٢٨٠
كحبة الحنطة التي لا يمكن أن تفرّع آلاف السنابل والحبوب مالم تُدفن في باطن الأرض .
بقلم رولا علي سلوم .مان )
ناديا شومان .. روائية ومترجمة لاذقانية ، قارئة شغوفة باللغتين العربية والفرنسية ، نالت عن روايتها ( خطى كتبت علينا) جائزة خير الدين الأسدي لعام ٢٠٢٠م
جرأتها في طرح فكرة مضى عليها الدهر بعيدا ، إذ عالجت في روايتها استخدام فتيات من الريف كخادمات مؤجرات لبعض الأسر الثرية في المدن ..
أعرض قراءتي المتواضعة لهذه الرواية الجميلة .. وكمقدمة أذكر عبارتي وهي من وحي ما قراته :
( ناديا شومان زهرة تفتحت، فلامس عطرها أرواحنا العطشى ) ..
تبدأ الكاتبة روايتها بمشهد مؤثر، مخاض ” فهيمة” ، ومعاناتها القاسية في وضع مولودها، تساعدها والدتها في البداية ، عبثا من غير فائدة، لثلاثة أيام تعاني مخاضاً صعباً عسيراً ، تصوير دقيق تحاول الأم والنسوة فيه مساعدة “فهيمة”، لكنّ القدر أقوى .
مشهد جميل جدا من حيث التفاصيل الدقيقة التي ذكرتها الكاتبة، والحالات الشعورية الحسية التي تكاد تلامس أرواحنا . تصف الكاتبة معاناة الناس ؛الفقر الجوع ،البيئة، الجهل ، قلة الحيلة ، الموت … كلها
ساهمت في جعل فهيمة تعاني، ثم تُسلِم الروح .
و( الأمراض _ كما تقول الكاتبة _ على أنواعها تشفيها قطعة من البطيخ الأحمر أو جرعة زيت، أو بعض حشائش مغلية، والأورام تُداوى بالكي ) ص١٠ .. هي ذي مساحة العقل والفكر في القرية .
يحاول أخ ” فهيمة” شق بطن أخته لإخراج المولود ، لكنّ زوجها يمنعه قائلاً : ( لا لن تمسها ، ما نفع الولد بعد أن ماتت الأم ، لا ريب أنها ابنة خامسة ، لتدفن مع أمها فذلك خير لها ، وعلت أصوات : لا ..لا يجوز لحرمة الميت أن تُنتهك ..أبداً ، وقالت أصوات أخرى : يا للعار .. أيطلع الرجال على جسد المرأة بعد الموت؟ أفضل لهذا الجنين أن يُقبرَ مع أمه ) ص١١
وبطريقة غير مباشرة تصف الكاتبة ” فهيمة” ، من خلال تذكر الزوج بشير لها : ( صبورة تساعده في العمل ، تهتم بالبيت ، غير متطلبة ، تكنس .. تعجن .. تخبز ..)
كثيرة هي الأحداث التي تتراوح بين المد والجزر ، بين اللين والقسوة ، الزوج القاسي والزوجة المحبة المعطاء ..تقول الكاتبة : ( أما هو فيلومها بعنف ويشتمها لا لشيء إلا لكونه تعباً ، فتصمت.. وقد تردّ عليه أحياناً بكلمة ، فينهال عليها ضربا، ويغادر البيت وهي لاتزال تبكي ، ويعود عند هبوط الظلام فإذا هي قد نسيت كل شيء ، وعلى استعداد لتلبية كلّ رغائبه ..
لقد أنجبت أربع بنات .. ماذا كانت أسماؤهن ؟ لقد نسي ، آه ، زهرة ومريم ونسيمة وفتنة ) ص١٥
تبدو حسرة الأب على موت زوجته ، والطفل الذي قد يكون دُفن معها صبياً ذكراً ، ثم موت ابنتيه زهرة ومريم ؛ زهرة وقعت في البئر ، ومريم ماتت بالحمى ، وبقيت نسيمة وفتنة ، تحملتا مسؤولية البيت، فقدتا الأم ، الحضن الدافئ ، تقول الكاتبة : ( فهيمة ماتت ، قتلها حملها الأخير، أيكون ذكراً هذا الطفل الذي مات دون إنجابه ؟ كان بمقدوره أن يعطيه لأخته تربيه مع أولادها ، ثم يكبر ويصبح شابا يساعده في العمل .) ص ١٧ هذه هي نظرة المجتمع للذكر ؛ نظرة ملؤها الحب والتعلق والرغبة الكبيرة …
تصف الكاتبة حال الزوج ” بشير “.. وهو يفكر بالزواج ،واختياره ل ” مسعودة “،رغم أنه لم يمضِ على وفاة ” فهيمة ” سوى أربع وعشرون ساعة ، نشعر بحوار بشير مع ذاته ، المونولوج الداخلي كثيرا ما تلجأ إليه الكاتبة ” ناديا شومان ” ، فهو يمنح النص حميمية كبيرة ، ودفئاً خاصاً ، حوار الذات وطرح الأسئلة والأجوبة …
تصف الكاتبة العمل المتعب المرهق في الأرض كزراعة التبغ ،تقول : ( أنجز شك صف طويل من الأوراق الخضراء بخيط ثخين من القنب، شعر بالجوع ، فاتجه
ناحية العين ، وتناول من الأرض قبضة من التراب ، فرك بها يديه جيدا ،فاتجه وعاد إلى مكانه ، فتناول من صرته رغيفا وبصلة كبيرة ، نزع رأسها بفمه ، ثم وضعها على حجر وضربها بقبضتيه ، فانسحقت ، وبرزت منها بصلة صغيرة بيضاء تلوثت بالتراب ، مسحها بيده ونزع قشرتها الخارجية وبدأ فطوره. ) ص١٨
وصفت الكاتبة حياة المعاناة والفقر من خلال خلو بيت بشير من الأثاث ومن الطعام ومن المصابيح، ومن أبسط متطلبات الحياة .. تتوالى الأحداث بعد موت فهيمة ، ورغم ذلك لايتوانى الزوج عن التفكير بالزواج من مسعودة ، يقارن بينها وبين زوجته الراحلة ،ويتمنى لو توافق على الارتباط به ، فهو سيلبي لها كل ماتطلبه ..تقول الكاتبة : ” أقبل الربيع وتفتحت في الأرض ملايين الزهور الصغيرة، وملأت البراعم الأشجار، وخرجت القطعان بعد حبس طويل لها إلى المراعي، وكثرت السواقي وفاضت الينابيع والعيون ، واقترب زفاف بشير ومسعودة ..” ص٣٥ . مقاربة جميلة في لغة الكاتبة بين مجيء الربيع وزفاف بشير ومسعودة .
يتم الزواج بينهما ، ويظهر دلال بشير لمسعودة ، وخاصة بعد أن ولدت له حسن، ثم تبدو معاملة مسعودة القاسية للفتاتين نسيمة وفتنة وإرهاقهما بالعمل … إلى ان تدخلت أم فهيمة وطلبت من أبي علي والد مسعودة
الرأفة بالبنتين ، فلبّت طلب والدها إلى أن مات .
في لغة الكاتبة تلك المسحة الإنسانية العذبة الشفيفة، والتي تبدو جلية بين ثنايا الكلمات والحروف .. وتلك الصور الفنية الرائعة المستمدة من عفوية الطبيعة وبراءة البيئة التي تعيشها … كثيرة هي مواقف الحزن الشفيفة المؤثرة ، والتي تمتلئ بها الرواية .. حقاً إنّ الحزن الشفيف ينقي الوجع ويصّفيه ويجلوه، ليصبح أكثر صفاء وروعة ونقاء وعذوبة…
اتسمت الكاتبة ” ناديا شومان ” في روايتها ” خطى كتبت علينا ” بسمات عدة وهي ، الجرأة ، والنفَس الطويل ، إضافة إلى الذائقة الأدبية الجميلة جدا، لاسيما عند الحديث عن التقاليد والعادات والموروثات وجماليات الطبيعة والبيئة ..
الجرأة ؛ تبدو من خلال طرح الكاتبة موضوعا حساسا ، وهو تأجير الفتيات من الأرياف بعمر صغير للعمل في الخدمة في بيوت الأثرياء والموسرين في المدينة. لقد احتل هذا الموضوع مساحة الرواية بأكملها ، فهو الموضوع الرئيس ، عالجت الكاتبة من خلاله صور التناقض بين الريف والمدينة ، بين الغنى والفقر ، بين العلم والجهل ، بين الحب والكره ، بين اللين والقسوة .. ثنائيات ضمنّتها الكاتبة أحداث روايتها ، إنها مشاعر إنسانية تتواجد في كل مكان وزمان ، ولعل السبب في
وجود تلك الظاهرة هو الفقر المدقع بالدرجة الأولى، فتأجير الفتاة لمدة معينة مقابل مبلغ من المال ، يخفف على الأب عبء مصروفها ، ثم إنه يستفيد مما يقبضه من مال لتحسين وضعه المعيشي ، إضافة إلى عوامل أخرى ؛ كرفض الخالة زوج الأب احتواء البنات . حتى بشير الذي كان قد استهجن هذا التصرف قبِلَ به في النهاية ، تقول الكاتبة : ” وكيف استطاع هؤلاء الأجلاف أن يؤجروا بناتهم ليخدمن في منازل أهل المدينة ” ص ١٨ . وهؤلاء الفتيات اللواتي خُلقن في تلك البيئة الفقيرة، كان قدرهن أن يخطون نحو قدرهن في المدينة ، وكل فتاة وما تحظى به ؛ إما عائلة رحيمة كريمة، أو عائلة قاسية بخيلة ، ولم تنسى الكاتبة شومان ان توضح آثار تلك الظاهرة ، كما بينت أسبابها ، فهي وإن كانت تعلّم الفتاة أعمال البيت والطبخ والتنظيف والحياة الاجتماعية ، لكنها كانت تسبغ مشاعر القهر والظلم والألم والذل والشوق والحنين إلى البيت الأول بيت عائلتها . اختيار موفق من الكاتبة في الحديث عن هذه الفكرة ومعالجتها .. لاسيما أنّ الفتاة لازالت في مجتمعنا الشرقي تعاني من التفرقة والتمييز بينها وبين الرجل ..
نسّوم وفتنة شخصيتان بدأت بهما روايتها ؛ حيث ماتت الأم ” فهيمة” إثر مخاض صعب بعد خمس ولادات كلهن بنات ، لم تستطع القابلة إنقاذها بسبب الجهل والفقر ،
ولم تردع الزوج في التفكير بأخرى، لاسيما أنه كان ينتظر مولوده الذكر ولم يتحقق، وخوفه من ان يكون المولود أنثى هو الذي دفعه لدفن الأم ومولودها الحي في رحمها من غير أن يتجرأ أحد على شق بطنها لاستخراج المولود .. هي ذي قسوة البشر فوق قسوة القدر …
ثم تبدأ رحلة نسوم وفتنة بعد رفض الخالة زوج الأب لهما، تبدأ رحلتهما الشاقة في المدينة، وفِقت ” نسوم” حيث أخفقت ” فتنة ” ، وما تفرع من قرينات لهن في العمر كان قدرهن أشد وأقسى ، ” نهوة ” كذب عليها حسن وأغراها بالزواج ، و ” زهرة ” لم يُعرف مصيرها ، و” عيشة ” ماتت بمشفى بعيد عن الأهل بمرض السل …
أما السمة الثانية لدى الكاتبة ” ناديا شومان ” فهي : النفس الطويل .. فبعد أن تضع المحاور الأساسية للرواية والخطوط العريضة التي تسير وفقها ، نراها تُشعّب الخطوط ، وتفرّع الأحداث، وتولّد من الشخصيات شخصيات تكاد تكون حقيقية ، نشعر ونحسّ بوجودها، كأنها تكلمنا وتشكو لنا آلامها وأحزانها ، هذا التماهي في الشعور بين الشخصية المتخيلة في الذاكرة وعلى الورق وبين الشخصية المتكونة من لحم ودم ونفس وروح ، وتلك مزيةٌ في أسلوب الكاتبة ، ألا وهو قدرتها على جعل الشخصيات حيوية نابضة بالحياة ، وذلك لا يتأتى عن عبث، بل؛ عن قدرة كبيرة ورؤية جمالية قادرة على تحريك الشخصيات بعفوية وصدق وروعة …ومما يؤكد على هذا النفس الطويل لدى الكاتبة هو خوضها في جزئيات وتفاصيل صغيرة جدا جدا ، تضفي عليها صفة الإنسانية الشفيفة، ففي كل تفصيل مسحة إنسانية شفافة ، هو مايجعل القارئ ينجذب لأحداث الرواية ويتفاعل معها ، ويقرأ الرواية بشغف من غير توقف .
ومما يجعل النص نابضاً بالحياة كثرة الأفعال في الرواية، والتي تدل على التجدد والحيوية ، وعلى الحركة والانفعال .. إضافة إلى تطعيم النص ببعض العبارات من البيئة المعاشة لإضفاء صبغة الواقعية ، فهي تسترسل في اختيار موجودات عذبة جميلة كحديثها عن الحبق وزهر الليمون وصنع ماء الزهر … ثم حديثها عن العادات والتقاليد في العيد ، وعن زراعة التبغ ومافيه من صعوبة بالغة، وحالة الدبق التي إن ألّمت بالزرع انتهى المحصول ، هي ذي ثقافة الكاتبة تساعد على خوضها في الحديث عن تلك التفاصيل التي ربما لا يعرفها سوى المتخصصون في ذلك كالفلاحين مثلا …
أما عن تقديمها لشخصيات روايتها ؛ فهي تتحدث عن الشخصية في الرواية من غير أن تقدّم كل شيء عنها
دفعة واحدة ، بل تترك لخيال القارئ أن يتشوق لمعرفة المزيد ، فنرى ذلك يبدو بعد فصل واكثر ، عندما تعود الكاتبة بالخلف خطفاً ، وتستذكر تلك الشخصية وتكمل ما بدأته عنها، إنّه أسلوب التشويق والجذب ، وكل ذلك بلغة جميلة معبرة واضحة، مليئة بالمفردات ذات الوقع العذب على الأذن ، فليس من كلمات نابية عن الذوق ، بل إنها تتذوق اختيار المفردات بشكل آخاذ ، ويزيد من تلك الجمالية تلك الأمثال المستمدة من واقع الحياة ، والمناسبة لغرض النص ، تذكرها الكاتبة بين الفينة والأخرى .
وتتحدث الكاتبة في روايتها عن بعض العادات والتقاليد السلبية المتوارثة في حياتنا ، كنظرة الأسرة إلى الصبي وخاصة البكر ، تقول الكاتبة على لسان ام حسن : ” .. ربما لأنه البكر ، وللولد الاكبر دائما منزلة خاصة عند الأم ، لكنه فعلا أسوأ أولادي ..” ص ١٣٥ .. وقولها ايضا : ” .. كلهم رفضوها ، لعلهم كانوا يفضلون ميلاد ذكر ولو مات لساعته ” ص ١٤٠ .. كذلك التفاخر باقتناء الخادمات بقولها : ” كلكم يتشدّق بكلمة خادمتي ، خادمتي فعلت كذا وقالت كذا ..ونهرتها وأدّبتها ” ص١٤٨
ولاتنسى الكاتبة ان تربط الأدب بالواقع المعاش ، فتُضّمن الأحداث الاجتماعية في الرواية أحداثاً سياسية تعصف بالبلد ، جاءت عباراتها تلميحاً عن سياسة المستعمر الفرنسي في البلاد كتوثيق مهم ، تقول :” أبو عدنان وزوجته ، تطرقا إلى الأخبار والوضع السائد في البلاد حيث كثرت هذه الأيام الشائعات وما يتناقله الناس عن مصادقات وقعت بين الأهالي والسلطات الفرنسية وعن عدد المعتقلين الذي يزداد باستمرار ” ص١١٣ .. ثم الحديث عن مواكبة فرحة البلد لجلاء المستعمر الفرنسي عن ارضنا ، تقول : ” ثم أقبل اليوم المجيد يوم خرجت القوات الأجنبية نهائيا من بلادنا مشيعة باللعنات وبالبيض وبالبندورة تقذف في أثر الجنود وهم يركبون سياراتهم الضخمة مغادرين المدينة إلى غير رجعة ” ص١٥٠
أما عن موقف الكاتبة تجاه العادات السلبية فإنها تعبر عن رفضها لها ، ولا تتوانى عن ذكرها والحديث عنها ، كحرمان الفتاة من التعليم ومن الخروج من البيت إلا برفقة والدتها او أخيها ، تقول : ” أم حسن قاسية مع ابنتيها ، لاتسمح لهما بمغادرة البيت إلا نادرا برفقتها أو برفقة من تثق بهن من بنات العائلة ، كانت نوال أحيانا ، ولفرط تشوقها للدراسة وشعورها بالقهر لحرمانها منها ، تمر ظهرا أمام مدرستها القديمة، وتحت إبطها بضعة كتب تختلط بأفواج التلميذات الخارجات منها ، تسير معهن بضعة أمتار، موحية لنفسها أنها منهن ، ثم تعود إلى المنزل ..” ص ١٧٧ .. كذلك تعبر الكاتبة على لسان شخصية ام حسن رفضها ارتداء ابنتها القصير ، تقول : ” أنا لستُ أماً رجعية كما تظنين ، أريدك أن تكوني فتاة عصرية وإلا لما وافقتُ على دراستك في بيروت ، ولكن لكل شيء حدود ، ولا أريدك أن تتجاوزيها أبداً ، ليس من مظاهر الحشمة ولا الفضيلة لبس هذه الأشياء الصغيرة التي تسمونها ثياباً …” ص ٢٦٩
تعرضُ الكاتبة الصورة كاملة بإيجابياتها وسلبياتها ، من خلال صورة معاملة الفتاة المؤجرة ، فهي صورة سلبية أحيانا ، كما هي في شخصية ” زهرة ” التي عُوملت بقسوة من قبل سيدتها أم حسن ، تقول الكاتبة : ” صارت زهرة تجيب على كل نداء تطلقه أم حسن حتى لو كان لايخصها ، خوفا من التقريع والضرب ، كانت السيدة حالما ترجع من زيارتها تخلع حليها ، وتعيدها إلى مكانها في الدرج السريّ ، تترك جوربها وحذاءها لإحدى الخادمتين التي يتوجب عليها غسل الأول فورا ، ومسح وتنظيف الثاني وإعادته إلى مكانه المخصص له في أسفل دولاب الملابس ” ص٩٦ .. توضح الكاتبة بمكان آخر من الرواية وجود فكر مستنير متعلم يرفض الذل والهوان . تقول الكاتبة على لسان ابن أم حسن : ” ليتكِ يا أمي تبدّلين هذه الطريقة ! كم أتمنى أن أعود يوماً فأرى البيت خاليا من الغرباء ! ماذا لو استغنيت ِ عن شراء الخادمات ، تستطيعين أن تكتفي كخالتي بمن يساعدك من الجارات ، ما تسمينه انتِ شراء الخادمات ، تسميه الكتب الرقيق الأبيض ، وتدعو إلى إلغائه .. وآن لنا أن ننتهي منه …” ص ٩٩ .
وهناك نموذج آخر تعرضه الكاتبة شومان بإيجابية ، حيث تبيّنُ معاملة الفتاة المؤجرة ، تقول الكاتبة على لسان أم رفيق تخاطب عيشة : ” قلتُ : لا .. يعني لا …كنتِ مساء تعبة فلا داعي لتعبكِ هذا الصباح .. مريم صبية وقوية ، وكذلك أم فؤاد ، إذا شعرتِ بالنشاط أمكنكِ أن تنشري الغسيل ، وإذا بقيتِ تعاني أي إزعاج فوديعة تنشره ” ص١٠٦ .. وفي موضع آخر تبدو عاطفة أم رفيق نحو عيشة : ” كانت تعلم أنها لا تهتم بنفسها ، فأصبحت تحيطها بعناية خاصة ، تراقب أكلها ، تحرص على تناولها وجبات مغذية ” ص ١٠٧ ..
ومن الصور الجميلة في مقارنة الكاتبة بين طبقتي الفقر والغنى ، حيث يبدو المونولوج في سدة روعته عندما قارنت الكاتبة بين ولادة الخادمة وولادة السيدة ، وذلك على لسان أمي هاجر التي ساعدت ” نهوة ” في ولادتها ، تقول : ” الأمثال لا تكذب ، إنها حصاد سنين وسنين وخبرة أجيال ، واحد ابن الست والآخر ابن الجارية ، مسكينة هذه الجارية ، حساء الدجاج وقْف على الوالدات الشرعيات هن الضروريات ..أما ” نهوه” فمن يفكر فيها ؟ إنها ليست والدة شرعية ، إنها زانية مطرودة من الرحمة …” ص ١٥٦ .
وتظهر مقارنة هذه الثنائية المؤلمة ” الفقر والغنى ” على لسان ” نسّوم ” وهي ترتدي ثوب وداد الأحمر ، تقول الكاتبة : ” ليته كان لها ، لتركت حين تلبسه شعرها محلولا ، ينسدل على كتفيها ، لن تربطه كما تنصّ التعليمات ، كانت ولاريب ، ستبدو أجمل من وداد وهدى أيضا ، ولكن لتعاستها ولدت في بيئة فقيرة وليست الآن أكثر من خادمة في هذا البيت ” ص ١٢٦ ..
ومن صور الرحمة والعطف معاملة ام عدنان لنسّوم بلطف وحنان ، تقول الكاتبة : ” فنسيمة بنت مسكينة ، اشتهت أن تقيس هذا الثوب ، ولا بأس أن نسامحها هذه المرة ، المسامح كريم ” ص ١٢٧ .. أما عن القسوة في معاملة الفتاة المؤجرة فتبدو لدى ام خليل لخادمتها امون تقول الكاتبة : ” شكّت أم خليل من قذارة أمون ، قالت إنها كانت تتبّول في فراشها ، ثم أقلعت عن ذلك حين عرفت كيف تعالجها ، صاحت أم رفيق باستنكار : كويتها بقضيب حامي ؟ أمعقول هذا ؟ حرامٌ عليكِ . كانت هي الطريقة الناجعة . نبهتها أول الأمر ثم وبختها ، ثم هددّتها فلم ترعوِ . كنتُ أفتتح صبحيتي بمنظرها غارقة في البول ، ولما جرّبتُ معها الكيّ لم تحتج إلا لمرات معدودة ، ثم تابت ، وشفيت ” ص١٧٤ .
أما عن التراث اللامادي في رواية ( خطى كتبت علينا ) لناديا شومان فهو يبدو جليا واضحا وبغزارة .. فيه الألفة والمودة والمحبة بين القلوب المجتمعة على أدائه .. سأوردهُ من خلال الصور التي عبّرت عنها الكاتبة بحميمية وعذوبة ..
الصورة الأولى ؛ تبدو من خلال احترام الأخت الكبرى واستشارتها والأخذ برأيها ، تقول الكاتبة على لسان أبي عدنان وأخته هدى : ” اتفقنا أنا وأبو عدنان على السهر عندكم لنستشيركم في أمر خطبة هدى ، تعرفين أخاكِ ، لا يبتُ برأي دون مشورتكِ ، فأنتِ الكبيرة وأنتِ فعلا كبيرة في كل شيء “ص ١٧١ .
الصورة الثانية ، التضحية ؛ تظهر في تضحية ” كلير ” التي أصيبت بالعمى ، تقول : ” لا ريب أن الله اصطفاني لأمور أجلّ من الزواج ، أصيبت أمي بالشلل، فقمتُ على خدمتها ، ثم توفيت وأنا لا أزال حتى الآن مسؤولة عن أبي وأخوتي والبيت ” ص١٩٩ .
ومن الصور تقاليد العرس في القرية وإيحاءات الفرح والمحبة والسعادة بين الناس ، تقول الكاتبة : ” تزوجت نسوم وكالعادة كان الحفل مختلطا ، لعمري أنّ أعراس القرية أكثر رقياً من الناحية الاجتماعية من أعراس المدينة ، التي تقتصر على النساء ! رقصَ الصبايا والشباب وغنوا الأغاني الريفية الحلوة، وتألقت الثياب الموردة الملونة ، أركبوها على حصان والدها الأصهب ذي القمرة البيضاء في جبينه ، فسار يتبغدد بها وسط الزغاريد ، حتى وصل علي ، فأنزلها عنه وكشف النقاب عن وجهها ، وعلا التصفيق والهتاف ” ص٢٢٣ .
ومن الصور أيضا ، تقاليد الخطبة في المدينة ؛ تقول : ” في الصباح _ كما هي العادة _ أرسلت أم رفيق بعضا من علب الحلويات من مختلف الأنواع إلى أهل الخطيب ، فجاء الرد حالا : أسورة عريضة من الذهب ” ص١٩٠ .
ومن جميل الصور اللامادية التي عرضتها الكاتبة ايضا : اهتمام العائلة بطبخ الصابون وكأنه عيد أو احتفال مميز ص١١٥ .. كذلك خوف الجميع لدى حصول مكروه لأحد أفراد العائلة ، تقول : ” أسرعَ الجميع في أثر طاهر ليطمئنوا عليه ، كان الجدّ أشدهم خوفاً وجزعاً على حفيده ، خشي أن يكون الصابون الحار قد سبّب له ألماً أو حروقاً …” ص ١١٧ ..
صنع العائلة للشعيرية ولماء الزهر والتبغ ..تقول الكاتبة : ” في الصيف ، أيام النهارات الطويلة والوقت الملائم لإعداد المؤونة تكون أم فؤاد حاضرة دوما ، كانت مشهورة بخفتها وبراعتها في فتّ الشعيرية ، تجتمع الجارات ، تعجن أم فؤاد ، تقطع العجين قطعاً صغيرةً ، تأخذ كلّ واحدة قطعةً تفتلها بين راحتيها بتأنٍ حتى تستطيل وتصبح حبلاً رفيعاً ، عندئذ تبرم طرفيها من الإبهام والسبابة ، وتقطعها حبات صغيرة متساوية كحبات الشعير ” ص ١٠٤ ..
حسنُ التدبير في لباس الأولاد : تقول الكاتبة : ” …وأنّ حُسنَ التصرف يقتضي أن تكون الثياب الجديدة للأكبر ، ثم يأخذها أخوه في السنة المقبلة بشرط أن تكون محتفظة بشيء من رونقها ، أما إذا حدث أنها لم تعد كذلك فلا بأس أن يشتروا للصغير شيئاً جديداً ” ص ١٠٨ .. كما كان رأيها أيضا أن تكون ملابس الأولاد أكبر من مقاسهم نظرا لنموهم السريع ” ص ١٠٩ ..
عادة حمل الطفل الصغير على الظهر لدى صيامه يوماً كاملاً : تقول الكاتبة : ” لا تاتا .. أنا ثقيل لاتستطيعين حملي . بل اركب .. عندما يصوم الطفل أول مرة حمله يشفي وجع الظهر .. حمَلته على ظهرها ، رغم ممانعتها ودارت به عدة أشواط في باحة البيت ، وأعدّت له من الطعام ما يشتهي ، وقالت له : عندما تكبر ستصوم مثلنا جميعا ” ص٨٥ ..
تقبيل الأيدي : تقول الكاتبة : ” وجدنا الأولاد بانتظارهم وقد ارتدوا ملابسهم الجديدة ، تسابقوا إلى تقبيل الأيدي مرددين تحية العيد التقليدية ( كل عام وأنتم بخير ) ، ثم جلسوا بأدب بانتظار العيدية ” ص٨٧ ..
صورة العيد كتذكار ، تقول الكاتبة : ” صورة العيد الماضي أخذتها _ أنا _ لهم كانت على الأريكة عينها ، نفس الوجوه ونفس الأقدام البيضاء المتلاصقة ، الشيء
الوحيد الذي تغير هو وجه السنة المنقضية .. هل يمكن التقاط صور لسنين ؟ ” ص٨٨ ..
تقاليد الطعام : تقول الكاتبة : ” وبعد الطعام القهوة ، ومن ثم ضيافة العيد ، يغرف كل واحد غرفة بيده من السكاكر والملبس والشوكولا يدّسها في جيبه شاكرا ” ص٨٨ ..
طقوس العيد ” الطبّال” ، تقول الكاتبة : ” وكلما كان الأجر أكبر كان المديح أكثر ، يقبض ما يتيسر ثم يدخل بيتاً آخر ، كانت معظم البيوت تضم أطفالا ولكن إذا حدث ودخل أحدهم بيتاً لا أطفال فيه أو أصحابه في حداد فكلمة : ” نحن لا نعيّد ” أو ليس لنا أولاد تكفي لينسحب حالاً ، ويختفي دون أية ضجة ” . ص٩٠ ..
الحب والحنان لدى ربة البيت ، تقول الكاتبة : ” تناول الأحفاد الطعام على مائدة خاصة ، وأشرفت الأمهات من بعيد على ذلك ، وكانت الجدة تتنّقل بينهم لتتأكد من أنّ الجميع أكل بمقدار ما يستطيع ويزيد ، إذ إنّ المحبة والعطف والحنو يُقاس بمقدار ما تبتلعه بطون الصغار ، لا تفتأ تسأل : هل شبعت حبيبي ؟ أتريد مزيدا من الأرز واللحم ؟ حبيبتي لم تأكلي حلوى ؟ .. أنتَ ياغالي هل أعطيكَ شيئا من اللبن ؟ ” ص٩٠ ..
تفاؤل الكاتبة دليل على حبها للحياة .. هكذا كانت خاتمة روايتها ..
( قبل أن يشرق النهار ، كانت أم حسن قد ودّعت الحياة ، ورغم أنّ الحزن الذي كان يخيم على العرافة ، كانت جوقة العصافير في الخارج تغني لميلاد يوم جديد ) ص٢٨٠
كحبة الحنطة التي لا يمكن أن تفرّع آلاف السنابل والحبوب مالم تُدفن في باطن الأرض .
بقلم رولا علي سلوم .٩



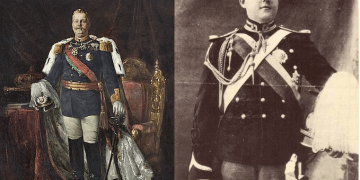






Discussion about this post