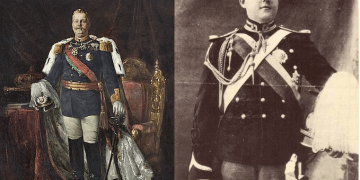التَصوُّف ..
(الحلاج) نموذجاً ..
د.علي أحمد جديد
التصوّف ، حالةٌ من نمطين مختلفين في إطار مفهومين متناقضين كلياً .
فالمفهوم الأول للتصوّف يعني الإيمان المطلق بوجود إلهٍ يتجاوز الكون المخلوق بكل مافيه من الإنسان والطبيعة بثنائياتها المعروفة (سماء و أرض ، إله خالق وإنسان مخلوق ، خير و شر ، ليل ونهار ) .. وهكذا . وتتجسد حالة التصوّف هذه في تدريبات المتصوّف لكبح جماح الجسد والغرائز تعبيراً عن شفافية العلاقة وطٌهرِها مع الخالق في محاولة التقرّب منه ، ومع القناعة الكاملة والتامة باستحالة التوحد مع الإله ، لأن الحلول الإلهي يتنافى مع الإيمان التوحيدي ، ولأن التعبير عن محبة الإله لا يكون إلا في الالتزام بقيم الخير المُطلَقة للعمل على إصلاح الدنيا .
أما المفهوم الثاني للتصوّف فهو كما تعبِّر عنه نظرية (القَبَّالَة اليهودية) الذي يتجسّد ضمن إطار حلولية الإله في الإنسان وفي الطبيعة ، وكذلك في أيٍّ من المخلوقات ، كما هو الحال في الديانات الهندية المتعددة اليوم والتي تتوجه في عباداتها إلى المخلوقات (بقرة ، قرد ، هرة ، ..) وغيرها للاعتقاد بأن الإله يحِلُّ فيها ويتوحّد معها حتى يصبح أن لا وجود للإله خارجها . ويتم اختزال الواقع كله إلى مستوى هذا الحلول التَوَحدي (وليس التوحيدي) وخاصة بتوحّد الإله مع الإنسان المتصوّف الذي يدّعي معرفة الذات الإلهية التي تحل فيه ، فيأخذ التصوّف شكل التفسيرات الباطنية بكتابة التمائم والتعاويذ التي يوحي بها المتصوِّف بأن لها التأثير في الحدِّ من الإرادة الإلهية ، وتمنع الضرر حتى ولو كان بقَدَرٍ إلهي ، كما تستجلب الخير . وغالباً ما يأخذ هذا التصوّف شكل الزهد الذي لايهدف إلى تطويع النفس ، بل إلى الوصول للإله والتوحّد فيه ليكون المتصوّف عارِفاً بالأسرار الإلهية (غنوصياً) ، ويصبح هو نفسه شبيهاً بالإله ، فوق الخير وفوق الشرّ ، ومتسامياً على كل القيم المعرفية والأخلاقية ، وذلك هو جوهر مفهوم الحلولية في (القَبّالة اليهودية) التي تقول بأن الربّ (يَهْوَه) لا يَحُلُّ إلا في شعبه اليهودي المختار ، وبالتالي يكون الفرد اليهودي فوق كل القوانين الإنسانية أو الأخلاقية ، لأن الإله يحُلُّ فيه ويتوحَّد فيه .
في حين أن مفهوم التصوّف الحقيقي يتجسّد في كثير من التجارب التي كانت أعلاماً وهداية في التاريخ الإسلامي . ولتوضيح الصورة الحقيقية في التصوّف ، فقد كانت حياة (أبو منصور الحلَّاج) وما انبثق منها من إشعاعاتٍ وإشراقاتٍ ، في التفكير والتأمل ، والتي يقول عنها (نيكلسون) :
” لحظة جوهرية في تاريخ التصوّف الإسلامي” .
كانت من نقاط التحوّل والتطوّر في التصوّف الإسلامي ، ومن مطالع النماء والخصوبة في التفكير الروحي ، لأن الأصول الكبرى لذلك التراث الإسلامي العالمي ترجع في جذورها إلى (الحَلّاج) لأنه الوحيد الذي شكّل في محيط الفكر الصوفي أعظم القوى الروحانية الإيمانية التي عرفها التاريخ الإنساني .
والتصوّف عند (الحلَّاج) ، هو انتساب الإنسان إلى الله الخالق سبحانه وتعالى ، لا إلى العالم المادي ، وارتفاع الإنسان إلى الله في سَفرٍ طويلٍ هائلٍ لا تقدر عليه إلا عزائم الرجال الكبار ، من المصطفين الأحرار . وهو سَفرٌ شاقٌ تفنى فيه الصفات البشرية في الصفات الإلهية فناءَ طاعةٍ وعبوديةٍ ، وفَناء حبٍّ ووجد ، وذوقٍ وشوق . إذْ يُقَسِّمُ (الحلَّاج) هذا السفر الطويل إلى أربع مراحل ، تبدأ الأولى بالمعرفة وتنتهي بالفناء ، والثانية تبدأ أنوارها وإلهاماتها حين يعقب الفناء البقاء ، وفي الثالثة يوجّه الإنسان الكامل اهتمامه لمخلوقات الله مرشداً وهادياً . وفي الرابعة قمةٌ سامقةٌ مشرقةٌ يحلِّق الإنسان في آفاقها وقد غمرته الصفات الإلهية بأنوارها الإشراقية ، فيصبح مرآةً تعكس حقائق الكون وأسراره .
وهو موقفٌ لا مجالَ للحديث عنه إلا بما قاله الشيخ (محيي الدين بن عربي) :
“ليس في مستطاع أهل المعرفة إيصال شعورهم إلى غيرهم ، وغاية ما في هذا المستطاع هو الرمز عن تلك الظواهر لأولئك الذين أخذوا في ممارستها” .
ومن أراد فقهاً أكبر ، فليتأمل قول سيد المرسلين عليه وآله الصلاة والتسليم في حديثه عن ليلة الإسراء :
“انعكس بصري في بصيرتي ، فرأيت من ليس كمثله شيءٍ”..
أي أن مارآه كان بالاستبصار الروحي لابمادية الإبصار .
ويقول (الحلَّاج) :
“أسماء الله التسعة والتسعين تصير أوصافاً للعبد السالك وهو بعدٌ في السلوك غير واصلٍ . ومن صدق مع الله في أحواله ، فُهِم عنه كل شيءٍ وفَهِم عن كل شيء” .
وقد حمل (الحلَّاج) في رحلة تصوّفه أمانة المعرفة الصوفية العليا وعاشها بروحه وبقلبه وحسه ، وقدّم دمه فداءً لها في بطولةٍ أسطوريةٍ لا يزال شعاعها وإلهامها يومض عبر صفحات التاريخ .
كانت تجربة (الحلَّاج) الصوفية من أصدق وأخلص ما عرف تاريخ التصوّف ، وهذا سرُّ ما فيها من عمقٍ ومن حرارةِ الإلهام ، بعد أن صعد في معارجها بجناحٍ جبارٍ من أجنحة الحب والوجد ، ووهبها كل روحه وقلبه ، وأماني حسه حين حمل قيثارته ليَهِبَ الخلودَ إلهاماتِ حبه ومعرفته وتجربته .
يقول (الحلَّاج) مصورًا حبَّه ووجدَه :
الله يعلم أن ما في النفس جارحة
إلا وذِكرُه فيها نيل ما فيها
ولا تنفستُ إلا كانَ في نَفَسي
تجري به الروح مني في مجاريها
إذ كانت العين مذ فارقتها
نَظَرتْ إلى سواه فخانتها مآقيها
أو كانت النفس بعد العد آلفةً
خلفاً عداه فلا نالت أمانيها
وقال ايضاً :
والله ما طلعت شمسٌ ولا غربت
إلا وحبك مقرونٌ بأنفاسي
ولا خَلَوْتُ إلى قومٍ أُحدّثهم
إلا وأنت حديثي بين جُلَّاسي
ولا ذكرتُك محزونًا ولا فرِحًا
إلا وأنت بقلبي بين وسواسي
ولا هممت بشرب الماء من عطشٍ
إلا رأيت خيالًا منك في الكاسِ
ولو قدرتُ على الإتيان جئتكم سعياً
على الوجه أو مشياً على الراسِ
ما لي وللناس كم يلحقوني سفهاً
ديني لنفسي ودين الناس للناسِ
وقال عنه ابن الحداد المصري :
خرجت في ليلةٍ مقمرةٍ إلى قبر أحمد بن حنبل رحمه الله فرأيت هناك من بعيدٍ رجلاً قائماً مستقبلاً القِبلة فدنوت منه من غير أن يعلم فإذا هو (الحسين بن منصور الحلّاج) يبكي ويقول :
– يا من أسكرني بحبه ، وحيَّرني في ميادين قربه ، أنت المنفرد بالقِدَم ، والمتوحد بالقيام على مقعد الصدق ، قيامك بالعدل لا بالاعتدال ، وبعدك بالعزل لا بالاعتزال ، وحضورك بالعلم لا بالانتقال ، وغيبتك بالاحتجاب لا بالارتجال ، فلا شيء فوقك فيظلك ، ولا شيء تحتك فيقلك ، ولا أمامك شيء فيحدك ، ولا وراءك شيء فيدركك … أسألك بحرمة هذه الترب المقبولة ، والمراتب المسؤولة ، ألا تردني إليَّ بعد ما اختطفتني مني ، ولا تريني نفسي بعد ما احتجبتَها عني ، وأكثر أعدائي في بلادك والقائمين لقتلي من عبادك .
فلما أحسَّ بي التفت وضحك في وجهي ورجع وقال لي :
– يا أبا الحسن ، هذا الذي أنا فيه أول مقام المريدين ، ثم أشار إليَّ بكفّه فذهبت وتركته . فلما أصبحت رأيته في جامع المنصور فأخذ بيدي ومال بي إلى زاويةٍ وقال : بالله عليك ، لا تُعلِم أحداً بما رأيت البارحة” .
كثيرون يصفون (الحلّاج) بأنه حلولي ينادي بالحلول ، ويتخذ الحب والفناء وسيلة لغايته ، وتنادوا بأنه تَوَحدي يحاول بمجاهداته وشطحاته أن يتوحّد بموجده في تجربةٍ مهمةٍ غامضةٍ وقد اتخذ من الوجد والنشوة عند السماع والاستغراق سبيلاً إلى هدفه ، حتى أصبح في سكره وسبحاته يقول في دعاوى عريضةٍ :
(أنا عوضاً عن هو)!!..
تأليهاً لنفسه وللإنسان المجتبَى المختار الكامل ، الذي يجد في ذاته حقيقة صورةً من الله !.
وعن حقيقة ذلك قال أحمد بن فاتك :
– يقول (الحلَّاج) :
“من ظنَّ أن الألوهية تمتزج بالبشرية ، أو البشرية تمتزج بالألوهية فقد كفر ، فإن الله انفرد بذاته وصفاته عن ذوات الخلق وصفاتهم فلا يشبههم بوجهٍ من الوجوه ولا يشبهونه بشيءٍ من الأشياء ، وكيف يتصور الشبه بين القديم والمحدث !!..
ومن زعم أن الباري في مكانٍ أو على مكانٍ أو متصل بمكانٍ أو يتصور على الضمير أو يتخايل في الأوهام أو يدخل تحت الصفة والنعت فقد أشرك .
فقومٌ جحدوا وألحدوا ، وقومٌ أشركوا وعدّدوا ، وقومٌ أنكروا الصفات فعطلوا وبطلوا.، وقومٌ أثبتوها ولكن شبّهوا وشكّوا .
ولا يُصيب شاكلة الحق إلا من آمن بالذات والصفات ، وكفر باللات والآلات ، ولازم التوحيد والتنزيه ،
واعلم أن العبد إذا وحَّد ربه فقد أثبت نفسه ، ومن أثبت نفسه فقد أتى بالشرك الخفي ، وإنما الله تعالى هو الذي وحَّد نفسه على لسان من يشاء من خلقه ، “وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللهَ رَمَىٰ” .
ويقول الشيخ (محيي الدين بن عربي) :
“إذا كان وجود الخالق ووجود المخلوق واحداً ، فلا معنى لقيام حوار العشق بين المخلوق وبين الله .
كان (الحلَّاج) من أكبر من تغنّوا بالحب الإلهي ، ولعله أكبرهم عاطفةً وأشدهم وجداً وولهاً .
إذْ يقول :
“إن المسافة بين النفس وبين الله تتوقف في مقدارها على صفة العشق الإلهي .
أريدك لا أريدك للثوابِ
ولكني أريدك للعقابِ
فكل مآربي قد نلتُ منها
سوى ملذوذ وجدي بالعذابِ .
ويقول ابن الخطيب في كتابه “تاريخ بغداد” :
إن ابن عطاء لما سمع هذا الشعر قال :
هذا مما يتزايد به عذاب الشغف وهيام الكلف واحتراق الأسف ، وشغف الحب ، فإذا صفا ووفا ، علا إلى مشربٍ عذبٍ وهطل من الحق دائم سكب . والحب لَذَّةٌ لا يعرفها إلا الصفوة من المحبين . وإن الحب العالي ، هوالحب الذي تعجز الكلمات عن تصويره أو كما يقول (سحنون) لا يعبّر عن شيءٍ إلا هو أرق منه ، ولا شيء أرق من المحبة فيما يعبّر عنها .
إن (الحلَّاج) يفهمه القلب في تجربة تصوّفه أكثر مما يحيط به العقل ويدركه الحس ، ويدنو منه الوجدان أكثر مما يمكن تحليله بالفكر والبيان . لأنَّ فَهْمَ (الحلّاج) بحاجةٍ إلى أن نرتفع بأذواقنا ومواجيدنا ، وأن نتلمس بأرواحنا وأشواقنا الطريق الذي يمكن أن نطل من نوافذه على أسرار ذلك الروح الكبير الذي حاول – في عظمةٍ شاهقةٍ – أن يكون صورةَ الولي الكامل المعبّر عن الله سبحانه . وهوالذي عاش في بطولةٍ خارقةٍ ليكون الشهيد الذي يكتب بدمه آية الفداء لحبّه ولعقيدته . فهو الشهيد الذي وقف على آلةٍ صلبةٍ يتحدّى الدنيا ، فلما قطعوا أعضاءه وتدفق دمه توضأ بدمه !!.. ولما سُئل ماذا تفعل .. قال :
– ركعتان في العشق لا يصح وضوؤهما إلا بالدم .
تابع (التصوف)
تلك لمحات من مواقف أعلام التصوّف الإسلامي في عصر (الحلَّاج) سواء في موقف الآخرين من (الحلَّاج) أوموقف (الحلَّاج) من نفسه ومنهم .
يقول (ألفرد فون كرايمر) :
– الكل مُجْمِعُونَ على أن (الحلّاج) كان على رأس فرقةٍ كبيرةٍ وأنه كان له أتباعٌ كثيرون أُعجبوا به واتخذوه إماماً ومرشداً .
كمايذكر (ماسنيون) :
– إن كثيرًا من الأمراء وقواد الجيش وعظماء الدولة العباسية وأعلام المعتزلة وفقهاء الحنابلة وصفوة المفكرين والمصلحين ، ومع كل هؤلاء جمهرةٌ كبيرةٌ من الناس، كانوا جميعاً من أتباع (الحلَّاج) ومن تلاميذه والمؤمنين بقداسته وولايته وبدعوته الإصلاحية . ومع هذا كله ، فإن عدداً من أعلام التصوّف الإسلامي في عصره ، قد خاصموه ولم يناصروه في أهدافه وصيحاته ولم يساندوه في محنته واستشهاده .
لقد جاء (الحلَّاج) ليضيف جديداً ونقاءً إلى التصوّف الإسلامي من خلال صلته بالله تعالى ، ومن خلال صِلاته بالحياة . لقد جاء (الحَلَّاج) ولم يكن صورةً مُكررةً من الناس أو العلماء ، ولا كان سطوراً متلألئة في كتب التاريخ بجانب السطور التي خَطَّها المفكرون أو العابدون . وإنما كان كتاباً وأمةً تقيم منهجاً وترسم طريقاً في فتح الآفاق ، وكانت نفسه بعد هذا صورةً صادقةً معبِّرةً وقائمةً بمنهجه وبطريقه وبأفقه .
كان (الحلّاج) يصنع من تاريخه معالمَ وصوراً تهتدي بها الإنسانية في سيرها المضيء إلى الله تعالى وفي جهادها العنيف للكمال والتسامي . وكان ينشد من المعرفة ، أن يظفر الصوفيُّ بحظٍّ من الفيض الإلهي ليعبِّر دائماً عن الإرادة الإلهية . فإذا عبَّرَ عنها ارتفع إلى أفقها وقداستها وأصبح قوله صورةَ إيمانه في دينه وفي دنياه .
ومن هنا كانت عظمة العقيدة الحَلَّاجية ، التي أخذت كل شيءٍ بقوةٍ وعزمٍ وبقداسةٍ ولم تقبل أبداً تساهلاً أو تردداً أو تقية ً.
يقول (الحلَّاج) :
“الواجب على أولياءِ الله أن يتوَجَّهوا إلى الله وحده ، وأن يتحقّقوا بمعنى العبودية الكاملة ، ويطيعوا أمرَه مهما كلفهم ذلك من عَنَتٍ وشَقاءٍ” .
لأن الولاية عند (الحَلّاج) تبلغ كمالَها عن طريق الابتلاء واحتمال الألم ، وتبلغ جلالَها بالجهاد والتضحية .
ويعتبر (الحسين بن منصور الحَلّاج) واحداً من أشهر الصوفيين وأكثرهم إثارة للجدل عبر التاريخ . ولد في البيضاء في فارس عام 244 هـ/ 857م ، ثم انتقلت أسرته إلى (واسط) في العراق ، وقتل في (بغداد) عام 309 هـ/ 922م على يد رجال الخليفة العباسي (المقتدربالله) على نحو بشع حيث جلد وصلب وقطعت جثته وأحرقت وألقيت رفاته في نهر دجلة .
وتضاربت الأسباب وراء قتله ، ما بين أسبابٍ سياسية وأسبابٍ دينية ، لكن الراجح أنها تعود إلى آرائه التي كان يخرج بها إلى الناس، من دون أن يتمكنوا من فهمها ، وبالتالي اعتبروها “كفرا” و”زندقة” ، وكان أبرزها ما قالوا أنها مقولته :
“أنا الحَقّ” .
ورغم انقسام الناس بين مؤيد ومعارض له فقد شكّل (الحلّاج) مصدر إلهام لأجيال من العرب وللمسلمين على مرِّ العصور . وما تزال تجربته الروحانية وأفكاره الفريدة التي تجاوزت عصره ، تتمتع بنفس القوة حتى اليوم .
ثمة مسألتان رئيسيتان في فكر (الحلّاج) ، ولا تخلو أي من أقواله أو أشعاره منهما . الأولى هي “وحدة” كل ما في الوجود ، والثانية أن الطريقة الوحيدة لإدراك هذه “الوحدة” تتم عبر إفناء “الأنا” أو “الذات” الفردية في “الأنا” أو “الذات” الكلية ، أو بحسب مصطلح (الحلاج ) :
“استهلاك ناموسية الإنسان في لاهوتية الله” .
لقد شكّلت رغبة (الحلاج) في الانعتاق من ربقة الجسد والسماح لروحه بالانطلاق مجدداً هاجساً دائماً لديه ، وكانت شديدة إلى درجة أنه لم يمانع أن يقتلوه . ويرى (الحلّاج) أن ثمة “واحداً” فقط في الوجود ولا شيء سواه ، وهو الله سبحانه وتعالى ، وأن جميع الموجودات هي تعبيرات عن هذا “الواحد” ، مثل أشعة الشمس فهي رغم تعدّدها فإن مصدرها واحد . ورغم أن مصدر كل شعاع هو الشمس لكن هذه الأشعة لا تقوم مقام الشمس ، وهي ليست مساوية لها ، كما أنها ليست “مماسة أو ممازجة لها” .
ويقول أيضاً :
“إن حواسنا ، بما في ذلك العقل ، تتعامل خطأ مع تلك الموجودات باعتبارها موجودات منفصلة وقائمة بذاتها” .
بينما يرى هو أن ذلك مجرد وهم ناجم عن قصورنا في إدراك الحقيقة والتي يقسمها إلى ثلاثة مستويات :
“ضوء المصباح علم الحقيقة ، وحرارة المصباح فيها حقيقة الحقيقة ، والوصول إليه حَقّ الحقيقة” .
وقد سأل أحدهم (الحلاج) :
“كيف الطريق إلى الله تعالى؟..
فقال : الطريق بين اثنين وليس مع الله أحد”.
وهو يقصد بذلك أن “الله موجود في كل مكان ، ولا يوجد طريق للوصول إليه ، لأن الطريق يقتضي وجود اثنين وليس مع الله أحد . ولكن يمكن إدراك الله مع ذلك من خلال النظر إلى سائر المخلوقات ، لأن النقطة أصل كل خط ، والخط كله نقط مجتمعة . فلا غنى للخط عن النقطة ، ولا للنقطة عن الخط . وكل خط مستقيم أو منحرف فهو متحرك عن النقطة بعينها . وكل ما يقع عليه بصر أحد فهو نقطة بين نقطتين . وهذا دليل على تجلّي الحقّ من كل ما يُشاهَد وتَرائيه عن كل ما يُعايَن . ومن هذا قلت : ما رأيتُ شيئاً إلا ورأيتُ اللهَ فيه”.
وشكّلت رغبة الانعتاق من ربقة الجسد والسماح لروحه بالانطلاق مجدداً هاجساً دائماً لدى (الحلّاج) وكانت هذه الرغبة شديدة إلى درجة أنه لم يمانع في قتله ، بل كان يستفز القتلة للإقدام على ذلك . وكان في مناظراته يصرح بآراء يعرف أن ظاهرها يستفز العامة ، رغم أن باطنها مختلف تماماً .
أما ماقالوا بأنه قوله “أنا الحق” ..
ففي الظاهر يُفهَم منها أنه يدّعي الألوهية لنفسه ، لكن الحقيقة أنها كانت محاولة منه لنفي نفسه وإثبات وجود (الله) . ففي اللغة لا نستطيع أن نذكر (الله) من دون أن نقع في ثنائية “القائل والمخاطَب”.
ودائما هناك “أنا و هو” ، بينما هناك “واحد” فقط .
الطريقة الوحيدة لتجاوز ذلك هي فناء الذات في (الله) ، مثلما تعود القطرة إلى الماء . وبهذا المعنى كانت مقولة
“أنا الحق” .. هي الطريقة الوحيدة للإشارة إلى (الله) تعالى من دون الوقوع في الثنائية أو في “الشرك”.
وتظهر معاناة الحلاج الشديدة مع الجسد في مناجاته المستمرة مع الله سبحانه بعد أن كشف له أموراً سُتِرَت عن أغلب الناس . وفي ذلك يقول:
أأنت أم أنا هذا في إلهين
حاشاك حاشاك من إثبات اثنين
هوية لك في لائيتي أبداً
كلي على الكل تلبيس بوجهين
فأين ذاتك عني حيث كنت أرى
فقد تبين ذاتي حيث لا أين
وأين وجهك مقصود بناظرتي
في باطن القلب أم في ناظر العين
بيني وبينك أنّيٌ يزاحمني
فارفع بأنّيك أنّيي من البين
وبنى (الحلّاج) دعوته الروحانية على أسس إنسانية شاملة ، من دون تعصب لديانة أو لمذهب أو لجنس أو لقومية بعينها
وبحسب معاصريه فقد كان متشوقاً للحظة الخلاص التي طالما أرادها وتنبأ بها دائماً . وفي اليوم الذي قتلوه فيه ضحك كثيراً ودمعت عيناه وهو مصلوبٌ على منصة إعدامه ، ومما قاله :
“هؤلاء عبادك قد اجتمعوا لقتلي تعصبا لدينك وتقربا إليك. فاغفر لهم ، فإنك لو كشفتَ لهم ما كشفتَ لي لما فعلوا ، ولو سترتَ عني ما سترتَ عنهم لما ابتُليتُ بما ابتُليتُ ، فلك الحمد في ما تفعل ولك الحمد في ما تريد”.
وهناك جانب آخر في فِكر (الحلّاج) وهو جانب جدير بالاهتمام لنظرته الكونية ، مثله في ذلك مثل (جلال الدين الرومي) ، حيث بنى دعوته الروحانية على أسسٍ إنسانية شاملة من دون تعصب ، وقد سافر إلى مناطق ما وراء النهر ، وإلى الهند والصين وتعرّف على أساتذة التأمل في (اليوغا) واطلع على علومها ومارسها عندما عاد إلى بغداد . وكان لافتا موقفه من وحدة الديانات كلها وضرورة عدم التفرقة بينها .
“يروى عن عبدالله بن طاهر الأزدي أنه قال : كنت أخاصم موسوياً في سوق بغداد وجرى على لفظي أن قلتُ له :
– يا كلب .
فمَرَّ بي (الحسين بن منصور الحلّاج) ، ونظر إليّ شزراً وقال : – لاتُنبِح كلبك .
فلما فرغت من المخاصمة قصدته ، فدخلت عليه ، فأعرض عني بوجهه . فاعتذرت إليه فرضي ثم قال :
– يا بني الديانات كلها لله عز وجل ، شَغَلَ بكل ديانةٍ طائفةً لا اختياراً فيهم بل اختياراً عليهم . فمن لام أحداً ببطلان ما هو عليه فقد حكم أنه اختار ذلك لنفسه وكَفَر . واعلم أن الموسوية والنصرانية والإسلام وغير ذلك من الديانات هي ألقاب مختلفة وأسامٍ متغايرة ، والمقصود منها لا يتغيّر ولا يختلف” .
كان (الحلّاج) مُتصوِّفًا من أكابر الصوفيّة ، ويُعدُّ رأساً من رؤوسهم في عصره . حوكِمَ في عهد الخليفة العباسي (المقتدر بالله) ووُجِّهَت له تُهَمٌ كثيرة تتعلّق باعتقاده وبسعيه لقلب الحكم ، وسعى لتأكيد هذه التهم جماعة من أعداء (الحلّاج) ، على رأسهم وزير الخليفة الأكبر (حامد بن العباس) ومن ورائه بعض المشايخ الكارهين الذين لهم نفوذهم عند الوزير . وقد كانت التُّهَم تتراوح بين إدّعائه الألوهيّة ، والتآمر مع القرامطة ، ومقولته المنسوبة إليه التي قالها في إحدى مناظراته :
” أنا على الحَقّ ”
حيث أوصلوها إلى الخليفة (المقتدر بالله) بأنه يدّعي الألوهية ويقول :
“أنا الحَقّ” .
واختلف الناس فيها بين مُثبتٍ وبين نافٍ لها ، أما الذين أثبتوها فقد تأوّلوها ونسبوا الكفر للحلّاج ، وبقي (الحلّاج) يُحاكَم بهذه التُّهَم نحو ثمانية أعوام تقريباً وهو في سجنه .
كان أتباع (الحلّاج) كُثُراً من العلماء ومن العوام على حَدٍّ سواء ، وكاد سجنه أن يزلزل الحكم العبّاسي كله نظراً للظلمِ الواقع عليه ولمحبة الناس له ، وقامت ثورات (تظاهرات) تدعو لإنقاذه من السجن . وبينما القاضي (أبو عمر المالكي) ، وهو القاضي المعروف بعلمه ، يتحاور مع (الحلّاج) بشأن مسألة وَرَدَت في كتاب للحلّاج ، قال القاضي (أبو عمر) جملته :
– كذبتَ يا حلّال الدم .
فتلقّف الوزير (حامد) هذه الكلمة ، وأمَرَ القاضي بكتابتها وأرسلها إلى الخليفة ، يُعلمه بأنّ القضاة قد أباحوا دم (الحلّاج) . ولمّا استلم الخليفة كتاب وزيره ، لم يملك من أمره شيئاً ، وطلب (الحلّاج) مقابلة الخليفة ، ولمّا سمع الوزير بذلك ألحّ أن يكون حاضراً في تلك المقابلة ، فجاء (الحلّاج) وعليه الأصفاد ، وحدّث الخليفة ونصحه بإقامة العدل ، وإنفاذ روح شريعة الله تعالى في البلاد ، ونحو ذلك مما يوعَظُ به السلاطين . بعدها انتقل (الحلّاج) للحديث حول قضيّته ، وأثبت للخليفة بطلان ما توجّه إليه من أحكام ، وأنّه يشهد بأنّه لا إله إلّا الله وبأنّ محمَّداً عبده ورسوله ، وأنّه – أي الحلّاج – عبدٌ من عباد الله ، وهو لايدّعي الألوهية ولا يُشرك بالله شيئاً . وختم كلامه بأنّه يقول بما قال به (إبراهيم الخليل) – عليه السلام – بأنّه قد وجّه وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين – وخرج من مجلس الخليفة ، وقد ترك الخليفة متردّداً بالحكم عليه .
وأُصيب الخليفة بعد هذه المناظرة بالحمّى ، فادّعى الوزير بأنه يخاف من افتتان الناس بالحلاج أن يعتقدوا بأنّ الله تعالى قد نصر (الحلّاج) عليه ، فأرسل إلى الخليفة يحثّه على الإسراع في إصدار الحكم النهائي على (الحلّاج) ، فأرسل الخليفة أنّه إلى القضاة بوجوب تنفيذ حكم الحَدّ عليه وقتله .
سيق (الحلّاج) نحو سجنه ليُحضَّرَ للقتل وكان يناجي ربّه ويدعو بما فتح الله به عليه من العلم ، ومن جملة دعائه الذي حُفِظَ عنه :
“نحن بشواهدكَ نلوذ ، وبِسَنا عزّتك نستضيء ، لتُبدي ما شئتَ من شأنك ومشيئتك ، وأنت الذي في السماء إلهٌ وفي الأرض إله” .
حتى أنَّ بعض الجُند الذين كانوا يحرسونه قالوا بأنّه صلّى ركعات في ليلته تلك ، فقرأ القرآن كاملاً في ركعة واحدة ، ثمّ أوصى من كان حاضراً عنده من الجند ، وجعل يتواجد ويقول من شعره ما يقول في تلك الليلة الأخيرة له ، ولم يبدُ عليه الخوف ، ولكنّه كان مستبشرًا يريد الموت في سبيل الله ، عسى أن يكون له في هذا القتل شهادة .
ويكتب المؤرِّخون عن واقعة قتله :
“لمّا كان صباح يوم الثلاثاء لسبعٍ بَقينَ من ذي القعدة سنة 309 للهجرة جيء بالحلّاج موثوقاً ويصحبه العسكر إلى مكان تنفيذ حكم الإعدام ، فطلب سجّادة وصلّى ركعتين ، ثمّ دعا ربّه بدعاءٍ قد حفظته بعض الكتب يدور حول الطلب من الله تعالى بالعفو عن قتلته ، فهم لا يعلمونَ بأنّهم مخطئون .
فجُلِدَ مائة جلدة ولم يمت ، فقطعوا يديه وعلّقوه على الصليب يوماً أو يومين ، ثمّ قطّعوا قدميه وتركوا دماءه تنزف منه وهو مايزال مصلوباً على صليبه ، ولاحت شرارةُ ثورةٍ بدأت في الأفق نُصرةً للحلّاج المصلوب ، ولمّا وصل خبر الثورة للخليفة ، أراد العفو عمّا تبقّى من (الحلّاج) ، ولكنّ الوزير (حامد) أبى ذلك وأصرّ أن يُقتَل (الحّلاج) من فوره ، فكان أمر الخليفة بقتله ، فتلا الوزير أمر الخليفة بقتل (الحلّاج) ، وقالوا إنّ آخر كلمة نطقَ بها (الحلّاج) هي قوله :
“حسب الواجد إفراد الواحد له” .
وبعد هذه الكلمات ضُرب عنقه ، وأُحرِقت جثته وأُلقيَ رمادها في نهر دجلة . ورُويَ ، وقد تمَّ إثبات ما روي على ألسنة الكثيرين من الشهود ، بأنّ دم (الحلّاج) لمّا وقع على الأرض كتب “الله الله” وكأن في ذلك إشارة لتوحيده وبراءته مما نسب إليه ، كما يقول المناوي في “الكواكب الدريّة” .
ترك (الحلّاج) وراءه العديد من الكتب ، وذُكر بأن له ستة وأربعين كتاباً ومنها :
(طاسين الأزل ، الجوهر الأكبر ، الشجرة النورية ، الظل الممدود والماء المسكوب ، الحياة الباقية ، قرآن القرآن ، الفرقان ، السياسة والخلفاء والأمراء ، علم البقاء والفناء ، مدح النبي ، المثل الأعلى ، القيامة والقيامات ، هُوَ هُوَ ، الكبريت الأحمر ، الوجود الأول ، الوجود الثاني ، اليقين .. وأخيراً التوحيد) .
ومن أشعاره في التصوّف التوحيدي بحبّ الله تعالى قوله :
ما لامني فيك أحبابي و أعدائي
إلّا لغفلتهم عن عظـم بلوائي
تركتُ للناس دنياهم و دينهـم
شغلاً بحبـّك يا ديني و دنيائي
أشعلتَ في كبدي نارين واحدة
بين الضلوع و أخرى بين أحشائي
===========
من كتابي :
( القَبّالَة و طوائف اليهود )